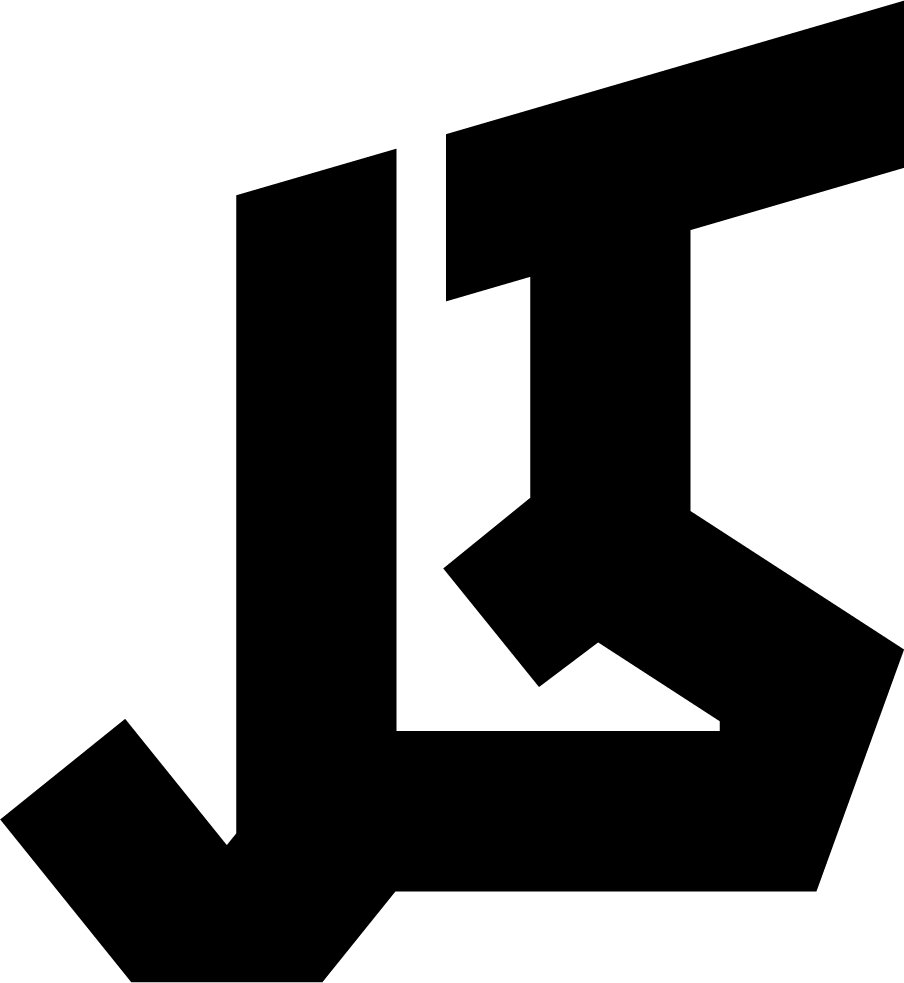النسوية الفلسطينية في زمن المحو: الجسد، الصوت، والمقاومة الرمزية في غزة (2023–2025)
failure_of_humanitarianism_ar.jpg

ميرا المير
في السياق الاستعماري الممتدّ الذي تتقاطع فيه أدوات العنف المادّي مع آليّات العنف الرمزي، يُعاد تشكيل الجسد الأنثوي الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، بوصفه موقعاً مزدوجاً للإبادة والمقاومة في آن واحد. فبعيداً عن كونه مجرّد كيان بيولوجي، يتموضع هذا الجسد كرمزٍ للوجود الوطني وأرشيفٍ حيٍّ لمعاني الاستمرارية في مواجهة سياسات المحو. وقد شكّل العدوان الإسرائيلي الواسع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والإبادة المستمرّة في غزة مثالًا صارخًا على هذه البنية، حيث استُهدفت النساء بصورة مباشرة ليس بوصفهن أضراراً جانبية بل كعناصر بنيوية في النسيج الاجتماعي والثقافي. وتشير بيانات "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" إلى أنّ النساء والأطفال شكّلوا أكثر من 70% من الضحايا مع قصفٍ ممنهجٍ للبنية الصحّية، بما في ذلك أقسام الولادة وعيادات الخصوبة، الأمر الذي يعكس استراتيجية استعمارية متعمَّدة لتقويض القدرة الإنجابية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني (UN Women, 2024). بهذا المعنى، تتحوّل الأمومة إلى ممارسة مقاومة سياسية، ويُفرغ الجسد الأنثوي من شروط الاستمرارية ليُعاد إنتاجه كأداة صمودٍ في مواجهة منطق الإبادة.
غير أنّ هذا الحضور الكثيف للجسد الأنثوي في مشاهد الدم والفقد والإسعاف والتوثيق الرقمي ظلّ محاصراً بخطابات تمثيلية متواطئة. فمن جهة، هناك خطاب إنساني اختزالي يجرّد الفلسطيني من سياقه السياسي ليُحيله إلى ضحية مُفرغة من قدرته على الفعل، ومن جهة أخرى، خطاب استشراقي يختزل الجسد الفلسطيني في ثنائية ضحية مستسلمة أو أيقونة نضالية منزّهة عن التعقيد. كلا الخطابين، الإعلامي والأكاديمي على السواء، يساهم في تغييب المعرفة النسوية الفلسطينية التي تنبثق من التجربة المعيشة تحت الاستعمار والحصار، على الرغم من أنّ النساء يشكّلن فاعلات أساسيات في أرشفة الكارثة وإنتاج خطاب المقاومة. هذه الفجوة المعرفية تكشف حدود الأدبيات السائدة، وتطرح الحاجة إلى مقاربةٍ جديدة تتجاوز التمثيل البصري المسطّح والتجاهل الأكاديمي المنهجي.
انطلاقًا من هذا الواقع، يُطرح سؤالٌ بحثيّ محوريّ: كيف يُمثَّل الجسد الأنثوي الفلسطيني في سياق العنف الاستعماري المعاصر، وما أشكال المقاومة الرمزية التي تنتجها النساء الفلسطينيات لمواجهة سياسات المحو المادي والرمزي؟ تتفرّع عن هذا السؤال عدّة مستويات تحليلية: أوّلها يتعلّق بآليات المقاومة الرقمية والرواية الذاتية خلال العدوان، وثانيها يختبر الكيفية التي تُترجَم بها سياسات المحو إلى تجارب نسائية يومية كما تُعكس في الشهادات والمقابلات الميدانية، وثالثها يستقصي إسهامات النقد النسوي المناهض للاستعمار في تفسير التمثيلات الإعلامية والأكاديمية للمرأة الفلسطينية، وأخيراً يُعيد مساءلة الجسد ذاته كأداة للأرشفة والمقاومة داخل مشروع الإبادة الاستعمارية.
فمنذ النكبة عام 1948 كان الجسد الأنثوي الفلسطيني ساحة صراعٍ أساسية؛ فقد روت أرشيفات اللجوء الأولى كيف تحوّلت النساء إلى حامِلاتٍ لذاكرة المخيم والشتات، وكيف استُخدم العنف الجنسي والتهجير القسري كأدوات إذلال جماعي. وفي الانتفاضة الأولى (1987–1993) شكّلت عمليات الاعتقال وهدم المنازل استهدافاً مباشراً للنساء، فيما وثّقت منظمات حقوقية حالات ولادة على الحواجز العسكرية بسبب منع المرور. أما خلال عدوان 2008–2009 على غزة، فقد جاء قصف أقسام الولادة ومراكز الرعاية الإنجابية امتداداً لما وصفته نادرة شلهوب-كيفوركيان بـ"العنف الإنجابي"، حيث يُستهدَف الجسد النسوي لا بصفته ضحية عرضية، بل كحامل للبنية المجتمعية الفلسطينية. من هنا، يتّضح أن ما جرى ويجري في ظلّ الإبادة ليس حدثاً طارئاً، بل حلقة متجدّدة في تاريخٍ استعماري طويل يجعل الجسد الأنثوي مسرحاً للمحو والمقاومة في آن واحد.
تقترح هذه الورقة إطاراً مفاهيمياً هو "الجسد المؤرشِف للمحو والمقاومة"، يرى في الجسد الأنثوي فاعلاً سياسياً ومعرفياً يُنتج خطاباً بديلاً من خلال الممارسات اليومية وأفعال العناية والتوثيق الرقمي والذاكرة الجمعية. وبهذا، لا يعود الجسد محصوراً في ثنائية الضحية أو الأيقونة، بل يُعاد تعريفه كبنية أرشيفية تُقاوم الاستعمار بالمعرفة، واللغة، والذاكرة، والغضب المشاع، مما يفتح أفقاً جديداً لإعادة قراءة التجربة النسوية الفلسطينية في سياق الكارثة الاستعمارية.
الجندر كأداة استعمارية في السياق الفلسطيني
في قلب الصراع الفلسطيني، تتداخل أبعاد الجندر مع البعد الاستعماري لتصبح الأجساد النسائية الفلسطينية ساحةً مركزية للصراع بين ممارسات الهيمنة ومحاولات المقاومة، متجاوزةً مسألة البيولوجيا أو الهوية الاجتماعية إلى ميدانٍ سياسي وثقافي معقّد. إذ يُستخدم الجندر كأداة استعمارية لإعادة تشكيل المجتمعات المحلّية، وفرض سرديات هيمنة تتخفّى خلف شعارات "تحرير النساء"، وهو ما تسمّيه ليلى أبو لغد (2013) بـ"النسوية الإمبريالية"، التي توظّف معاناة النساء الفلسطينيات لإضفاء شرعيةٍ على تدخّلات سياسية وإنسانية مع إقصاءٍ فعليٍّ لأصوات النساء وتجاربهن الفريدة.
هذا الاستخدام الاستعماري للجندر يتقاطع مع ما يطرحونه جوديث بتلر (2009) في كتابهم Frames of War "أُطُر الحرب: متى تكون الحياة مُستحِقّةً للحزن؟"، حول مفهوم "الحياة القابلة للحزن"، إذ يوضحون كيف تحدّد الخطابات الاستعمارية مَن يستحقّ أن يُرثى ومَن لا يُعتبَر إنساناً كاملاً. في الحالة الفلسطينية، تُختزل النساء في الإعلام الغربي بأرقامٍ مجهولة، ما يجعل أجسادهن غير مرئية وغير جديرة بالنجاة. ومن هنا يصبح فعل التوثيق والتعبير النسوي فعلاً سياسياً يعيد تعريف الحياة الفلسطينية بوصفها حياة قابلة للظهور والتأريخ.
في هذا السياق، تذكّرنا غاياتري سبيفاك (1988) في نصها المؤسس ?Can the Subaltern Speak "هل يستطيع التابع أن يتكلم؟" بأن المهمّشين لا يُسمح لهم بالكلام إلا عبر وسطاء نخبويين يعيدون تشكيل خطابهم. وهو ما يتجلّى في الحالة الفلسطينية حيث يُختزل صوت النساء في خطاب الشفقة أو يُصوَّرن كضحايا محايدات، بينما تُنتِج الفلسطينيات على الأرض معرفةً سردية من قلب الحصار والقصف، ما يجعل من فعل الكتابة والتوثيق والتعبير كسراً لهيمنة الصمت الاستعماري. وحول هذا الاختزال، توضح ليلى أبو لغد (2013) في كتابها ?Do Muslim Women Need Saving "هل تحتاج النساء المسلمات إلى إنقاذ؟"كيف يُسطّح الخطاب الغربي النساء المسلمات ويعيد إنتاجهن كضحايا بلا قدرة على الفعل، وهو ما يتّضح عن غزة حيث تُقدَّم النساء كرموز للمعاناة فقط بينما تُمحى أدوارهن التنظيمية والمجتمعية. هذا التحليل يفتح الباب لفهمٍ أعمق للجسد الأنثوي بوصفه حاملاً للمقاومة لا رمزاً للضعف.
صبا محمود (2005) في Politics of Piety "سياسة التقوى" تذهب أبعد من ذلك، إذ تعيد تعريف القدرة على الفعل بحيث لا تُختصر في التحرّر من الدين أو الأعراف، بل يمكن للنساء أن يمارسن الفعل من داخل الالتزام الديني والاجتماعي. ومن خلال هذا الإطار، يمكن قراءة الأمومة، والرعاية، وتوثيق الألم لدى النساء الفلسطينيات كأفعال مقاومة لا تقلّ أهمية عن المشاركة السياسية المباشرة. فيما تؤكد رنا بركات (2017) على "الذاكرة المتجسدة" حيث يصبح الجسد نفسه حاملاً للتاريخ والمقاومة، فلا ينفصل عن الأرض والذاكرة. أما نادرة شلهوب-كيفوركيان (2015؛ 2023) فتضيف بعداً آخر حين تبرز مفهوم "العنف الإنجابي" Reproductive Violence، حيث يُستهدف الجسد الأنثوي الفلسطيني عبر الهجمات على المستشفيات ومراكز الولادة في محاولةٍ لإضعاف البنية المجتمعية.
وإذا كانت الأجساد الفلسطينية موقعًا للهيمنة والمحو، فإنها في الوقت ذاته تنتج فضاءات جديدة للمقاومة الرمزية، خصوصاً في العالم الرقمي. عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك"، تتحوّل الشهادات اليومية إلى ذاكرة جماعية تواجه محاولات المحو الرمزي وتعيد تعريف حضور النساء الفلسطينيات في المشهد العالمي، ليس كضحايا صامتات بل كفاعلات يكتبن تاريخاً حياً يتحدّى الاستعمار في كلّ تجلّياته.
المقاومة الرمزية – الزغاريد والأرشفة الرقمية
لم تعد الزغرودة الفلسطينية مجرّد بقايا فولكلورية أو طقسٍ عابرٍ يُستعاد في مناسبات الموت؛ لقد غدت فعلاً ميتاسياسياً، يتجاوز حدود الفرح والحزن ليؤسس معنىً آخر للوجود في وجه الإبادة. فالمرأة التي تطلق زغرودتها في جنازة لا تُعلن فقط تحدّيها للحداد، بل تُمارس ما يشبه "إعادة كتابةٍ" للموت في سجلّ الجماعة، فتحوّل الجرح الفردي إلى علامة جمعية، والغياب إلى كثافة حضور. منذ النكبة، مروراً بالانتفاضات، ظلّ الصوت الأنثوي يشقّ كسيف هوائي في الفضاء العام، يعلن أن الفقد ليس ختاماً بل بداية أخرى، وأنّ الحداد يمكن أن يُستعاد كفعل مقاومة يُرسّخ الذاكرة بدل أن يشيّعها إلى الغياب.
غير أنّ زمن الإبادة على غزة قوّض هذا المشهد برمّته: لم تعد هناك جنازات تُنظَّم، ولا مسيرات تشييع تفيض بالجموع والنداءات والأغاني الثورية. ما كان فعلاً شعائرياً–جماعياً مُفعماً بالرمزية انكسر أمام شروط الدفن تحت القصف، والمقابر الجماعية، والموت الذي لم يعد يتيح للطقس أن يُكمل دائرته الرمزية. الزغرودة هنا لم تنقطع كصوتٍ وحسب، بل تحوّلت إلى استعارة مكسورة، صدى غائب يذكّر بما لا يمكن ممارسته، ومع ذلك يظلّ يشتعل كذكرى مقاومة مستحيلة تُضيء فضاء الخيال.
وهنا يبرز البُعد الرقمي كفضاء بديل للطقس: صورٌ مرتجفة مُقتطعة من اللحظة، بثوث حيّة تُجاور الانفجارات، كتابات نسائية ممزوجة بالبكاء والزغاريد الافتراضية. هذه العلامات العفوية لا تُشكّل مجرد توثيق، بل تتراكم كـ"أرشيفٍ مضادّ" يعيد للذاكرة حقّها في البقاء، ويُقيم لغةً بديلة تواجه محاولات المحو الاستعماري. إنّها مقاومة رمزية تحوّل الجسد المهدَّد والصوت المحاصَر إلى أدواتٍ لتفكيك البنية الخطابية للسلطة، ولإعادة صياغة الفضاء السياسي نفسه. وكما يشيرون بتلر (2009)، فإن هذه الأفعال، مهما بدت هامشية أو صغيرة، تحمل طاقةً تفكيكية قادرة على خلخلة معمار السلطة الرمزي، وعلى إعادة توزيع الحدود بين ما يُحتفى به وما يُراد دفنه في الصمت.
انطلاقاً من الاشتباك النقدي مع الأدبيات النسوية والمناهضة للاستعمار، تقترح هذه الورقة إطاراً مفاهيمياً محلّياً بعنوان "الجسد المؤرشف للمحو والمقاومة"، والورقة هنا ليست دراسة ميدانية مكتملة العناصر البحثية التقليدية، بل مقال/ ورقة تنظيرية تُعيد صياغة المفاهيم من قلب السياق الغزّي. يُفهم الجسد بوصفه أرشيفاً حيّاً لا يوثّق لحظات النجاة والفقد فحسب، بل يُعيد إنتاج الذاكرة عبر الأثَر، الندبة، الصوت والرعاية، لتتحوّل الممارسات اليومية – من التوثيق العاطفي إلى إرضاع طفل تحت القصف – أفعالاً أرشيفية تقاوم المحو. وبخلاف بتلر الذين توقّفوا عند الحقّ في الحزن، يقترح هذا الإطار الانتقال إلى تأريخ الألم Archivable Pain، أي من الحقّ في أن تُرثى الحياة إلى الحقّ في تأريخ الألم ذاته.
بهذه المقاربة، لا يعود الجسد الأنثوي مجالاً بيولوجياً أو رمزانياً فحسب، بل وثيقة سياسية تقاوم الطمس، وتُسائل الخطابات الدولية التي تحتفي بـ"الضحية" وتتجاهل المؤرِّخة. كما يفتح هذا الإطار أفقاً لقراءة أفعالٍ تبدو هامشيةً – كتصوير الجثث أو الصمود أمام الكاميرا – بوصفها مقاومة أرشيفية، ويعيد تموضع الذاكرة الفلسطينية في موقع الجسد لا في الأرشيف الوطني الرسمي الذي طالما همّش النساء. غير أن المفهوم، وهو ما يزال قيد التشكّل، يعترف بحدوده، إذ يحتاج إلى توسيع فضائه ليشمل الشتات والسياقات المتعددة للذاكرة النسوية، ويتطلّب اشتباكاً أعمق مع دراسات الأرشفة والأنثروبولوجيا الحسية، فضلاً عن الحذر من فخّ تمجيد الألم أو تسليعه. ومع ذلك، فإن قوة المفهوم تكمن في مساءلة ليس فقط أدوات الاستعمار، بل أيضاً المنهجيات البحثية التي طالما فصلت بين الجسد والمعرفة، وبين الألم والسياسة.
إن الجسد المؤرشف للمحو والمقاومة ليس مجرد مفهوم، بل اقتراح لأفق نقدي جديد، يُعيد كتابة العلاقة بين الجسد الفلسطيني والتاريخ والذاكرة، ويُنتج معرفةً بديلة تُقاوم الهيمنة الكولونيالية والإغاثية، وتؤسس لأرشيفٍ حيّ ينبض بالحياة في مواجهة النسيان.
أرشفة مضادّة كفعل مقاومة
في السياقات الرقمية، لم تكن المنشورات التي وثّقتها النساء مجرّد ممارسات عاطفية أو لحظات اعتراف شخصية، بل جسّدت – بشكلٍ تراكمي – ما يمكن تسميته بـ "أرشفة مضادة" تمارسها النساء من داخل الكارثة، لا من هامشها.
عندما كتبت بيسان عودة، الشابة الغزّية التي فقدت منزلها واضطرّت أن تلجأ إلى أماكن كثيرة في القطاع في ظلّ الإبادة، على صفحتها1 على "إنستغرام": "غرفتي اللي فيها عشرين سنة راحت"، فهي لا تكتب لتبكي بل لتبقى، لتحوّل المكان المهدّم إلى ذاكرةٍ حيّة تُعاد كتابتها على الجدران الافتراضية. فإنّ هذه الجملة، التي قد تبدو انفعالاً عاطفياً عابراً، تحمل وظيفةً أرشيفية؛ إذ تحوّل المكان المهدوم إلى ذاكرةٍ حيّة يُعاد تدوينها في الفضاء الرقمي. فعل الكتابة هنا لا يقتصر على التوثيق، بل يصبح شكلاً من أشكال المقاومة الرمزية التي تعيد إنتاج المكان كحكاية جماعية، وتمنع اندثاره تحت الركام. كما أن توثيق بيسان اليومي للارتكابات الاسرائيلية وتصوير النساء في مخيمات النزوح وهنّ يجمعن الأطفال في طوابير صباحية لتدريسهم، إلى بثّ مقاطع تدعو الشعوب للثورة على حكّامها المتواطئين – يجعل من خطابها أرشيفاً حياً لمقاومة المحو الرقمي ومحاولة الاحتلال إسكات الأصوات التي تعرّيه أمام العالم.
تقول ميس (27 عاماً): "كتبتُ على الفيسبوك أن ابني ما نام ليلة كاملة، حسّيت كأنّي عم بحفر ذكرى صغيرة بتتحدّى المحو" (2024). هذه الكتابة اليومية تفكّك العنف البطيء إذ تُظهر أنّ الزمن نفسه يُستعاد عبر اللغة والندبة المؤرشَفة رقمياً. إن هذه الأفعال لا تقتصر على النجاة من القصف، بل تُعيد بناء اللغة وتُعرّي الحدود بين الألم والمعرفة، لتصبح الكتابة النسوية الغزّية فعلًا أرشيفيًا يقاوم النسيان.
إنّ التوثيق كفعلٍ سياسي ساهم في تنمية وعيٍ حادّ بأن الرواية لا تُنقذ فقط، بل تُقاتل، وأن الصمت الإعلامي الغربي – الذي وصفته أنيتا كينسيليتو (2024) بـ"الإنكار النسوي المتواطئ" – لا يُقابَل بالصراخ فقط، بل بالأرشفة (نصار، 2024). كلّ منشور، كلّ صورة، كلّ صوت مرتجف هو تفكيك عملي للنظام التمثيلي الاستعماري، كما صاغته سبيفاك (1988)، حيث يُسمَح للنساء بالكلام فقط حين يتكلّمن عن موتهن، لا عن معرفتهن.
غير أن المقاومة النسوية الفلسطينية تتجاوز التوثيق. إنها تتجلّى بأوضح صورها في "الرعاية كمقاومة"، وهي ممارسة تبدو مألوفة للوهلة الأولى، لكنها تنطوي على فاعلية سياسية غائبة عن عدسات الإعلام والخطاب الأكاديمي.
حين تقول2 آيات خضورة: "النسوان سنَد لبعض"، فهي تُعيد تعريف التضامن النسوي كفعلٍ سياسي محلّي لا مركزي، يتحدّى تفكك البنى المجتمعية عبر العناية اليومية. وتروي أم ليان: "وزّعنا الخبز بيننا، ما حد أكل لحاله... حسّيت إنه هذا التضامن أقوى من أي سلاح" (2024). هذه الشهادات، التي وثّقتها النساء عبر صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل، تبرهن أن المرأة الفلسطينية لا تقاوم رغم أدوارها الاجتماعية، بل من خلالها. فأعمال الرعاية، الطهو، تنظيف قبر الشهيد، جميعها أفعال استراتيجية تقاوم الطمس وتؤسس لذاكرة جماعية بديلة.
هنا تتجسّد ما تصفه صبا محمود (2005) بالقدرة على الفعل من داخل التقاليد، حيث تصبح أفعال الرعاية اليومية – من طهو الطعام إلى رعاية الأطفال – استراتيجيات صمود سياسي تُقاوم النسيان والتهشيم الاجتماعي الذي يسعى إليه الاستعمار. تقول رنا (طالبة جامعية من غزة): "كلّ مرة بنسمع المستشفى انقصف، بحس إنه القصف مش علينا بس... كأنه على مستقبلنا" (2024).
وفي هذا السياق، يتكشّف التناقض الفجّ بين ما تُنتجه النساء من أرشيفٍ حيّ، وبين ما تُعيد وسائل الإعلام إنتاجه كمشهدٍ مكسور. تظهر تحليلات الخطاب أن المرأة الفلسطينية تُقدَّم في معظم قنوات الإعلام الغربي إمّا كأم باكية أو كجسد هشّ ينتظر العناية، وهو يعكس ما حذّروا منه بتلر (2009) حول تراتبية الحزن: ليست كلّ حياة قابلة لأن تُرثى. بالمقابل، ورغم انفتاح بعض القنوات العربية على إبراز المقاومة النسائية اليومية، فإن خطابها بقي مؤطراً في ثنائية "الأمومة البطولية" و"الرمزية الجمعية"، الأمر الذي يُغيّب الصوت الفردي النسوي خلف البطولات الجماعية (إحمود، 2025).
هنا، تظهر أهمية مفهوم "الجسد المؤرشِف للمحو والمقاومة" بوصفه أداة تحليلية تُعيد موضعة الفعل النسوي في سياقه الحقيقي: لا كأثر جانبي للحرب، بل كبنية إنتاج معرفي مقاومة. إن النساء يُمارسن التوثيق لا لتجاوز الحزن بل لحفظه كذاكرة سياسية، هذا ما أظهرته معظم المقابلات والشهادات النسائية الفلسطينية، وهذا ما يتجاوز التحليلات التي تركّز على الأثر الجسدي للإبادة دون تفكيكٍ للبُعد الرمزي الذي تنتجه النساء من الداخل.
في هذا الامتداد النظري، تصبح الأمومة الثائرة كما في حالة دعاء الباز ليست فعل رعاية فحسب، بل مشروع مقاومة يعيد تعريف معنى الحياة ذاتها. إذ تقول3 الباز: "أنا أمّ للمقاومة"، وكأنها تعيد صياغة المفهوم من جذوره: لم تعد الأمومة حاجة فطرية، بل موقعاً لإعادة تنظيم المجتمع بعد المحو. كذلك، فإن فداء، التي دفنت زوجها ووزّعت المساعدات باليد ذاتها (2024)، تجسّد هذه الفرضية: أنّ كل جسد أنثوي في غزة هو موقع أرشيفي قيد التشكّل.
إن هذه الورقة، إذ تنحت مفهوم "الجسد المؤرشف للمحو والمقاومة"، لا تفعل ذلك فقط كرد فعل على غياب الخطاب العادل، بل كمساهمة فلسطينية نسوية أصيلة تُعيد توطين المفاهيم في موضعها الحقيقي: الجسد المُهان، الصوت الممنوع، والممارسة اليومية التي ترفض الصمت.
ما تكشفه هذه الورقة لا يقتصر على مساءلة التمثيل أو تحليل الرموز، بل يؤسس لخطابٍ نسوي فلسطيني قيد التشكّل يُعيد تعريف المفاهيم لا من خلال التنظير المسبق، بل من خلال الشهادة المُعاشة. ليس مفهوم "الجسد المؤرشف" مجرد محاولة لفهم الألم، بل لبناء أداة تفكيك تُسائل الاستعمار، وتواجهه باللغة، والندبة، والرعاية، والغضب. هذا الجسد، حين يُكتب عنه، لا يُستعاد فقط، بل يُستبقى، ويُخَطّ بذاكرةٍ تقاوم النسيان، ويُنقش على جدران الحكاية لا كندبة فقط، بل كخارطة خلاص.
Abu-Lughod, Lila. (2013). Do Muslim Women Need Saving? Cambridge, MA: Harvard University Press.
Barakat, R. (2017). “Writing/righting Palestine studies: settler colonialism, indigenous sovereignty and resisting the ghost(s) of history.” Settler Colonial Studies, 8(3), 349–363.
Butler, J. (2009). Frames of War: When is Life Grievable? London: Verso Books.
Ihmoud, S. (2025). “Countering Reproductive Genocide in Gaza: Palestinian Women's Testimonies.” Native American and Indigenous Studies, 12(1), 33–53.
Kynsilehto, A. (2024). “Feminist silences and silencing the critique of Gaza genocide.” Gender, Place & Culture, 32(10), 1467–1476.
Mahmood, Saba. (2005). Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton: Princeton University Press.
Shalhoub-Kevorkian, N. (2015). “The Politics of Birth and the Intimacies of Violence Against Palestinian Women in Occupied East Jerusalem.” The British Journal of Criminology, 55(6), 1187–1206.
Shalhoub-Kevorkian, N. (2023). “Reproductive Violence in Palestine: The Need for a Feminist Approach to Justice.” Opinio Juris. https://opiniojuris.org/2024/02/01/reproductive-violence-in-palestine-the-need-for-a-feminist-approach-to-justice/
Spivak, G. C. (1988). “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture, Nelson & Grossberg (Eds). Urbana/Chicago: University of Illinois Press, 66–111.
UN Women. (2024). Gender alert: The gendered impact of the crisis in Gaza. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/01/gender-alert-the-gendered-impact-of-the-crisis-in-gaza
أم ليان. (2024). شهادة شخصية. مقابلة شخصية، غزة.
رنا. (2024). شهادة شخصية. مقابلة شخصية، غزة.
فداء. (2024). شهادة شخصية. مقابلة شخصية، غزة.
ميس (2024). شهادة شخصية. مقابلة شخصية، غزة، محفوظة في أرشيف الباحثة.
نصار، هبة. (2024). تحليل 20 مادة إعلامية (تقريرات، أخبار، مقاطع مرئية، أو تصريحات رسمية)، تم جمعها من مصادر إعلامية ناطقة بالعربية والإنجليزية. محفوظ في أرشيف الباحثة.