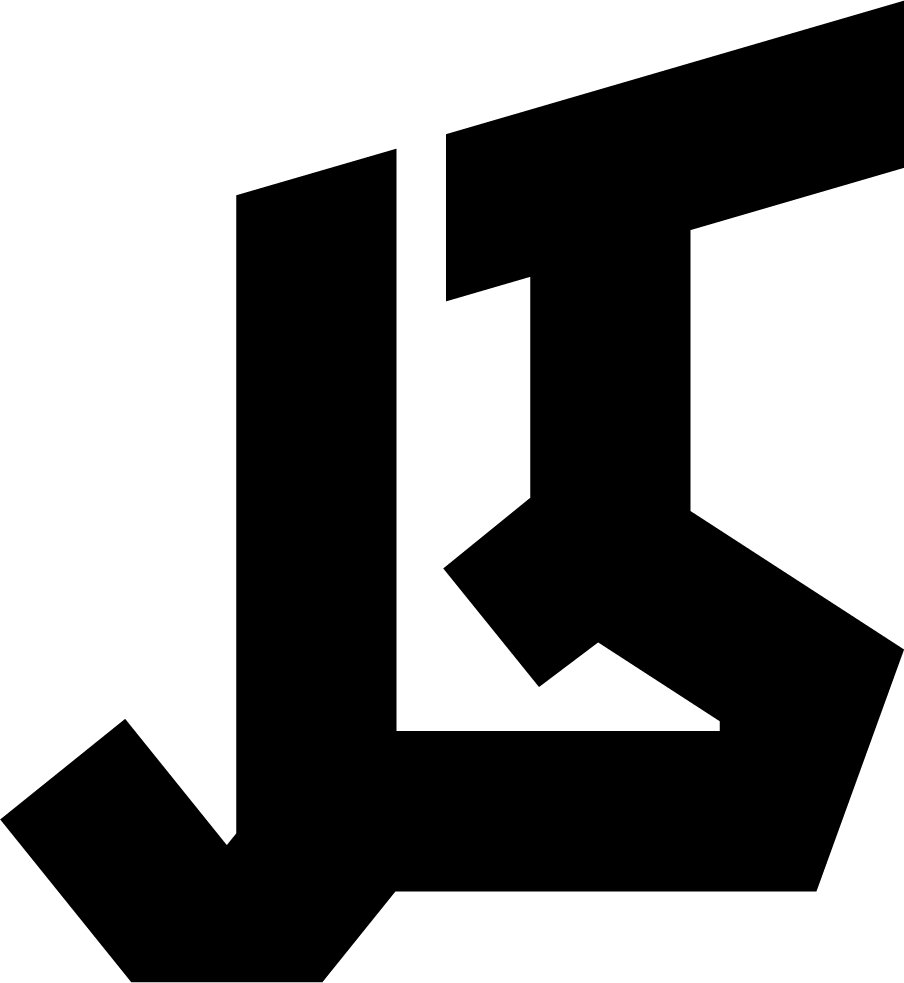شبح النسويات في عراق ما بعد تشرين: عن الغياب السياسي والشلل التنظيمي
nation_without_state_ar.jpg
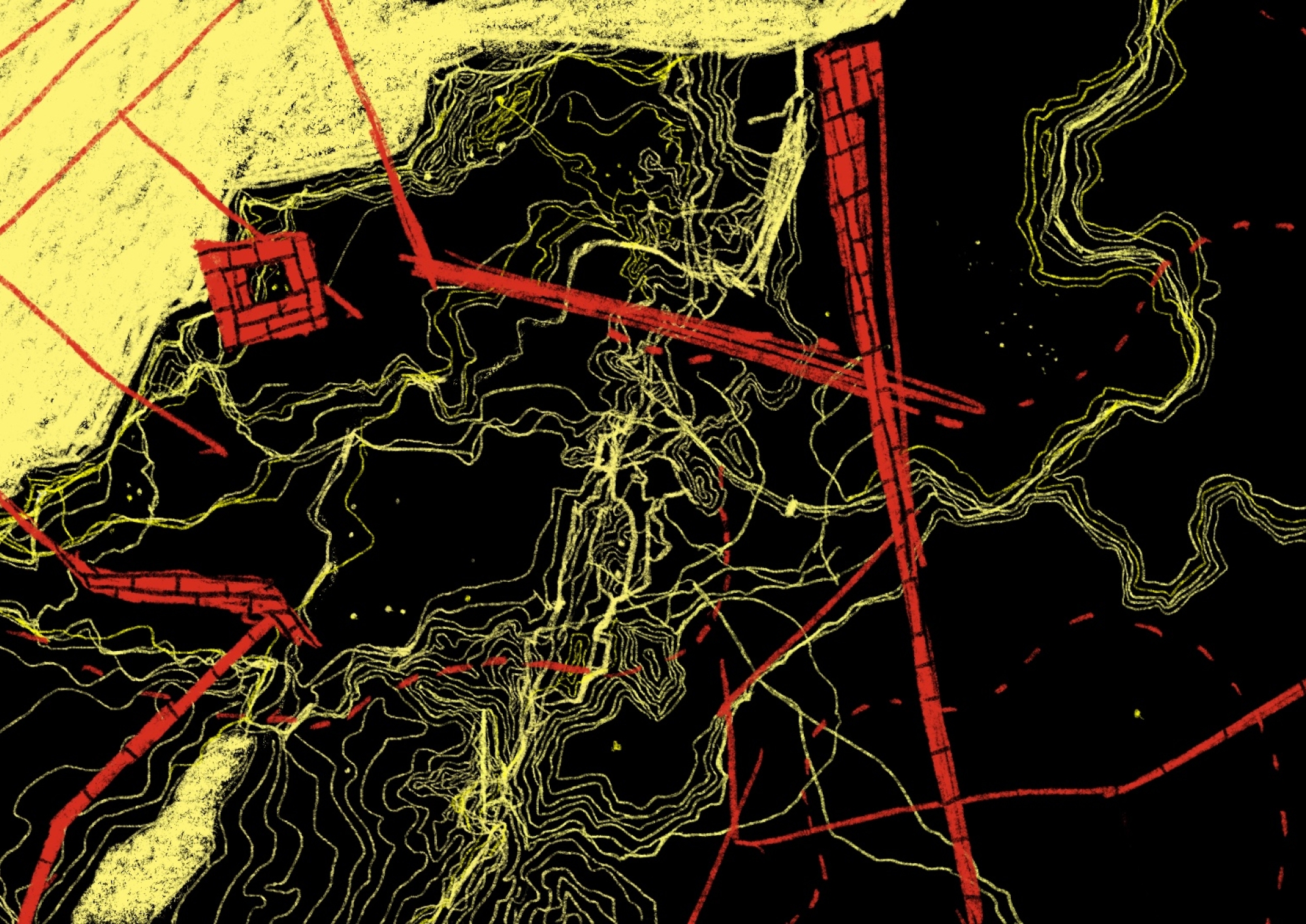
ميرا المير
تقديم
"صارت الكلمة تموت"، هكذا عبّرت إحدى النسويات عن إخراسها بسبب نسويّتها بعد انتفاضة تشرين 2019. لم تكن النسوية غائبة خلال الاحتجاجات التي عمّت البلد حينها، بل مُطارَدة ومُجبَرة على الصمت، صمتٌ جرى تسويقه على أنه هزيمة وانسحابٌ من المجال العام واعترافٌ بالعمالة للخارج من أجل "تدمير الأسرة العراقية المتماسكة".
قبل تشرين، تماهى الحراك النسوي مع السلطة، وخَلَق علاقات تعاونٍ ودعمٍ مشترك، ما لم يشكّل إزعاجاً وما دام يطرح قضاياه منزوعةً من البعد السياسي، ومن خلال منظمات شبه موحدة، مموَّلة من الأحزاب أو الجهات المانحة الخارجية، وجمهورها غالباً ما كان نخبوياً أو متعلّماً. لكن انتفاضة تشرين، بحضورها النسوي الكثيف، اصطدمت بجمهورٍ متنوّعٍ لم تعتده النسوية في العراق، ما دفعها لمواجهة نقاط ضعفها. ورغم وجود هذه الفرصة لترميم نقاط الضعف، فضّل الحراك الاحتفاء بالحضور العدديّ، معتبراً إياه انتصاراً على مدار عقدين، متجاهلاً الخسارات التي لحقت بالقواعد الجماهيرية، وهو ما أدّى إلى سلسلة من الصعوبات والتحديات.
يبقى السؤال معلّقاً: لماذا لم يتحوّل هذا الحضور إلى قوّة سياسية منظّمة؟ وما أسباب العجز عن استيعابه؟
اليوم يعاني الحراك النسوي في العراق من شللٍ تنظيمي، مع مؤسسات محدودة النمط ومرتبطةٍ بأساليب تمويل محدّدة، نتيجة حملات كراهية وتحريض وعنف مباشر من اعتقالات وابتزاز وإبعاد قسري إلى التضييق على الاحتجاجات النسوية وتجريد النسويات من أدواتهن وشيطنة النساء أمام المجتمع. ومع ذلك، كما يذكّرنا جاك دريدا، فإن الحضور لا يُفهَم إلّا من خلال الغياب؛ فالغياب النسوي الحالي ليس اختفاءً كاملاً، بل حضورٌ شبحيٌّ يُستدعى مع كلّ محاولةٍ للتغييب. فالنسوية بيننا ليست واقعاً سياسياً منظّماً، بل "فزّاعة" لتبرير استمرار العنف الرمزي لصالح المستفيدين منه.
في هذا المقال، أقدّم خلفيّةً سياقية للحراك النسوي العراقي قبل تشرين 2019، وأناقش تأثير نقاط ضعف النسوية على الحراك خلال الانتفاضة، وصولاً إلى مآلاته بعد تشرين: ضعف سياسي، شلل تنظيمي، وسكون نسوي. أستكشفُ الكيفية التي يُنتَج بها الغياب النسوي عبر حملات التشويه ووقف التمويل والتضييق الإعلامي وإقصاء الأصوات، وأطرح مفهوم "الشبحية النسوية" لفهم هذا الغياب والحضور المتناوب. كما أحاول توضيح كيفية مواجهة هذا الغياب الرمزي والتنظيمي عبر إعادة السرد وتوثيق التاريخ من منظور النسويات وإعادة التفكير بالتنظيم، أي كيفية الانتقال من كوننا أشباحاً إلى قوة سياسية فاعلة.
النسوية العراقية قبل تشرين
قبل تشرين 2019 كان الحراك النسوي في العراق نَشِطاً نسبياً منذ تحوّل العراق إلى النظام الديمقراطي (رشيد، 2017) وزيادة مساحة التعبير السياسي بعد سقوط نظام حزب "البعث" عام 2003، إذ أُعيدت ممارسة حقّ التنظيم والتجمهر (العلي، 2021)، وتضمّنه دستور 2005، ليبدأ النشاط النسوي مرحلةً جديدة شكّلت عموده الفقري وهي الشكل المنظّماتي للحراك النسوي (حميد، 2025).
هذا الطابع كان المسيطر، والنسوية في السياق العراقي ما تزال غامضةً لعامّة الناس بسبب التضليل المتعمّد (مصطفى، 2024). تشير النسوية المنظّماتية إلى الأنشطة والمؤسسات التي تعزّز حقوق النساء والمساواة الجندرية، سواء كانت منظمات نسوية مستقلّة أو برامج نسوية ضمن منظمات التنمية العامة (علي، 2018). تعمل هذه المنظمات على مكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز مشاركتهن السياسية، وتقديم برامج تمكين اقتصادي واجتماعي، وغالباً ما تتصرّف ضمن نفس منطق المنظمات النسوية من حيث الاستقلالية الجزئية، ما يجعلها جزءاً من الحقل النسوي المنظّماتي قبل تشرين.
مع ذلك، تعرّض هذا الحراك للشلل جزئياً، إذ أسست العديد من منظمات المجتمع المدني نفسها تحت عناوين عامة كالحقوق والتنمية، فتجنّبت موجات القمع، رغم تبنّيها أهدافًا نسوية (الخطيب). لكن بعض المنظمات ذات المشاريع النسوية تخلّت عن الصفة النسوية بعد حملات مناهضة الجندر، ما دفع إلى إعادة التفكير بأهمية التبنّي العلني للعمل السياسي الفعّال (الخطيب).
قبل تشرين، تحوّل النشاط النسوي إلى نشاطٍ حقوقي بلا حسّ سياسي، حذّر من تناول القضايا النسوية من منظور سياسي، وركّز على الجانب الاجتماعي والقانوني لضمان استمرار التمويل. هذا الاعتماد على التمويل الدولي بعد 2003 خلق انطباعًا بأن النسوية مجرد منظمات ومشاريع مرتبطة بالتمويل، وليست حركة سياسية أو تنظيم مستقلّ (حميد، 2021).
نتيجة ذلك، أصبح الحراك مقيّداً بين منظّمات مدعومةٍ من الأحزاب أو بتمويلٍ دولي، بعيداً عن القاعدة الشعبية، ممّا جعل المشاركة النسوية المباشرة في الشارع تعكس غياب بنيةٍ تنظيمية حقيقية، وهو أبرز نقاط الضعف التي انعكست خلال انتفاضة تشرين. المرحلة هذه اتّسمت بـ"نسوية مطلبية"، بلا استراتيجية واضحة أو رؤية تنظيمية، حيث ظلّت المؤسسات النسوية حبيسة البُنى السلطوية التي تسعى لتجاوزها (جلبي، 2023).
تشرين كانثناءٍ نسويّ
في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 تفجّرت انتفاضةٌ كانت كالعاصفة ذرّت رمادها في وجه كلّ قوى الإسلام السياسي وتحديداً الشيعية منها (السعيدي، 2020)، لجرّهم البلاد إلى مستوياتٍ غير قابلةٍ على الاحتمال من سوء الخدمات والفساد المالي والإداري والمحاصصة والبطالة التي نالت حتى من حَمَلة الشهادات العليا، ناهيك عن غياب سيادة البلاد على نفسها وجعلها عرضةً للتدخلات الإقليمية والدولية (محمد، 2019)، لكنّ القشّة التي قصمت ظهر البعير كانت بإنهاء احتجاجات الخرّيجين والخرّيجات من حَمَلة الشهادات العليا ومن الأوائل على الجامعات وهم بصدد المطالبة بحقّهم بالتعيين الحكومي، فتعرّضوا للعنف ووُجهوا بالماء الحارّ والغاز المسيّل للدموع والذي هتك عرض النساء المحتجّات بشكل استفزّ الناس لكونهن نساء أوّلاً (محمود، 2022) ومن الطبقة المتعلّمة تعليماً عالياً. وشملت تحرّكات الانتفاضة العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية ومدن الفرات الأوسط من العراق، قادها بشكل أساسي الشباب من طلبة الجامعات وشاركهم فيها بقية الفئات العمرية (الجزيرة نت، 2019)، حيث كانت تحضر الطالبات للساحات في أوقات الدوام صباحاً والرجال يواصلون المرابطة لبقيّة اليوم، حتى تمّ إغلاق دوام الجامعات بالكامل نتيجة العصيان الذي قام به الثوار.
لكن نزول الطالبات للساحات لم يكن بالأمر السهل تماماً فخرجن خلسةً عن أهاليهن أو بعد محاولات إقناعٍ مطوّلة، أو برفقة ذويهن، والغالبية منهن خرجن مع الحرص على عدم إظهار وجوههن فارتدين الكمّامة الطبّية أو اللثام ليتجنّبن محاولات التهديد والابتزاز. انصبّ تواجد النساء بشكل أساسي في الإسعاف والتطبيب وتقديم العمل الرعائي بكلّ أشكاله، وانتشرت لاحقاً بعد الحصول على هامش من الأمان في الساحات الفرق النسوية الفنّية التي ظلّت تعبّر عن المطالب الوطنية بالرسم على جدران الأنفاق (ابو غنيم، 2021).
كانت ثورة – كما يستطيب لأهلها تسميتها – ذات توجّه مدني علماني واضح (نظمي وحاتم، 2022) وكانت الرغبة بالإصلاحات الجذرية هي المسيطرة مع أنها طالبت رسمياً وعبر الشعارات بالإصلاح القانوني والسياسي ما جعل الحلم بتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين ليس مستحيلاً بل مهمّاً وتحويلياً (مكي، 2021).
إنّ تواجد النساء في الاحتجاجات موجودٌ منذ أربعينات القرن الماضي وفي الموجات الاحتجاجية الأربعة (نظمي وحاتم، 2022) التي سبقت تشرين ولكنه كان وجوداً شبه مقتصرٍ على الفاعلات في منظمات المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية العلمانية، لكن في تشرين كان الوجود العددي النسوي ملحوظ بشكل كبير، ضمّ ربّات بيوت وعاملات وغير متعلّمات وفتيات يافعات وشابّات لم يسبِق لهن الخروج للفضاء العام بهذا الشكل. ما جعلها لحظة احتجاجية فارقة في كثافتها وزخمها وتضحياتها لإحداث التغيير السياسي بالمقارنة مع موجات أخرى سبقتها، فأسقطت حكومة وأجبرت السلطة على إجراء انتخابات مبكرة وإصدار قانون انتخابات يرتضيها، وما ميّزها هو النزعة الشبابية وأنها قدمت ثورية مستميتة لمفهومين انتزعهما النظام السياسي من جوهر كينونة المجتمع ألا وهما الوطن والمساواة اللذان تجسّدا بالشعارين "نريد وطن" و"نازل آخذ حقّي" (نظمي وحاتم، 2022)، فهي تعتبر آخر محاولة جماهيرية للتمرّد المدني على الأقل لحين كتابة هذه الورقة.
مشاركة النساء في الاحتجاجات على اختلاف الانتماءات الطبقية والعمر والمستوى التعليمي والمهني، كانت نقطة القوة في إدامة التظاهرات، إذ إنّ مجرد الحضور المادي للنساء في ساحاتٍ عامّة كانت حكراً على الرجال أحدث فرقاً مهمّاً للثورة نفسها وليس للنساء فحسب – وهو ما جعل هلع السلطة من الثورة انتقامياً منهنّ فيما بعد – فضلاً عن إمداد الثوار بالأعمال الرعائية كاملةً. وحتى النساء اللواتي لم يستطعن التواجد في ساحات التظاهر وجدنَ طريقةً للحضور رغم التغييب القسري بسبب الحبس المنزلي الممارَس عليهن من قبل الأهالي ونظرة المجتمع أو بسبب بُعد سكنهن عن مواقع الاحتجاج، وقد عبّرن عن دعمهن للثورة ولمطالبهن الوطنية حيث وقفن على أرضية مشتركة مع الرجال من حيث المطالب. أما مطالبهن النسوية فقد رفعنها وطالبن بها عبر الفضاء الرقمي، بسبب تهميش أصواتهن لكون تنسيقيات الاحتجاجات تقودها لجان ذات غالبية من الذكور قيّدت رفع تلك المطالب تحت ذريعة أنها "تشتّت التظاهرات". وهؤلاء كانوا في ذات الوقت يعمدون إلى وضع النساء بالمقدمة عند حضور كاميرات الإعلام العالمية أو خلال البث الحيّ أثناء قراءة بيانات التنسيقيات، البيانات التي لم تشارك النساء في كتابتها. هكذا عند البحث عن ثورة تشرين العراقية على الانترنت تجد أن غالبية صورها تُظهر النساء الثائرات في المقدمة، ليتحقّق بذلك الحضور المرئي لكن بغياب التأثير الحقيقي (بورديو، 1994).
إنّ التقسيم النمطي للأدوار بين المحتجّين والمحتجّات وجد امتداده من المنازل إلى ساحات الاحتجاج حيث كان الرجال في الصدّ والمواجهة والتحشيد والتخطيط والتنظيم وصياغة الأفكار والبيانات وبقيت النساء في الخطوط الخلفية في ممارسة الإسعاف والتطبيب والأعمال الرعائية واللوجستية من طبخ وخَبز وتنظيف وغسيل الملابس… ومَن واصلن الاحتجاج بلا مطالب نسوية، وتحديداً من الفئات غير المطّلعة على تاريخ الاحتجاجات النسوية، اعتنقن فكرة الرجال واعتبرن أن مطالبهن النسوية ستتحقق بمجرد انتصار الثورة وتحقيق المطالب الوطنية، وفئة لا يُستهان بعددها كُنّ يعلّلن وجودهن الاحتجاجي بـ"دعم" الثوّار فقط، أي أن دورهنّ انحدّ بمساعدة ومساندة فاعلٍ آخر وهو بصدد الدفاع عن حقوقه أو قضيته وهو هنا الرجل. إن وجود القاعدة الجماهيرية للنسوية من النساء في ساحات الاحتجاج بغض النظر عن الدور الذي قمن به كان لحظة انفلاتٍ من قبضة السلطة لم يستطع الحراك تثمينها أو استغلالها كفرصة من الصعب تكرارها واستثمارها في بناء بنية تنظيمية دائمة تكون فيها "تشرين" نقطة الصفر.
عندما نظّمتُ مع "خيمة المرأة" جلسة نقاشية نسوية داخل ساحة الصدرين في النجف وكان معي طفلي ذي الـ14 شهراً في عربته، ناقشتُ أهمية أن يكون لنا مطالب نسوية، حينها تجمّع ثوّار من الرجال حولنا وكانوا يناقشوننا بحدّية أقرب إلى العدوانية وكأنّ مجرّد نقاشنا خطر على الثورة. اعتبروني حينها مبعث فرقة في جلستي تلك وليس مبعث "دعم" كما تصوّروا، وحاولَت حينها الحاضرات امتصاص غضبهم بمسايرتهم قليلاً ثم إنهاء الجلسة بشكل لطيف. مطالبنا بالنسبة لهم تافهة لا ترقى إلى هموم الرجال والثورة والدولة. إنّ تكرار تلك المواقف يتطلّب مقاومة إرجاع مطالب المرأة إلى الخلفية، بغضّ النظر عن الظروف. فما هو "عاجل" من المطالب هو كذلك لأنه ببساطة قد تقرَّر من قبل الحكم الأبوي الذي يضع نفسه كالمقياس والمعيار، بما في ذلك ما يتعلّق بالمتطلّبات الاجتماعية، وهذا خطاب يجب الانتفاض ضدّه (ستيبو، 2019).
إنّ عجز المنظمات النسوية بضخامتها وأموالها وأسبقيتها في العمل النسوي منذ عام 2003 من تكوين تكتّل نسوي احتجاجي قادر أن يفرض نفسه بمقدار حجمه وتأثيره في الساحات وبمقدار التضحيات التي تقدّمها النساء نظير تواجدهن في الاحتجاجات، مكّن الشابات الجدد اللواتي استثمرن فرصة التواجد اليومي معاً للمناقشة والتلاقح الفكري والثوري من تكوين فرق وتنظيمات نسوية أو مجتمعية خاصة بهن. فظهرت نساء ناشطات لم يسبق أن أنتمين للمنظمات أو جماعات حقوق المرأة فأنشأن باعتصامهن في الخيام مساحات بديلة، وقد اعتبرت السلطات تحدّي المتظاهِرات للمعايير الجنسانية الأبوية، تهديداً للنظام بأكمله (مصطفى، 2025).
إلّا أن النساء المحتجّات دفعن تكلفة هذا التواجد أغلى من المكتسبات التي حصلن عليها، حيث تنبّهت السلطة والميليشيات إلى نقطة قوة الاحتجاج وضعفها تلك فعمدت إلى ضرب الاحتجاجات من خاصرتها الهشة بمجتمعٍ لم يألف ظهور النساء في الفضاء العام بهذا الشكل، فروّجت السلطة عبر أساليب عدة من بينها خطابات قادة سياسيين أمثال مقتدى الصدر الذي أسس لهذا الصدع منذ تشرين 2019 (العمّار، 2020) إضافة إلى رجال دين آخرين من مختلف المذاهب والطوائف حرّضوا الأهالي على النساء بتشويه صورتهن واتهامهن بأنهن محظيات للثوار ورغباتهم الجنسية. لكن المحرّضين لاحظوا أن النساء وبمساعدة الثوار قاومن تلك الخطابات بالتواجد المكثّف على الأرض فانطلقن بمسيرات نسوية يحميها الثوار من كل جوانبها تحت شعار "بناتك يا وطن" و"صوت المرأة ثورة وليس عورة" وذلك للردّ على تغريدة الصدر بأن صوت المرأة عورة ويجب ألا يصدح في التظاهرات. انتقلت المحتجّات في هذه المسيرة من المواقع الخلفية إلى الأمامية وقد حُرّف الشعار لاحقا ليصبح "عاهراتك يا وطن" (علي، 2023) وصارت المشارِكات حذِرات حتى من ذكرها أو تناولها في أي نقاش.
ولاحقاً، تمّ تصعيد سياسة طرد النساء من الساحات عبر أعمال الخطف والاغتصاب والابتزاز بنشر صورٍ ومقاطع فيديو لهن أثناء الاعتقال أو صور خاصة من هواتفهن… وقد حقّقت تلك الأساليب الترهيبية ما أرادته السلطة وميليشياتها إذ تناقصت أعداد النساء في التحرّكات بشكل ملحوظ وزاد منع الأهالي لهن من الاحتجاج (نجاح-بغداد، 2020)، ثم أمتدّت سياسة الطرد من الفضاء العام إلى الفضاء الرقمي عبر التهديد بالتصفية الجسدية أو الحرق الاجتماعي بالوصم "بنات الخيم" على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل وعلى أرقام الهواتف الشخصية. وفي ظل كلّ تلك الخسارات بسبب غياب التكتل النسوي السياسي ومطالبه النسوية لا يمكن القبول باختلاط الأجساد في الساحات على أنه مطلب من أجندة نسوية بحد ذاته (علي، 2021).
ومنذ اللحظة التي أطلق فيها رجال الدين خطاباتهم التحريضية ضد النساء ظهرت موجة التقيّة1 النسوية الأولى كما أُسميها. هنا، صار الخطاب النسوي حذِراً ومقيّداً في كافة الفضاءات العام منها والخاص والرقمي.
ولادة الشبَحية النسوية
كنتيجةٍ لانتفاضة تشرين أُجريت انتخابات مبكرة عام 2021، لنشهد مناخاً سياسياً نستطيع أن نصفه بأنه سامّ أو غير مرحِّب بالنساء على أقلّ تقدير سواء من القوى السياسية المدنية التي انبثقت عن الانتفاضة أو من قوى الإسلام السياسي الموجودة منذ عام 2003، ففي الوقت الذي توصَم به النساء المحتجّات بـ"العهر" كان الرجال من المحتجّين يعتبرون أن النساء ليس لهنّ باع في السياسة وقليلات معرفة في التشاور والتنظيم وكتابة البيانات ومناقشة الأفكار لمواصلة الحراك (الحسن، 2022).
نظرة الرجال الاستعلائية تلك مهّدت لسياستهم تجاه النساء "التشرينيات" بشكلٍ خاص وتجاه النساء بشكل عام ما بعد الثورة حيث عمدوا إلى تنظيم أنفسهم في أحزاب وتحالفات وحركات كان وجود النساء فيها رمزياً، ودفع التحيّز الجندري الكثير منهن الى مغادرة تلك التنظيمات (الحسن، 2022)، هذا التحيّز هو انعكاس لما واجهته النساء في ساحات الاحتجاج وامتداد له. إذ دافع الكثير من هؤلاء بقوة عن قوانين إسلامية متطرّفة قاهرة للنساء كتعديل مواد الحضانة وسَنّ المدونة الجعفرية بدل القانون المدني الحامي لحقوقهن والمدافعة عن سَنّ قانون البغاء الكاره للنساء وغير المبالي بالأوضاع الاقتصادية ثم مساندة حملة مناهضة الجندر التي استهدفت النسويات والنسوية بالتواطؤ بالصمت على أنه "الحياد" الذي اختاروه، والجهر بالفرح لحظر مفردة "الجندر" (إنان.م.بلاي، 2024).
أُجريت الانتخابات المبكرة بعد عامين على الانتفاضة، وأثناء عمل حكومة تصريف الأعمال حصلت المنظمات والفرق والتنظيمات النسوية التي انبثقت من تشرين على هامشٍ من الحرية للعمل النسوي بشكل راديكالي نوعاً ما، وثورية مستمَدّة من الحراك نفسه وركزت في هذه المرحلة على النشاطات المعنية بالتمكين السياسي للنساء وتعليم ممارسة الحقوق السياسية وآليات مواجهة العنف السياسي آخذةً بعين الاعتبار مخاوف المحتجّات الراغبات بالعمل السياسي لكن الخائفات أيضاً من أذى المليشيات الانتقامي المحتمل، فيما كان التعبير عن المطالب النسوية في احتفالات عيد المرأة وذكرى الانتفاضة بشكل مسيرات أو مظاهرات في الميادين العامة كبيراً ومهيباً ومشجّعاً على خلق المزيد من الفعاليات إلّا أنه كان مُراقباً عن كثب من قبل السلطة.
فمنذ عام 2003 يشكّل الاحتفال بالثامن من آذار استعراضاً للوجود النسوي وحجمه البشري في بغداد والمحافظات وفي مرحلة ما بعد تشرين كان الوجود النسوي قوياً لدرجةٍ استدعت الحكومة تأمينه بقوات مكافحة الشغب (الحزب الشيوعي العمّالي العراقي، 2022) وبمعدّل جندي واحد تقريباً لكل متظاهرة ممّا أثار استغراب وسخرية المحتجّات العزّل اللواتي لا يحملن سوى لافتات وحناجر تردّد شعارات نسوية. لكن هذا الحشد الكبير بدأ يتلاشى بشكل تدريجي لاحقا ًبعد ممارسة السلطة أساليب العنف الرمزي ضده.
في منتصف عام 2022 شيّد البرلمان نفسه بعد سلسلة من الحل والعقد بين الكتل السياسية ذات الأجنحة المسلّحة لتنتهي بغالبية قوى الإطار التنسيقي الموالي لإيران (الدباغ، 2022) والحانق على المحتجين الذين حرقوا غالبية مقاره في مختلف المدن والراعي للمليشيات التي نكّلت بالمحتجين ووقفت جنباً إلى جنب مع الحكومة (كولي، 2020) في قمعها للثورة، وكمن يفرك راحتيه حماسة وتلهّفاً فركت تلك القوى راحتيها للانتقام من المحتجّين والمحتجّات ومن المنظمات على اختلافها وبالأخصّ المنظمات النسوية.
جاءت الحكومة الجديدة محمَّلة بعدّة مخاوف ولم تجد سبيلاً لتبديدها إلّا عبر تغييب النسوية والنساء الفاعلات سياسياً وإطلاق حملات لمطاردتهن وافتعال ما أسمّيه بـ"الشبحية النسوية" أي خلق شبحٍ لتنفير الناس منه. ومن أهم مخاوف السلطة حينها، عودة الاحتجاجات بشكل عام وتواجد النساء الداعم فيها بشكل خاص، فعمد النظام إلى بثّ أفكار حول انعدام جدوى الاحتجاجات بدلالة رجوع القوى الممسكة بالسلطة وبشكل أكثر رسوخاً إلى الحكم بعد انتفاضة تشرين. والتخوّف الثاني كان الخوف من عدوى الاحتجاجات الإيرانية (الروابط، 2019)، أي أن تطال تلك العدوى العراق ذي الحكومة الموالية لإيران والمدعومة منها، فصار قمع النساء واجباً وضرورة للحفاظ على السلطة السياسية والسلطة الدينية والأبوية معاً. وقد لعب رجال الدين دوراً كبيراً في هذه الحملات دفاعاً عن "هيبتهم" ومخافة احتمالية تكرار حملة "أسقط عمامة" أو حرق الحجاب الذي حدث خلال الاحتجاجات الإيرانية.
بعد أول انتخابات عقب الثورة، استطاعت 97 نائبة من الوصول إلى قبّة البرلمان وجزء منهن "تشرينيات" لكن لم يُحدِث هذا الحضور تغييراً ملحوظاً بسبب المحاصصة الطائفية الجندرية المترسّخة التي تشهدها البلاد منذ عقدين، وبسبب العنف السياسي الذي يتعرضن له داخل البرلمان. عوملت النائبات وخصوصاً "التشرينيات" منهن كغير مرئيات حتى في الاحتفالات والمناسبات المتعلقة بالمرأة. لكن، وبشكل عام، لم يحصل بين تلك النائبات وقواعدهن الانتخابية وغير الانتخابية من النساء تبادل وجهات نظر ورؤى. وقد صوّتت في تلك الدورة الانتخابية 80 نائبة من أصل 97 لصالح تعديل قانون الحضانة المجحف ليُعدّ التمثيل النسائي في هذه الدورة هو "الأسوأ" (مجيد، 2024). الغياب السياسي للنساء كان يعلن عن وجوده في كلّ مرةٍ كان يُقضَم بها حقّ أو يُسلَب مكتسب بحضور كتلة نسوية عددية لم تستطع لمّ شتات نفسها لتكوّن قوة سياسية تتناسب مع هذا العدد الذي تخطّى الكوتا المحددة بـ83 نائبة.
في البرلمان نفسه يتم قمع الأصوات النسوية من قبل قادة الكتل ويتعرضن للإخراس القسري عند الاعتراض سواء في الجلسات العامة أو جلسات اللجان عندما يتحدثن بشجاعة عن حقوق المرأة كما حدث مع النائبة نور نافع المنبثقة من قوى تشرينية. إلا أن هذه الحالات ظلّت فردية ولم تتحوّل إلى حركة نسائية برلمانية جماعية ذات معالم واضحة تتبنّى قضايا المرأة بشكلٍ مؤثّر (مجيد، 2024)، ليتجلّى إنكار وجود المرأة – السياسية لمجرّد كونها امرأة، علامة على العنف الرمزي الذي تتعرض النساء له حتى يومنا هذا. فعندما تواجه النساء صعوبة في تأكيد سلطتهن، وعندما يتمّ التشكيك في مؤهلاتهن على أساس جنسهن يتمّ الاستيلاء على أفكارهن من قبل الرجال (الحسن، 2022)، أما السواد الأعظم منهن وجدن في الانصهار مع البنية الذكورية وسيلةً للبقاء في مناصبهن وترددن في التعبير عن قضايا النساء خشية أن يعرّضهن ذلك للتشهير أو الابتزاز.
في كانون الثاني/يناير 2023 أطلقت الحكومة العراقية منصة "بلّغ" (وزارة الداخلية، 2023) التي استهدفت صناعة المحتوى الإلكتروني "المسيء" حسب تعبيرها، من دون أن تشرح أو توضح معنى "مسيء" وحسب أي معايير يُصنَّف أي محتوى بالمسيء. أثار هذا الأمر الخوف لدى المدونين والمدونات الذين ينتقدون عمل الحكومة والمليشيات. بدأت الحملة باستهداف صنّاع المحتوى من النساء وتحديداً ممّن يعتبرهن الشارع العام غير شريفات أو بنات ملاهي ليلية (الموسوي، 2023)، كن جانيات متفق ضمنياً على تذنيبهن، لنلحظ بعدها إصدار سلسلة من القوانين واللوائح والسياسات التي شكّلت شكل الخطاب الأخلاقي في هذه المرحلة (مصطفى، 2025).
بمجرد أطلاق المنصة ظهرت حسابات روّجت لفكرة أن النسويات يجب أن تشملهن الحملة وبعضها اقترح ذكر روابط الحسابات والصفحات النسوية للتبليغ عنها ما دفع الكثير من النساء اللواتي كنّ ينشطن في المجال الرقمي إلى تعطيل حساباتهن وإغلاقها نهائياً. لم يكن تسلسل الأحداث يجري بشكل بريء ففي فترة حكومات تصريف الأعمال ظهرت محاولات من الأحزاب السياسية لخلق منظمات نسوية تابعة لها تدّعي الاستقلالية عن السلطة وذلك بهدف خلق نسوية متواطئة تصلح لأن تُقدَّم لاحقاً كنسوية بديلة تعكس ما تريده الدولة من الحراك النسوي. منظمات تتناول قضايا النساء بشكل سطحي تهدف إلى إظهار صورة النظام الديمقراطي تجاه الخارج واحترامه لقيَمٍ تجعله مقبولاً أو معترفاً به ولو ظاهرياً أمام المجتمع الدولي.
وبالفعل استطاعت أحزاب السلطة استمالة عددٍ من المجموعات والمنظمات والتنظيمات النسوية، إضافة إلى المؤثّرات والناشطات النسويات المستقلّات. تعرّف تشاندرا موهانتي التواطؤ كأفعالٍ وكلماتٍ تخدم بنية القوّة العظمى حتى عندما يُقصَد بها الاعتراض، ويحدث التواطؤ النسوي عندما يتبنّى الخطاب النسوي خطابَ الطرف الظالم، أو عندما يدعم النشاط النسوي البُنى الظالمة بفعالية (موهانتي، 2006)، وقد اصطّفت عدد من المنظمات النسوية العراقية الى جانب الدولة مرّة بالحياد السلبي ومرة بالانصهار مع خطابها ونشاطاتها. كمثل التسويق لوعودها ودعم مشاريعها كالإعلان عن إعداد الحكومة "الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)"، التي تضمّنت محاور مثل المشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي ومحاور اجتماعية مختلفة (سكاي نيوز، 2023) ما ساهم بامتصاص حماسة النساء للتحشيد لاحتفالات "يوم المرأة" مثلاً ومنهن من انسحبن من الخطط المعدّة للنضال النسوي في هذا اليوم، ليطرح تكتيك السلطة هذا ثماره بعد مدّة وجيزة من اعتماده.
النسوية بعد تشرين
بالنسبة للنساء وللحركة النسوية في العراق لم تنتهِ انتفاضة تشرين كفعلٍ استفزّ السلطة والمليشيات بفكّ الخيم وتفريغ الساحات وخلق الأحزاب المنبثقة منها ودخول البرلمان وما تلا كل ذلك من خيبات أمل وانقسامات ولا بإعادة التموضع التي قامت بها المنظمات النسوية، بل انتهت حقّاً في المرحلة التي استقرّت فيها الحكومة جامعةً كل القوى التي انفجرت تشرين ضدها.
في تموز/يوليو 2023 ظهرت حملة "مناهضة الجندر والانحراف الاجتماعي" التي جاءت متّسقة مع حملة مناهضة مجتمع الميم عين العابرة للحدود الوطنية والتي مثّلت دفاع البطريركية عن نفسها التي فقدت جزءاً كبيراً من قدرتها المعيارية بعد انفجار مفهوم الجنسانية التقليدي وظهور النقاش حول ما تسمّيه بتلر اضطراب الجندر الذي يمثّل فضح الاضطراب أو التشوش أو القلق الذي أصاب هوية الجندر (المسكيني، 2023). هنا، بدأت موجة التقيّة النسوية الثانية ومعها لاحظنا التغييب النسوي بشكل واضح نتيجة الإرهاب الممنهج من قبل السلطة وأذرعها غير الرسمية تجاههن.
كان هدف حملة "مناهضة الجندر والانحراف الاجتماعي" ضرب عصفورين بحجرٍ واحد أي ضرب حقوق المرأة والنسوية وهويات مجتمع الميم عين فاتّبعت تكتيكات مختلفة لتشويه سمعة الجندر (مصطفى، 2025)، بدأت بشرارة أطلقها الشيخ محمد اليعقوبي الزعيم الروحي لحزب "الفضيلة" الإسلامي المعروف بعمله الحثيث للتخلّص من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 واستبداله بآخر جعفري ديني منذ عام 2004.
لم تستطع النسويات تحديد هوية خصومهن بالضبط هذه المرّة كأشخاص أو كمؤسسات، إذ شاركت في الحملة أطراف مستفيدة وأخرى مُضلَّلة وأخرى تمّ جذبها من منطقة الحياد واللامبالاة نصرةً للدين. وبخلاف العنف المادي أو المباشر الذي يكون هدفه محدداً، يتّخد العنف الرمزي عدّة أشكال وأنماط تشكّل في مجملها إشارات أو رموز للمواجهة غير المباشرة، حيث يعمد فاعلوه على التخفي دون الظهور علانية (بورديو، 1994). حملة من المتطرفين أخضعت السلطة وأجبرتها تحت ظل الضغط الاجتماعي المخلوق من قبلهم على التنصّل من مصطلح "الجندر" ونبذه فظهرت تعليمات منعت تداوله أو حتى ذكره في التدريبات وأجبرت الناشطات النسويات على توقيع تعهّد خطّي يقضي بعدم تناوله بالمطلق (مصطفى، 2025). كما غيّرت السلطة اسم دوائر "تمكين المرأة" إلى "دائرة شؤون المرأة" وضيّقت أكثر على تمويلها الحكومي. تلك الدوائر عملت مع نسويات النسوية البديلة المتواطئة التي صنعتها السلطة واللواتي يبرّرن عملهن التسطيحي فيها على أنه أفضل من ترك الساحة بالكامل حتى في ظلّ انكشاف نوايا الحكومة.
وُصفت هذه الحملة بأنها سعار ضد النسويات (مصطفى، 2023) بشكل خاص والنشاطية المدنية بشكل عام، جُرِّدت فيها النسويات من الحقّ في التعبير عبر الوصم والتشويه خصوصاً في وسائل إعلام كرّست نفسها على مدار شهور لبثّ خطابات كراهية حادّة ضدهن، مستقاة بشكل أساسي من رجال دين، عمدوا إلى تضليل الناس وإقحامهم في مصطلحات أكاديمية معقّدة. كما استعان مطلقو الحملة ومؤيدوها بجيوش الكترونية تحوّلت حرّاساً للأبوية تصطاد النسويات وتلاحق حساباتهن على مواقع التواصل وتشهّر بهن بهدف ترهيبهن وإخفائهن.
هكذا أصبحت كلمات مثل "تشرينية" أو "سيداو" (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) محمّلة بالوصم والإهانة ولم تستطع النسويات حينها مواجهة ذلك إلّا بالصمت والانكفاء، حيث يمكن تقسيم أفعال العنف الرمزي ضد المرأة هنا، إلى فئتين فرعيتين: أفعال الارتكاب وأفعال التقصير. هامش أفعال الارتكاب يشمل التحريض على الاعتداء الجسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات والتحرشات الجنسية والجهود الاستباقية لإسكات النساء في الحياة العامة من خلال الوسائل القانونية أو العلنية… أفعال اضطرت الكثير من المنظمات النسوية والناشطات النسويات إلى تعطيل حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل وحذف المنشورات والصور التي توثّق عملهن النسوي. أما أفعال التقصير فهي تتسم بالإهمال، مثل جعل المرأة غير مرئية وإهمال مطالبها، كمثل تعرُّض العديد من الأكاديميات النسويات للتحييد ومنهن من تمّ أبعادهن عن عضوية اللجان أو المجالس المتعلّقة بشؤون المرأة كاللجان الجامعية والمؤتمرات المزمع عقدها.
بعد هذه الحملة، صار الاعتماد شبه كامل على تضامن نسويات الخارج من عراقيات وعربيات. وأدّى عجز النسويات العراقيات عن مواجهة الحملات الشرسة وعن التضامن مع بعضهن بشكل علني وملموس إلى تسرّب الاضطرابات إلى داخل الحركة النسوية نفسها، إذ قامت بعض الناشطات بمراجعات نقدية قاسية وغاضبة كشفت هشاشة التنظيمات. فقد واجهت معظم مَن تعرّضن للهجوم العاصفة وحدهن دون دعم مؤسسي من منظماتهن (حميد، 2025).
قبل الحملة كانت السيطرة للأقدم جيلًا والأكثر خبرة نضالية (جلبي، 2023)، ما جعل الحركة تُدار وفق هرمية لم تُناقَش كفاية. أما بعدها، فقد أثارت الأزمة موجة انسحابات علنية وصامتة، وتركت غياباً جسدياً وحضوراً طيفياً داخل المنظمات. هكذا ومن غير قصد، دفعت الحملة النسويات إلى فتح النقاش المؤجَّل حول نقد التنظيمات النسوية من الداخل عبر الأجيال. أما المنظمات والفرق والروابط النسوية التي رفضت الشكل التقليدي للمنظمات النسوية وانطلقت بالعمل أثناء وبعد تشرين فسرعان ما تفكّكت حمايةً لسلامة الأعضاء ومنها من غيّر اسمه وأهدافه المعلنة ليصبح معنياً بالتنمية المستدامة مثلاً ومنها من أعلن أيقاف نشاطه حتى أشعار آخر ومنها من اختفت وكأنها لم تكن خاصة تلك التي تعمل بالتمويل الذاتي.
إن التجريد من اللغة كسياسة اتبعتها الدولة العراقية تجاه النسوية تمثّل محاولة إخراس عبر المنع من استخدام الكلمات والمصطلحات، ولا شيء أخطر من محاولة قطع حبل السرة الذي يربط الأنسان بلغته فعندما ينقطع هذا الحبل أو يتعرّض للاهتزاز ينعكس ذلك على كل الشخصية (معلوف، 2015)، فالمصطلحات هي الأدوات التي تمكّننا من وصف الظلم والاضطهاد ومنع استخدامها أو السخرية منها أو تحريف معانيها بهدف التضليل ساهم في الحرمان من حقّ الانتماء والمجاهرة بالانتماء للهوية السياسية النسوية التي تحملها تلك المفردات.
جعل التغييب النسوي القسري هذا الوجود التنظيمي النسوي موجود لكن محدود، تخلّلته محاولات بسيطة للملمة شمل ما تبقّى من المنظمات القادرة على مواصلة العمل. تقول رؤى خلف وهي ناشطة نسوية وعضو في "الهيئة الإدارية لشبكة النساء العراقيات" إنّ "ما تبقّى حاضراً من وجودٍ نسويٍّ قليل العدد مقارنة بحجم القضايا التي يجب ان تُعالَج". وبعد استقرار الحكومة، كان الاحتجاج النسوي على رأس أولوياتها الانتقامية إذ إن مجرّد تنظيم وقفة أو مسيرة نسائية يستدعي إجراءات رسمية مكثفة ونشر قوات أمنية لترويع المحتجّات، مع استفزازات واستجوابات غير رسمية وازدراءٍ علني لشعاراتهن (سكاي نيوز، 2023).
مع استمرار الشلل التنظيمي النسوي، تمّ تعديل مواد حضانة الأطفال لصالح الرجال، وظهرت المدونة الجعفرية التي تحيل قضايا الأحوال الشخصية للمذاهب الدينية بما يحقق مصالح الرجال، وظلّ الانشغال السياسي والاجتماعي بما اعتُبر "أهمّ" – مثل مقاطعة الانتخابات والتحالفات السياسية وتطبيق قانون الأحزاب – ما جعل قضايا النساء تُستبعد إلى الهامش.
التمويل كتهمة
استكمالاً لحملات تأليب الرأي العام على المنظمات النسوية تمّ نشر البيانات المالية لأهمّ المنظمات النسوية على قناة الحملة الأساسية في "تيليجرام" (الحملة المركزية لمناهضة الانحراف)2 وأعيد تداولها على مواقع التواصل مترافقة مع حملة شيطنة للمنظمات واتهامها بـ"العمالة لدول خارجية" و"ضرب تقاليد وقيم الأسرة العراقية"، ما ساهم في خلخلة ثقة الناس بتلك المنظمات. وهنا، طال الضرر البنية التمويلية التي كانت تشكّل شريان حياة المنظمات النسوية، وقد تفاقم الوضع مع التغيّرات التي طرأت على سياسات التمويل الدولية ما زاد من هشاشة هذه المنظمات وجعلها هدفًا سهلاً لخطاب السلطة. تخبرني لطيفة وهي مديرة لإحدى المنظمات فتقول "قرصنوا حساب الإيميل الخاص بالمنظمة واخترقوه وراسلوا الجهات الدولية التي أعمل معها وطلبوا المزيد من المال فاضطربت علاقات الثقة بيني وبيني المانحين وبيني وبين الموظفات اللواتي يعملن معي كون الوثائق التي تم نشرها كانت حساسة وخاصة. ما اضطرّني إلى حذف معظم المنشورات التي توثّق عملنا على مدار السنين". ومع أن التمويل يغذّي مختلف المنظمات من طبّية وإغاثية وتعليمية وبيئية وحتى دينية إلا أن التصوير العام المشيطن للتمويل حُصِر بالمنظمات النسوية والنسويات.
الحملة على التمويل فتحت أيضاً المجال لاستعادة نقاش مهمّ قديم حول اختيار مصادر التمويل وهي من الإشكاليات التي تواجه المجموعة وتهدّد هويتها (محمود وطنطاوي، 2016) ولكن التمويل ذي الشكل الواحد أي المنحة صنع الوهم بعدم القدرة على التعامل مع موارد قليلة بعمل بشري تطوّعي أو ذي تعويض مالي رمزي خصوصاً بعد سنوات من تلقّي مِنَحٍ بآلاف الدولارات وبرواتب للعاملات في المنظمات أكبر بكثير من المتوسط العادي للأجور في البلاد، لذا تبدو المشكلة في عدم الألفة لا عدم القدرة. وكأن كلّ ما حدث يجبر النسويات على النقد ومراجعة 20 عاماً من الحراك لإعادة طرح القضايا المؤجلة في النقاش النسوي.
ممرّات إلى الشبَحية
الممرّات إلى صناعة الشبَح ثلاثة: الأول هو شيطنة النسوية، والثاني دعم نظيرٍ نسوي مشوّه، والثالث تقديم النسوية التي تريدها السلطة بعد رفض الناس للأولى والثانية. تحاول السلطة والمليشيات ادّعاء استيعاب الحراك النسوي كدلالة لديمقراطيتها وصورتها المتحضّرة أمام المجتمع الدولي، ولتؤكّد أنها تحمل نفس المطالب النسوية لكن من نظرة إسلامية محافظة على التقاليد والأعراف، وبأنها لا تستمدّ أفكارها من "الغرب الكافر" كالنسوية العلمانية، وحاولوا تقديمها كنسوية طيّعة تنشد "العدل وليس العدالة" كما تقول الكليشيهات الإسلامية المعتاد سماعها عند الحديث عن المرأة. والحقيقة أن النساء في ظل سلطة أصحاب هذا الخطاب لا يحصلن لا على العدل ولا على العدالة.
ومع تفكّك التنظيمات النسوية وتراجع الحاضنة المؤسسية، لم يقتصر الأمر على إضعاف الحركة النسوية، بل جرى تصنيع بدائل محسوبة: نسوية متماهية مع خطاب الدولة وأخرى متواطئة بالصمت أو مشاركة في حملات تشويه الأصوات الجذرية. في هذه المرحلة تمّ إفراغ الفضاء العام من النسوية بوصفها حركة اجتماعية مستقلة، وقُدّمت للجمهور صورة بديلة مسيطَر عليها يسهل رفضها والسخرية منها، والنتيجة كانت فراغاً سياسياً تملأه ذاكرة حول النسوية كخطر أكثر مما هي حضور فعلي، إذ أصبحت النسوية تُستحضَر كاتهام أو تهديد لا كقوة فاعلة. وهنا يمكن فهم ما يحدث بوصفه انتقالًا من النسوية إلى شبحٍ حاضرٍ غائب يُذكّر بالاحتمال المخيف لعودتها (دريدا، 2006) لكنه محروم من الجسد والتنظيم الذي يمنحها الحياة.
النسوية مزعجة في ذاتها (أحمد، 2010)، فحتى محاولات النسويات المتملّقات للسلطة بالتماهي معها لم تحجب عنهنّ هالة الشرّ المضاءة حولهن، تستفزّ "كلاب الصيد" التي تسارع إلى تقليم أظافرهن كلّما نَمَت، حتى بعد أن تحوّلن إلى واعظات في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يجب أن يكون عليه العمل النسوي وواجباته تجاه البلاد، وحتى بعدما تخلّين دفعة واحدة عن المفردات اللغوية التي تشير للهوية النسوية من قبيل (أبوية، ذكورية، اضطهاد، جنسانية، تهميش، قمع...).
تخبرني الناشطة النسوية رؤى خلف، أنها عندما تجاهر بنسوّيتها أو تناقش مواضيع ذات أولوية تواجه ردوداً من قبيل: "النسوية هي التخلي، بتك تجيك ويا صحابها وتكلك عادي، بابا اتس أوك، وتلبس وتطلع براحتها واليوم تطلب تعليم باجر تطلب غير شي، إذا متردين تنظفين شعر اباطج عادي"،3 كمحاولة للتقليل من شأنها ومن آرائها.
إن صناعة الندّ المشوّه للنسوية الذي ينشر خطاباً تسطيحياً وجد مكانه الرحب في مواقع التواصل، حيث تمّ دعم ظهور شخصيات نسوية غالباً من صاحبات الامتيازات في المجتمع، ليتحدّثن عن حاجاتهن الفردية وكأنها مطالب نسوية. بشكل متواز ظهرت خطابات تجميل صورة المرأة التي تترك عملها من أجل أسرتها لتتمتّع بكونها مكرّمة من الرجل والمجتمع، وتمّ دعم ترندات من قبيل "فلوسك فلوسي وفلوسي فلوسك" لبث فكرة أن استقلالية النساء المالية بلا فائدة للأسرة رغم غيابها عنها من أجل العمل، وأفكار اخرى من شأنها التقليل من رجولة أزواج الموظفات باعتبار أن النساء المستقلات ماليًا مسترجلات بسبب الإنفاق على الأسرة (حميد، 2025)، إضافة إلى الدعوات لتقليص المساحة العامة للنساء، ويتقاطع كل هذا مع تزايد حالات التحرش والعنف والاعتداءات الجنسية على النساء.
على صعيد نسوي فردي، وبعد خلق ثنائيات النسوية المعتدلة/النسوية المتطرّفة والنسوية المخرّبة/النسوية البنّاءة، ازدادت تلك الرغبة الدفاعية عند النسويات بإظهار أنفسهن كأمّهات ناجحات ومربّيات فاضلات وزوجات مخلصات لكن ذلك لم يحل دون وصفهنّ بـ"المخّربات" و"الأنانيات". فلنتمتّع بوصف المخرّبات هذا ما دمنا فعلاً نرفض ونرغب بتخريب النظام الذي يحتجز النساء ويستغلهنّ ويوهمهن بسعادةٍ زائفة أو على أقل تقدير سعادة مهددة بالطرد والتعنيف والإفقار والحرمان من الفرص في أي وقت.
خلق نسوية دينية شيعية بديلة
في الوقت الذي قمعت فيه السلطة الوجود النسوي، قدّمت المؤسسات الدينية بشكل عام وتلك التابعة للأحزاب الشيعية والعتبات المقدسة بشكل خاص، وأبرزها الحضرة العباسية، برامج نسوية دينية شيعية صرفة، تركّز على الأدلجة الإسلاموية، فعمدت مثلاً إلى تحجيج آلاف الطفلات الصغيرات باحتفالات طقوسية مهيبة، وضخ المال الكافي لنقل حفلات التخرّج من الجامعات إلى فناءات العتبات بشكل ديني، ودأبت على تنظيم ندوات احتفالية بالشابات المرتديات للعباءة السوداء الزينبية داخل أروقة الجامعة لتكريمهن، بينما تُغرِق الماكينات الإعلامية الموالية لها مواقع التواصل بمقاطع فيديو تشيطن الطالبات غير المرتديات للعباءة (عز، 2024).
القاعدة الجماهيرية من النساء لم تشعر بأن ما يحدث مدعاة لإثارة قلقها، ورأته محض عراك بين "مخرّبات" وبين مَن يحاولون الحفاظ على المذهب، ولم تشعر بتهديد حتى عند سن القانون الجعفري المعدل لقانون الأحوال الشخصية رقم 188.
اعتمد الحراك النسوي بشكلٍ عام على الفضاء الإلكتروني للتواصل مع القواعد الجماهيرية، متجاهلًا أن نسبة وصول النساء لمواقع التواصل الاجتماعي لا تزيد عن 32% فقط (الساعة، 2023)، مما أضعف قدرته على التعبئة والتأثير، وخاصة في ظل الأزمات. كما تعقّدت إمكانية الوصول النسوي إلى شريحة واسعة من النساء بسبب تغييب الفاعلات النسويات من مناهج التعليم، وقصقصة أجنحة كل الأفكار التحررية التي تحاول الوصول إليهن وحجب أي معرفة نسوية رصينة لصالح هيمنة المناهج التعليمية المكرّسة للأيديولوجيات والسرديات السلطوية الأبوية (مصطفى، 2024). إذ تُستخدم النساء كمقاييس للانضباط الاجتماعي، وكحدود أخلاقية يُمكن من خلالها تعريف "الالتزام" و"الرجولة" و"الهوية المجتمعية" (صالح، 2025).
بهذا يتحقّق هدف النسوية البديلة، وهو تكوين الصورة التي يُراد أن تكون عليها المرأة العراقية، صورة المرأة الناجحة بفضل برامج الحكومة، المرأة الصابرة الزينبية، وما عداها فهنّ منحلّات يطالبن بما يضمن دوام انحلالها. إنّ القدرة على بناء المعطيات الفكرية بالإعلان عنها وترسيخها، والقدرة على تغيير الأوضاع الاجتماعية والثقافية عبر التأثير في المعتقدات وتغيير مقاصدها، وبناء تصورات أيديولوجية عن العالم تتوافق مع إرادة الهيمنة، هو العنف الرمزي الجليّ (فياض).
الشبَحية النسوية
بعد إماتة النشاط النسوي بهذا الشكل الوحشي تمّت صناعة الشبح النسوي الذي يهدّد المجتمع، فالحراك النسوي وعلى الرغم من أنه كان ضمن حدود النظام السياسي والقانوني ولم يخرج عنه، تمّت محاربته بكافة الوسائل. حتى أن استخدام مصطلح "الجندر" كان يتمّ في السابق بمعرفة السلطة وحتى من قبل العتبات الدينية الشيعية المقدسة ومراكزها البحثية، إلا أن المصطلحات تحوّلت إلى عدو لدود بمجرد تغيّر أيديولوجية السلطة وعودة "حزب الدعوة الإسلامية" للتأثير (حميد، 2023) وللحكم، والذي يتّبع سياسةً باتت معروفة لنا كعراقيين وهي "خلق وهمٍ مخيف ثم محاربته كبطل منقذ".
تاريخيًا حارب "حزب الدعوة الإسلامية" الحركة الشيوعية في العراق بنفس الطريقة، واصفًا إياها بالكفر والإلحاد (الحيدري، 2012)، وارتبط وجوده وقوته بمحاربة هذه القوة "التي تريد تدمير المجتمع". الشبح هنا مرتبط بتقلّبٍ سياسي واضح، واستعارة للتعنيف الرمزي المستمرّ، ويظهر في مخاوف واتهامات، aوأشكالٍ متخيَّلة للنسوية أكثر مما يتجسد في فعل سياسي جماعي واضح.
هذا الصمت المفعم بالتوتر يدعونا إلى التفكير فيما يمكن أن أسميه بـ"الشبحية النسوية": لحظة يصبح فيها الحراك أشبه بالشبح، يُستحضَر في الخطاب أكثر مما يُرى على الأرض، ويُحمَّل بمعانٍ قد تعكس مخاوف خصومه أكثر مما تعكس إرادة فاعلاته.
مرحلةٌ تمثّل تحدٍّ لقدراتنا على محاولة هضمها والاستفادة منها نقداً وممارسة، وهذا بحدّ ذاته أسلوب لمقاومة الوضع الراهن. فرغم الخيبة والعزلة والتعب والانسحاب، ما زالت النسويات ونسويّتهن شبحاً، كما الشبح عند دريدا: لا يدلّ على عودة الموتى، بل يقدّم دليلاً مجازياً لإثارة أسئلة تتعلق بالعدالة في ظل احتمال عدم وجوده، ويقدّم الطيف رفضاً للسرديات الكبرى لصالح نُسَخٍ مجزّأة منها (رحيم، 2012).
هُنَّ لا يملكن جسداً جماعياً لكن حضورهن يثير القلق، وخطاباتهن تُحارَب، ويُتّهمن بالعمالة حتى بغيابهن وبدون امتلاكهن أدوات الفعل أو القول. صاغت السلطة حضورهن بتغييبهن فصرن حاضرات غائبات، فشكّلت للنسويات تكتيك بقاء دون أن تعي ذلك، شبحاً نِتاج سلسلة من أشكال التحجيم الممتدة من تظاهرات تشرين إلى اللحظة. والسؤال الآن وهنا: كيف نستفيد من هذا التكتيك؟ مسؤوليتنا في ظل هذا السياق الصعب هي العمل على استنطاق هذا الشبح ومعرفة ما يشير إليه. تجنّبت النسويات الظهور والمجاهرة من أجل النجاة، ليكون الحذَر استراتيجية سياسية لابد منها (التقيّة)، حتى امتدّ الحذَر إلى غير النسويات أو المهتمين بالشأن السياسي. ومع أنه تصرّف ناتج عن الخوف والتأقلم معه، إلّا أنه نوعٌ من الحضور، حاضر كشبحٍ سياسي-ثقافي وغائب كتنظيم أو فاعلية.
ورغم المؤشرات القوية على أهمية التنظيم السياسي النسوي، لا تزال معظم النسويات عالقات في إطار المنظمات النسوية بشكلها الحقوقي، وتخلطن بين التنظيم السياسي كاستراتيجية إنقاذ وبين التشبيك العابر للاختلافات الأيديولوجية النسوية. مثال على ذلك "تحالف 188" (المرسومي، 2024)، وهو تحالف تأسس للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية رقم 188، والذي صُمّم على شاكلة تحالف "شبكة النساء العراقيات" سابقاً والذي لم تظهر النسويات فيه كقوةٍ سياسية حقيقية، ولم تتمّ إدارته بشكل أفقي بل وفق حجم التأثير والتمويل، حيث قادت قراراته المنظمات ذات الغالبية العددية والتمويلية وصاحبة العلاقات الواسعة، والتي لم تنجح في مواجهة الحملات المناهضة. كما عبّرت رانيا، كاتبة نسوية كويرية: "ما يحدث هو أقرب لما يحدث للجواميس في الأهوار، تتعرّض للتجفيف، برك ماءٍ قليلة لا تكفي حتى للاستلقاء، ثم الموت ببطء" (المرسومي، 2024).
الغائب هنا لا يمثّل عجزاً فردياً، بل نتيجةً لعنفٍ بنيويٍّ ورمزيٍّ ومحاولات منظّمة لإسكات صوت لا يُحتمل وجوده. وهذا ما يدفعنا لاستيعاب الشلل التنظيمي كحالة سياسية، لا كضعفٍ فرديّ، كمحاولة لإستعادة نسويّتنا من حملات المحو عبر وسائل الإعلام المؤدلجة والمنابر والخطابات القومية والذكورية.
الدلالة التخويفية لمفهوم الشبح في المخيال العراقي توضح شكل الحركة النسوية الآن: الشبح موجود بشكل مجازي، مفتعل من خصومه، غائب لكنه موجود في كلّ مكان أو في اللامكان، ويعاود الظهور بسهولة (رحيم، 2012). إنّ تحويل النسوية إلى شبحٍ مخيفٍ يُعتقَد أنه الضامن لعدم عودتها، وواجب التخلّص من هذا الشبح يقع على النسويات. فالحديث المشيطن لهن يشكّل حالة استدامة لبقاء النسويات ولحثّ رغبة الناس في معرفة الفكر الذي يتبنّينه: "أوج الاختفاء يقضي أن يقدم المرء بالإخفاء وهو ينتج الظهور" (دريدا، 2006). الفتيات والنساء المتأثّرات بهن أو اللواتي يطالبن بمطالب نسوية يُعتبرن "ممسوسات"، حتى التعليق على المنشورات التحريضية يهدد بقاء الحساب الرقمي (مصطفى وعبد، 2024). ثقافة الإلغاء الآن بلا حاجز، والصوت النسوي المرتفع يُنظر إليه تهديدًا للمنظومة الأبوية، ويتوحد المدافعون عنه لإسكاته وتحجيمه وإعادته إلى مكانه المفترض (صالح، 2025).
الخاتمة
إنّ استعادة الحضور السياسي بعد انتفاضة تشرين 2019 بمواجهة القمع المباشر أو الرد على الانتهاكات في ظلّ الظروف الحالية لهو عملٌ انتحاريّ، ممّا يتطلّب منّا حصر أدواتنا وتحفيز الخيال الجماعي لخلق إمكانات جديدة للعمل السياسي والتنظيمي. إنّ القدرة على وصف اللحظة الحالية بحدّ ذاته هو مقاومة، هو محاولة تخيّل إجابة حول سؤال: أين نحن؟ سواء من الحراك الاجتماعي ككلّ أو لتفحص أثر خطواتنا في الحركة ذاتها.
لم تكن انتفاضة تشرين حدثاً عابراً في الحراك النسوي العراقي كانت كطَيّ طرفي ورقة، وضعتنا بالمواجهة مع نقاط ضعفنا ولم تمهلنا سوى فترة بسيطة لفهم تلك النقاط والتعامل معها. لنُعاقَب بعدها بالإخراس الذي سيتحوّل إلى لعنة إذا لم نواجهه هو أيضاً.
وكما قال جاك دريدا "إن الأطياف لتكون هنا دائماً حتى وإن لم تكن موجودة، حتى وإن لم تعُد موجودة، حتى وإن لم تزَلْ غير موجودة وأنها لِتهبنا إعادة التفكير بال(هنا) ما إن نفتح الفم" (2006).
رغم القمع والتغييب، ما زالت النسوية العراقية حاضرة كشبحٍ سياسي وثقافي، وهو ما يفتح المجال لإعادة التفكير في استراتيجيات المستقبل. التحدّي الآن يكمن في بناء أطر تنظيمية مرِنة وقادرة على مواجهة القمع، مع الحفاظ على لغة سياسية واضحة، وتنمية شبكة دعم داخلي وخارجي تضمن استدامة الحضور النسوي ومقاومته للقمع الرمزي والمؤسسي.
ينبغي ألا تقتصر استراتيجيتنا على إعادة تشكيل حراكاتنا أو إحيائها بالقالب نفسه الذي ساهم بالشلل التنظيمي الحالي، بل بلورة أشكال تنظيمية جديدة تركّز على إعادة لمّ الشمل للمناقشة والمراجعة بحرية أكبر وبشكلٍ غير نمطيّ. وإجراء محاولات لاستعادة اللغة في الفترة الانتقالية هذه من خلال إعادة إنتاج المفهوم النسوي في الفضاء الأكاديمي الإقليمي أو العالمي بسبب التضييق عليه عراقياً، والنظر بجدية أكبر لعمل التحالفات وإجراء التشبيكات مع الحراكات الأخرى كتلك المعنية بالفقر أو الفساد أو العمّال أو البيئة لإعادة طرح القضايا النسوية داخلها ومن خلالها، والعمل على تطوير خطابٍ تقاطعيّ محلّي من خلال قراءة واقع النساء بعيداً عن وجهة نظر المانحين سواء كانوا داخليين او خارجيين لإنتاج خطاب من داخل البيئات نفسها يكون معبّراً عنها. والتفكير ببدائل لأرشفة التاريخ النسوي ورقياً ورقمياً لحماية تاريخنا وتجاربنا من المحو والعمل بشكل جماعي لكتابة تاريخ المرحلة الحالية من وجهة نظرنا نحن وبمناهجنا النسوية وحمايته من التلاعب أو المحو.
كلّ ما تقدمّ هو إحياء عِنادنا حتى وإن كان سرّياً وحذراً وسرد قصصنا في ظل التقيّة والتيه بالسبل الآمنة لنكسر الجدران التي شيّدناها بيننا بسبب الخوف، سردها من وجهة نظرنا نحن لنحمي أنفسنا من النسيان، لنكتب تاريخ تشرين النسوي كوجعٍ علّم علينا وعلّمنا لا كانتصار، لحماية ماضينا من التشويه… وحتى لا نظلّ أطيافاً في حاضرنا ومستقبلنا.
- 1. هي تكتيك إسلامي شيعي اتّبعه الشيعة الأوائل في ظل حكّام قامعين وتعني إخفاء المعتقدات أو المواقف لحماية النفس من الخطر والاضطهاد مع الحفاظ على القناعات الداخلية.
- 2. حساب الحملة على فيسبوك الذي يستمدّ منشوراته من قناة التلكرام بشكل أساسي: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095085627278
- 3. جملة باللهجة المحكية العراقية تصبح بالعربية الفصحى: "النسوية هي التمرّد، ابنتك تأتي مع أصدقائها وتقول لك: لا بأس يا أبي الأمر عادي، ثم تلبس وتخرج كما تشاء، واليوم تطلب حق التعليم وغداً ستطلب شيئاً آخر. وإن لم ترغبي في إزالة شعر إبطيك، فهذا أيضاً عادي".
احمد الدباغ. (2022). عام كامل على الانتخابات العراقية.. تعرّف على أهم أحداثه. الجزيرة نت. https://www.aljazeera.net/politics/2022/10/10/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
أسماء جميل رشيد. (2017). التشكلات الجمعوية النسائية في العراق حركة أو نشاط نسوي أو نسائي؟ الجامعة المستنصرية، مجلة كلية التربية، العدد السادس.
الجزيرة نت. (2019). طلاب العراق.. ثورة القمصان البيضاء. الجزيرة نت. https://www.aljazeera.net/gallery/2019/11/4/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
الحزب الشيوعي العمّالي العراقي. (2022). في يوم المرأة العالمي ترفرف الرايات الحمر وتحمل شعارات الحرية والمساواة وسط بغداد. موقع الحزب الشيوعي العمّالي العراقي. https://wp-iraq.com/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
الروابط. (2019). القلق: عنوان الموقف الإيراني من احتجاجات العراق. مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية. https://rawabetcenter.com/archives/98782
الساعة. (2023). إحصائيات 2022.. مستخدمو الإنترنت في العراق. موقع الساعة. https://alssaa.com/post/show/14394-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2022-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
الهام مكي. (2021). تظاهرات اكتوبر نقطة تحول في الحراك النسوي العراقي. الرابطة النسائية الدولية من أجل السلام و الحرية. https://www.wilpf.org/%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81/
أماني الحسن. (2022). النساء في تشرين.. أكنا "راديكاليات" بما يكفي؟ جمار ميديا. https://jummar.media/1699
أمين معلوف. (2015). الهويات القاتلة. ترجمة نهلة بيضون. بيروت: دار الفارابي للنشر.
إنان.م.بلاي. (2024). "بعد ماكو جندر ولا جندرة": حرب الدولة-الميليشيا على "الجندر" في العراق. درج ميديا. https://daraj.media/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
بلسم مصطفى. (2023). "سُعار مُموَّل".. عن رهام يعقوب والحرب على النساء في العراق. جمار ميديا. https://jummar.media/3990
بلسم مصطفى. (2024). قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق. جمار ميديا. https://jummar.media/5050
بلسم مصطفى وريم عبد. (2024). اليمين والمانوسفير العراقيان: وحدة ضد النساء. جمار ميديا. https://jummar.media/4865
بيير بورديو. (1994). العنف الرمزي (المجلد الأول). ترجمة نظير جاهل. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
جاك دريدا. (2006). أطياف ماركس. ترجمة منذر عياشي. حلب: مركز الإنماء الحضاري.
حسام الدين فياض. (بلا تاريخ). العنف الرمزي: فلسفة بيير بورديو. مجلة الجديد. https://www.aljadeedmagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A
حيدر الموسوي. (2023). منصة "بلّغ" العراقية: محاربة "المحتوى الهابط" أو تكميم الأفواه؟ درج ميديا. https://daraj.media/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%91%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84/
خالد هاشم محمد. (2019). احتجاجات العراق 2019: نظرة تحليلية. المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية. https://democraticac.de/?p=64017
رحيم محمود. (2022). السلطة حينما واجهت شباب تشرين: إباحة القتل لإدامة النظام. جمار ميديا. https://jummar.media/1736
زهراء علي. (2018). النسوية في العراق: بين فرض نهج المنظمات غير الحكومية والعنف الطائفي والنضال من أجل دولة مدنية. عمران للعلوم الاجتماعية، مجلّد 7، عدد 25، 7–27. https://omran.dohainstitute.org/en/Issue25/Documents/Omran25-2018-Feminism-in-Iraq-Zahra-Ali.pdf
زهراء علي. (2021). انتفاضة العراق 2019 والخيال النسوي. السفير العربي. https://assafirarabi.com/ar/41600/2021/11/08/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-2019-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A/
زهراء علي. (2023). النساء والجندر في العراق: بين بناء الأمة والتفتت. ترجمة وسن قاسم. بغداد: المركز الأكاديمي للأبحاث.
سارة أحمد. (2010). نسويات قاتلات البهجة (بالإضافة إلى مواضيع قصدية أخرى). ترجمة دانا علاونة. مجموعة اختيار. https://www.ikhtyar.org/writings/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7/
سعد محمد رحيم. (2012). استعادة ماركس. دمشق: دار أفكار للدراسات والنشر.
سكاي نيوز. (2023). العراق.. وقفة احتجاجية نسائية بعد مقتل طيبة العلي. سكاي نيوز عربية. https://www.skynewsarabia.com/varieties/1594500-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8
سناء العلي. (2021). المرأة العراقية... بصمة وتأثير في مختلف الحضارات والأزمنة. Jinha: وكالة أنباء المرأة. https://jinhaagency.com/ar/mlf/almrat-alraqyt-bsmt-wtathyr-fy-mkhtlf-alhdarat-walazmnt-5-23358
ضي مضر أبو غنيم. (2021). الفن والسلام في ساحة التحرير. بغداد: جمعية الأمل العراقية.
عالية عز. (2024). ربطة وعباية وبوشية: حجب نساء الشيعة في العراق. مجلة الفراتس. https://alpheratzmag.com/arguments/20240802601/
عبد الجبار عيسى عبد العال السعيدي. (2020). حتجاجات تشرين في العراق مدركات الاحتجاج في البيئة الشيعية ومآلات الاجتماع. مركز الجزيرة للدراسات، عدد 6. https://lubab.aljazeera.net/article/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA/
علاء كولي. (2020). هل فقدت الأحزاب الشيعية النافذة سطوتها وهيمنتها بجنوب العراق؟ الجزيرة نت. https://www.aljazeera.net/politics/2020/5/26/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9
علي الخطيب. (بلا تاريخ). شعب الخيام، شهادات من واقع احتجاجات تشرين العراقية. أوما لحقوق الإنسان. https://ahewar.org/rate/bindex.asp?yid=18948
فارس كمال نظمي ومازن حاتم. (2022). احتجاجات تشرين 2019 في العراق من منظور المشاركين فيها. بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط.
فتحي المسكيني. (2023). الجندر الحزين. القاهرة: مؤسسة هنداوي. https://www.hindawi.org/books/57319183/
فيروز مجيد. (2024). دكتاتورية وذكورية: التمثيل النسائي في البرلمان العراقي. جمار ميديا. https://jummar.media/6169
كاميلا ستيبو. (2019). دروس من الثورة التشيلية النسوية | تشيلي. مجلة كحل لأبحاث الجسد والجندر، مجلّد 5، عدد 3. https://kohljournal.press/ar/Feminist-Chilean-Revolution
مايا العمّار. (2020). عراقيات "بناتك يا وطن" هتفن: "لا مو عورة صوتج ثورة". درج ميديا. https://daraj.media/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%81%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5/
مريم جلبي. (2023). المنظمات النسوية وأسئلة العمل المؤسساتي. منصّة الجمهوية. https://aljumhuriya.net/ar/2023/08/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3/
منال حميد. (2021). الحركة النسوية في العراق من عام 2003 الى 2019. الحوار المتمدن. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718095
منال حميد. (2023). عن الجندر في العتبات المقدسة ومنظمات المجتمع المدني. مركز مساواة المرأة. https://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=801279
منال حميد. (2025). البحث عن المكان الثالث في الحراك النسوي العراقي. منصّة الجمهورية. https://aljumhuriya.net/ar/2025/09/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
منال حميد. (2025). حين تهدد الأزمات الرجولة: العراق وإعادة إنتاج الخطاب التقليدي. الحوار المتمدن. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=857926
ميسا صالح. (2025). الصورة الغائبة: دولة تُعاد صياغتها بدون النساء. منصّة الجمهورية. https://aljumhuriya.net/ar/2025/04/22/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9/
نبيل الحيدري. (2012). فتوى المرجع الشيعي الحكيم: الشيوعية كفر وإلحاد، وخلفياتها. صحيفة إيلاف. https://elaph.com/Web/opinion/2012/11/771662.html
نهلة نجاح-بغداد. (2020). يتعرضن للتهديد والتشهير.. هكذا تحدت المرأة العراقية الهيمنة الذكورية في معترك السياسة. الجزيرة نت. https://www.aljazeera.net/women/2020/8/24/%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AA
نور المرسومي. (2024). عضوات تحالف 188 تؤكدن أن مشروع تعديل القانون هو كسر لإرادة المرأة. Jinha: وكالة أنباء المرأة. https://jinhaagency.com/ar/alhqwq/dwat-thalf-188-twkdn-an-mshrw-tdyl-alqanwn-hw-ksr-laradt-almrat-44336
هند محمود وشيماء طنطاوي. (2016). دليل نظرة للمبادرات النسوية. القاهرة: مركز نظرة للدراسات النسوية. https://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/-النسوية-النسائية-الشابة.pdf
وزارة الداخلية العراقية. (2023). منصة الكترونية خاصة الإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي. الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية. https://moi.gov.iq/?page=4611
Mohanty, Chandra Talpade. (2006). US Empire and the Project of Women's Studies: Stories of citizenship, complicity and dissent. Gender, Place & Culture, 13(1), 7–20. https://doi.org/10.1080/09663690600571209
Mustafa, Balsam. (2025). Gender found Guilty: Anti-Gender Backlash and (Dis)Translation Politics in Iraq. Gender & Society, 39(4). https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08912432251344267