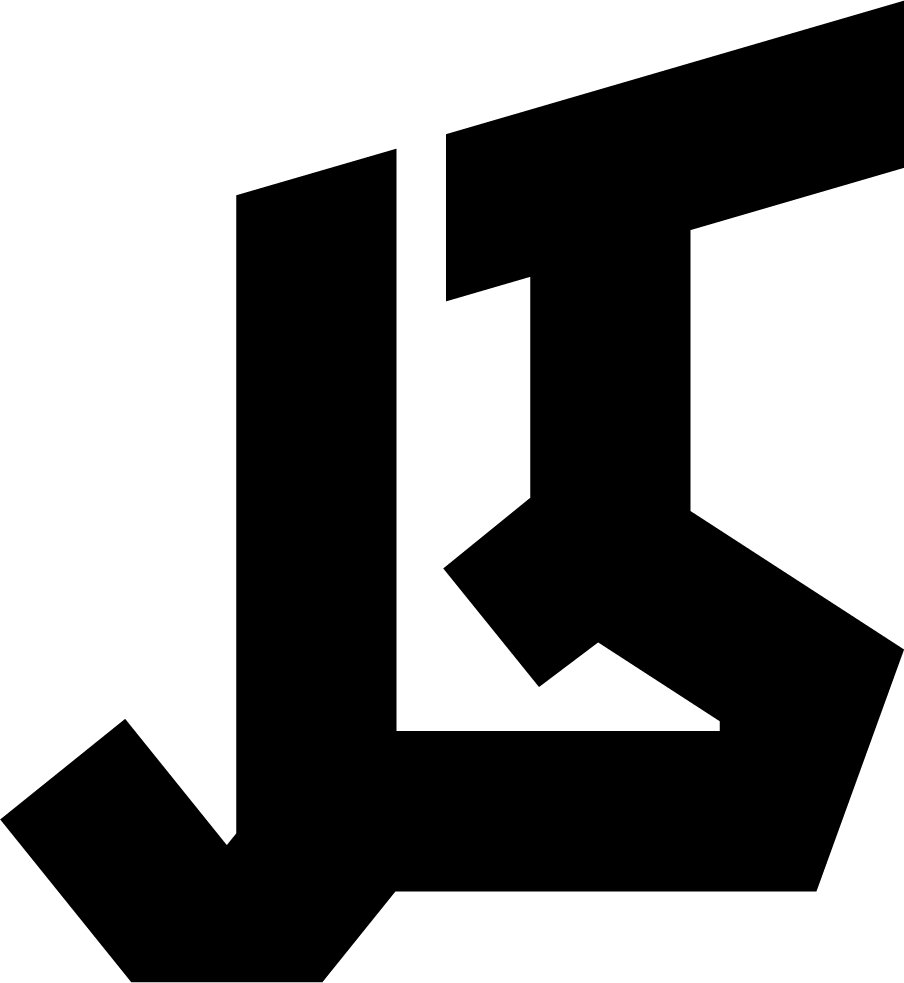إنهيار العمل الإنساني: الكارثة بين المال والممارسة
failure_of_humanitarianism_ar.jpg

ميرا المير
السياق
من المستحيل اختزال حجم العنف العشوائي والجرائم الوحشية التي ارتكبها الكيان الاستيطاني الصهيوني بحقّ أبناء منطقتنا منذ عام 1948، أو الإحاطة الكاملة بأوجه التشابه والاختلاف بين الواقعين الفلسطيني واللبناني تحت وطأة هذا الاحتلال. لقد رُسِمت حدودنا على موائد استعمارية، فساهمت من جهة في تفكيك استمرارية انتمائنا وتمزيق نسيج منطقتنا، ومن جهة أخرى أكّدت سرديةً مشتركة قوامها الخضوع للعنف الاستعماري والإبادي الذي مارسته الامبريالية الغربية.
إن مشاريع الهيمنة والاقتلاع والمحو التي ما يزال الغرب يمارسها، جعلت من المقاومة شرطًا أساسيًا للوجود في منطقتنا، لا مجرد خيار سياسي أو موقف أخلاقي، بل فعل بقاء ورفضٍ للمحو. نتيجةً لاستيعار العدوان الإسرائيلي أواخر عام 2023، بدأت حركات النزوح الجماعي من القرى والبلدات الجنوبية في لبنان، بالتوازي مع تصاعد الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية. وفي أيلول/سبتمبر 2024، اتّسع نطاق العدوان بشكل كبير، مما أدّى إلى تزايد موجات النزوح من الجنوب متجاوزة البلدات الحدودية.
في 17 و18 أيلول/سبتمبر، شهد لبنان هجومين واسعين باستخدام أجهزة النداء (البيجر) وأجهزة اللاسلكي، أثارا الرعب في مختلف أنحاء البلاد. أدّت هذه الهجمات إلى مقتل وإصابة وفقدان أطراف وأعين ما لا يقل عن 3400 شخص1 من شرائح سكانية مختلفة، بينهم أطفال. وفي 20 أيلول/سبتمبر، استهدف العدوان الصهيوني الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق مركزية من المدينة، ما أدّى إلى موجة نزوح ضخمة أرغمت الآلاف على مغادرة بيروت وضواحيها خلال ليلة واحدة فقط (23 أيلول/سبتمبر). وقد سُمّيت هذه المرحلة من العدوان بـ"عملية سهام الشمال"، واعتُبرت أعنف هجوم على لبنان،2 إذ أدّت إلى نزوح ما بين 90 و94 ألف شخص في يوم واحد نتيجة تنفيذ 1600 غارة جوية.
بحلول 25 أيلول/سبتمبر، قُدّر3 عدد النازحين في مختلف أنحاء البلاد بنحو 600 ألف شخص، جاء معظمهم من الضاحية الجنوبية، والجنوب، والبقاع. كانت هذه المناطق الهدف الرئيسي (لكن غير الوحيد) لحملات القصف العنيف والمستمر، واستخدام الأسلحة الكيميائية، في محاولة ممنهجة لجعل الأراضي غير صالحة للسكن أو للعودة إليها.
بين الاجتياح البرّي المعلن في الأول من تشرين الأول/أكتوبر والهدنة المزعومة في السابع والعشرين من الشهر نفسه، بلغت موجات العنف ذروتها، وترافقت مع حالة من الإفلات من العقاب والتقاعس التام للدولة اللبنانية – التي فشلت في إعلان حالة الطوارئ أو تأمين المأوى والمساعدات الأساسية للمتضررين. ابتداءً من 17 تشرين الأول/أكتوبر، بدأ الناس بأخذ المبادرة بأنفسهم، فاجتمعوا وحاولوا تنظيم جهودهم في مجموعات مؤقتة تشكّلت عبر "واتساب"، والتقت في مساحات مجتمعية بديلة خارج سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية القائمة. ضمّت هذه المبادرات أفرادًا من مختلف الأعمار والانتماءات السياسية: أشخاصًا مستقلين، مجموعات غير رسمية، مجموعات من العاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية، ولاجئين سوريين وفلسطينيين. بعضهم فتح بيته لاستقبال النازحين، وآخرون تولّوا تنظيم اللوجستيات وتأمين الاحتياجات الأساسية وتقاسم ما يملكونه. كثيرون منهم كانوا نازحين أنفسهم، حاولوا التخفيف عن نظرائهم. لم تكن هذه المبادرات مدفوعةً بأجندات مؤسساتية أو لغة العمل الإنساني الرسمية، بل بالضرورة والتضامن ورفض انتظار المؤسسات التي كانت قد تخلّت عنهم منذ البداية. ومع ذلك، ورغم كل الجهود المجتمعية والأموال التي جُمعت، ظلّت عشرات العائلات تعيش على الشاطئ في العراء وسط تدهور الأحوال الجوية. أما الجهات الحكومية المكلّفة بالتعامل مع الكوارث، فلم تتخذ أي خطوات عملية لأسابيع بعد ذلك. وفي تلك الأثناء، كانت المشاهد في وسط بيروت وحدها أشبه بنهاية العالم.
نزح آلاف الأشخاص أكثر من مرّة، فيما لم يتمكّن عدد مماثل من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وفي الوقت نفسه، اتّسعت الفجوة بشكل كبير بين ما استطاع الناس تأمينه من مساعدات محدودة والعدد المتزايد من النازحين واحتياجاتهم المتنامية، ما جعل تلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش تحدّيًا يوميًا يتجاوز قدرة المبادرات الفردية والمجتمعية.
لم تكن هذه الفجوة أو حالة التفاوت جديدة، بل كانت امتدادًا لحالة مستمرة من التمييز العنصري. فخلال انتفاضة عام 2019، تُركت العاملات المهاجرات من قبل كفلائهن وتُركن للنوم في الشوارع. وبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، تكرّر المشهد نفسه، إذ قام أرباب العمل والكفلاء مجددًا "بالتخلّي" عن العاملات المنزليات، تاركين إياهن بلا مأوى في قلب الكارثة. لقد شكّلت تلك اللحظات سابقة لما أصبح نمطًا متكرّرًا، حيث يُعاد إنتاج العنف البنيوي نفسه في كلّ أزمة. لم يكن تصعيد عام 2024 استثناءً من ذلك، بل كان تجسيدًا متفاقمًا لمنطق الإهمال والتخلّي المستمر.
التداعيات
من أكثر الصور التي علقت في ذهني خلال ذروة الحرب كانت مشاهد الآلاف من الناس – عائلات، أفراد، ومعارف من مختلف الأعمار – وهم ينصبون خيماً مؤقتة مصنوعة من أغطية نايلون على طول الطريق البحري في رأس بيروت، وعلى امتداد الساحل، بل وحتى في المساحات الفاصلة بين مسربين للسيارات، بينما كانت المركبات تمرّ من الجهتين. أتذكّر المسنّين وهم ينامون مباشرة على أسفلت الكورنيش وإسمنته، بلا أي غطاء يحميهم من قسوة الأرض أو الليل. أتذكّر كيف داهمت قوى الأمن الداخلي تلك المناطق، وأجبرت الناس على إزالة خيامهم ومغادرة المكان. وأتذكّر حادثة "حمرا ستار" حين تمّ طرد مئات الأشخاص بالقوة من فندق مهجور في غرب بيروت، وأُلقي بهم في الشوارع، بناءً على طلب مالك المبنى.
في أحياء بيروت الشرقية، كانت العائلات الشيعية النازحة تُواجه رفضًا متكررًا للحصول على مأوى. جرى صدّهم أو التمييز ضدّهم بدافع من التحريض الطائفي والتحيّز الطبقي ورُهاب الآخر. أما الذين تمكنوا من دفع الإيجار، فوجدوا أنفسهم أمام أسعار خيالية، إذ مع ازدياد الحاجة إلى المأوى والسلع الأساسية، قام المالكون والمضاربون باحتكار السوق، مستغلّين يأس النازحين وعجزهم عن إيجاد بدائل. لقد فاقم هذا التمييز الطبقي والطائفي من عنف النزوح نفسه – إذ أُرهبوا خارج بيوتهم أولاً، ثم أُرهبوا هيكليًا من إمكانية السكن مجددًا في عاصمتهم.
وُثّقت أيضًا حالات من العنف الجسدي والتنمّر ضد النازحين. كان هناك أهالي يتوسلون للحصول على حليبٍ للأطفال الرضع، ومسنّون يتجولون في الشوارع ليلاً بلا فرش أو وسادة للنوم – لم تكن هذه المشاهد مجرد معاناة عرضية، بل كانت دليلًا على الإهمال المنهجي، والعنف البنيوي/عنف الدولة.
إضافةً إلى كل هذه الوقائع البشعة: بينما كان النازحون اللبنانيون محرومين من الموارد والدعم الكافي، كان العمّال والعمالة المهاجرة من الطبقة العاملة يُعانون إهمالًا شديدًا وتهميشًا كاملًا، بل وتمّ استبعادهم من أبسط أشكال الدعم التي كانت المبادرات المجتمعية قادرة على توفيرها.
تُركت العاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية للنوم تحت الجسور بعدما فرّ كفلاؤهن وتركوهنّ كأنهنّ ممتلكات مُهمَلة. رفضت الملاجئ الحكومية والخاصة استقبال أفقر الفقراء من بين المهاجرين، السوريين، والفلسطينيين. كما أن المباني الخاصة أو المهجورة التي كانت أحيانًا توفّر مأوى للعائلات اللبنانية، لم تستقبل اللاجئين أو العاملات المهاجرات. تفاقمت العنصرية البنيوية والتمييز الطبقي المتجذّر في نظام الكفالة خلال أوقات الأزمة، مما جعل أجساد المهاجرين قابلة للتصرّف والتجاهل. وهذا يعكس ظاهرة "التخلّص الجماعي" التي صعدت أثناء انتفاضة 2019 وما تلاها من انفجار مرفأ 2020. ولم تسهم الحرب سوى في تكبير حجم هذا العنف البنيوي المستمر.
في غياب الدولة، حاول الناس التنظيم بكل الوسائل المتاحة. تجمّعت العائلات والمعارف لتوحيد الموارد، وظهرت مطابخ مجتمعية لتأمين الطعام. تم تنظيم وسائل نقل مؤقتة لإخراج الناس من المناطق الملتهبة. جُمعت ووُزّعت الفرش وحليب الأطفال والطعام واللوازم الطبية الأساسية. أصبحت مجموعات "واتساب" بمثابة شريان حياة للتنسيق. لم تكن هذه الاستجابات شاملة، بل كانت استراتيجيات بقاء مجزأة بالكاد تخدش سطح الاحتياجات المتصاعدة.
كالعادة، تدخّلت المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسية (iNGOs) وفق منطقها المعتاد في توزيع فتات من ميزانياتها – غالبًا أقلّ ممّا تنفقه على موظفيها البيروقراطيين، وحملات الدعاية والتمجيد الذاتي التي لا تهدف إلا إلى تبرير وجودها وإنفاقها. تظلّ هذه المؤسسات منفصلة تمامًا عن الاحتياجات الحقيقية للناس الذين تدّعي خدمتهم، بينما تعتمد أدنى مستويات أدائها على موارد ضخمة بلا أي أفق للاستدامة. مدفوعة بجماليات العمل الإنساني، تقيس تقاريرهم اللامعة فعلهم الإغاثي بالأرقام: الطرود الموزّعة، نسب الأسر التي تم الوصول إليها، المحافظات المشمولة. كانوا يحصون الأرقام، لكن لم يستطيعوا استيعاب حجم الواقع الكامل والمعاناة الحقيقية.
تدفّق الأموال
بدأت المجموعات القاعدية الصغيرة، وخاصة ذات الخطاب السياسي الواضح، تفقد تمويلها مع صعود اليمين المتطرف الأوروبي، فيما كانت الأجندات الإنسانية والتنموية تتخذ أشكالًا جديدة. وكان الغزو الروسي لأوكرانيا نقطة محورية في كيفية توزيع الأموال: بحلول نيسان/أبريل 2022، أُعيدت هيكلة استراتيجيات التمويل الأوروبية لتفضيل التمويل الطارئ داخل أوروبا نفسها، مع توجيه موارد ضخمة لدعم نظرائهم من المواطنين الأوروبيين. تسرّب هذا التحوّل إلى كامل جهاز العمل الإنساني والتنموي، كاشفًا مرة أخرى كيف أن المساعدات تتبع التسلسلات العرقية والأولويات الجيوسياسية للغرب. لقد تحوّلت "عقدة المنقذ الأبيض": لم تعد تنقذ الجنوب العالمي، بل أصبحت تنقذ البياض من الداخل، مما جعل منطقة SWANA (غرب آسيا وشمال أفريقيا) تزداد تهميشًا بعيدة عن سلم الاولويات التمويلية خطة الانقاذ الاوروبية.
رسخت سياسة إعادة التوجيه المالية في سياق تداعيات "طوفان الأقصى". ما بدأ كإعادة توجيه هيكلية للمساعدات الأوروبية والغربية تحوّل إلى انهيارٍ كاملٍ في الدعم للمنظمات ذات الخطاب السياسي الصريح في المنطقة. كانت الضربة لقطاع المنظمات غير الحكومية، الذي يعتمد عليه الاقتصاد اللبناني بشكل كبير منذ عام 2011، فورية ومدمّرة، لا سيما بالنظر إلى اعتماد الدولة بكليّتها على التمويل الخارجي بشكل عام.
تمّ تخصيص الحصّة المتبقّية الضئيلة من التمويل للمجموعات ذات الخطاب الفضفاض والغامض. لم يتبقَّ أي مجال للمنظمات المناهضة للاستعمار والإمبريالية. وبطبيعة الحال، أدّى انخفاض الموارد لهذه المجموعات إلى محدودية قدرتها على المشاركة في جهود الإغاثة المجتمعية خاصة بعد امتداد أتون الحرب الاستعمارية إلى لبنان.
إلى جانب مبادرات الإغاثة المجتمعية، نُظِّمت عدّة حملات لجمع التبرعات، أطلق العديد منها لبنانيون مغتربون ومهاجرون. ومنذ اندلاع الأزمة المصرفية في عام 2019، التي فقد خلالها معظم المودعين أموالهم لدى المصارف الخاصة، تفاقمت الأزمة الاقتصادية الحادّة مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90% مقابل الدولار الأميركي. أدّى ذلك إلى تعقيد المعاملات المالية داخل البلاد وخارجها، وإلى مزيد من تآكل الثقة في النظام المصرفي. عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أفضت تصنيفات عدد من الدول الغربية للبنان – دولةً وشعبًا – باعتباره "متعاونًا مع حزب الله وحماس" إلى تشديد القيود على التحويلات المالية والمساعدات القادمة من حملات الدعم والمغتربين. وقد انعكست هذه السياسات على عرقلة تدفّق الموارد الإنسانية والاقتصادية نحو الداخل اللبناني، تحت ذرائع تتصل بمخاوف من تمويل جماعات مُدرَجة على لوائح الإرهاب الغربية، ما ساهم في تعميق الأزمة المالية وتوسيع فجوة العزلة المصرفية التي يعيشها البلد. في السياق نفسه، فاقم العدوان الإسرائيلي الأخير من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي، إذ أدّت الإجراءات المصرفية الاحترازية والقيود المفروضة بذريعة "الخشية من تمويل جماعات مرتبطة بحزب الله" إلى إبطاء حركة التحويلات الخارجية وتعطيل قنوات الدعم الإنساني.
في قطاع غزة، تحوّل الحصار الطويل إلى مجاعة شاملة في ظلّ الإبادة الجماعية الجارية، كاشفًا هشاشة منظومة العمل الإنساني وأوجه الخلل في إدارة المساعدات. فقد رافقت عمليات توزيع الإغاثة سلسلة من الانتهاكات والفضائح، ما أظهر التداخل العميق بين المساعدات الإنسانية والأجندات السياسية والأمنية للجهات المانحة. وفي هذا السياق، برزت نماذج مثل "صندوق غزة الإنساني" (Gaza Humanitarian Fund)، وهي منظمة أميركية غير ربحية تعمل تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، كمثال على ما يُعرف بـ"تسليح المساعدات". إذ تحوّلت بعض مراكز التوزيع إلى مواقع خطرة جذبت الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء نحو مناطق الاستهداف، ما أسفر عن سقوط شهداء برصاص القناصة أو نتيجة التدافع والفوضى أثناء محاولات الحصول على المساعدات. أما الناجون من هذه الوقائع، فكثيرًا ما وجدوا أنفسهم أمام مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، وهو ما زاد من معاناتهم اليومية.
عرفت هذه الأحداث لاحقًا باسم "مجازر الطحين"، إذ جرى استدراج السكان الجياع المحاصرين نحو الموت عبر الأجهزة والمنصات نفسها التي يُفترض أنها توفّر لهم المساعدة الإنسانية. تكشف هذه المفارقة المأساوية عن الوجه الحقيقي لما يُسمّى "المساعدات المحايدة": فهي ليست شريان حياة، بل أداة لاستمرار الحصار والإبادة بطرق غير مباشرة، مضمخة بالسلطة والسيطرة. وبصياغةٍ أعمق، يظهر أن نظام المساعدات ذاته بما يشمله من أطر وإدارة وأجندات، غالبًا ما يُعاد تصميمه ليضمن إدامة أعمال الإبادة والتطهير العرقي بشكل منهجي، مع إبقاء الضحايا في دائرة الاعتماد على هذا النظام الذي يفترض أن ينقذ حياتهم.
بينما تعرّضت جهات توزيع المساعدات "الرسمية" في غزة لتجريدٍ كامل من التمويل وفقدان المشروعية – كما حدث مع وكالة "الأونروا" – اتسمت الاستجابة في لبنان بسلوك مختلف. فقد ابتعد معظم الممولين عن الاعتراف بالحقائق السياسية المترتبة على الأزمة، وقطعوا العقود القائمة مع الجهات المستفيدة من دعمهم. وعلى الرغم من ذلك، عبّر عدد محدود من المموّلين عن ما يمكن وصفه بـ"تضامن سلبي"، مؤكّدين في الوقت ذاته عدم قدرتهم على توفير التمويل بصفتهم مؤسسات داعمة، وهو ما يعكس محدودية دور هذه الجهات في مواجهة الانتهاكات السياسية والاقتصادية المتشابكة مع الأزمة الإنسانية، ويبرز الفجوة بين المبادئ الإنسانية والإكراهات السياسية والمالية.
لقد تجاوزنا مرحلة توقّع المساءلة أو محاولة تعريف العدالة ضمن الأطر التي يفرضها الخطاب الاستعماري. نحن اليوم أبعد ما نكون عن الوهم، وقد فقدنا الإيمان نهائيًا بما يُسمّى "حال العالم" وبمسار العمل الإنساني كما يُمارَس فعليًا. لقد وجدنا أنفسنا، نحن في الجنوب العالمي، في عزلةٍ ووحشةٍ لغوية فرضتها علينا منظومات القوة، إذ أُجبرنا على استخدام لغةٍ تُقصينا وتُعيد إنتاج تبعيتنا في كل مفردة. ومع مرور الوقت، أصبح إدراك عبثية الاعتماد على التمويل الأجنبي أمرًا لا لبس فيه؛ فذلك النظام لا يبقينا إلا بالقدر الذي يضمن استمرار خضوعنا، في الوقت الذي يقيد فيه قدرتنا على تخيّل بدائل حقيقية لأنماط العيش والتنظيم السائدة. لذلك، نعود اليوم إلى ما تبقّى لنا من رأس مالٍ راسخ: مجتمعاتنا، وأهلنا، وناسنا. ورغم اختلاف خلفياتنا وأيديولوجياتنا، فإننا نواجه تهديدًا وجوديًا واحدًا – تهديدًا يسبق الإمبريالية ذاتها، وقد حوّل جغرافيتنا إلى دولٍ وحدودٍ مصطنعة، وبلغ من الجرأة أن بات يُعلن صراحةً عن التهجير القسري والإبادة الجماعية الشاملة.
خطّنا التدخّلي
بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، انضممنا في مجلة "كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر" إلى صفوف عدد من المجموعات المتقاربة في الرؤية، بإعلان إضرابٍ مفتوحٍ تضامنًا وتنظيمًا مع الحركات العمالية والشعبية المناهضة للإبادة الجماعية. قمنا بتعليق عملنا حتى كانون الثاني/يناير 2024، وقد ترتّب على ذلك، كما كان متوقعًا، فقدان ما يقارب ثلثي التمويل الذي كنا نعتمد عليه.
كانت مسألة التمويل – الاعتماد على الأموال الغربية، والبنية المؤسسية للمنظمات غير الحكومية، والفجوة الشاسعة بين وعود وواقع الجمود – عبئًا ثقيلًا على كاهلنا. حاولنا جمع عدد من المجموعات ضمن ما أسميناه مبادرة "رفض"، مساحة للنقاش والتفكير الجماعي في بدائل ممكنة. كنا نأمل أن نتمكّن يومًا ما من ابتكار نظام تمويلي مختلف، يقلّ اعتماده تدريجيًا على البنى القائمة، ويعمل وفق آلية دائرية وتبادلية بين مجموعات متعددة، دون أن يشترط مَن يسعى إلى التمويل أن يتخذ شكل المنظمات غير الحكومية التقليدي، وأن يكون قادرًا على الاستمرار بعيد المدى. لكن، كما حدث مع جهود مجموعات أخرى، كانت محاولاتنا متناثرة، ولم تُثمر نتائج ملموسة. فالزمن القاسي، والاستنزاف العميق الذي كنا نعيشه، جعلا من فكرة جمع التمويل للمجموعات نفسها أمرًا ثانويًا، بل شبه بلا جدوى أمام حجم التحدّيات التي كنا نواجهها.
ماذا يعني أن نكون كتّابًا وباحثين وعلماء اجتماع في أوقات تُمارَس فيها الإبادة الجماعية، إبادة فعلية، على بعد مئة كيلومتر فقط؟ ماذا يعني أن نفكك لغة الاستعمار من وراء لوحات المفاتيح، بينما تستمر هذه اللغة نفسها في سحق أجساد شعبنا فعليًا بدباباتها؟ تسلّل شعور العجز – بعيدًا عن الكليشيهات التي يختزنها المصطلح، وعن الإحساس الجمعي الذي نتقاسمه حاليًا مع ملايين البشر حول العالم – إلى أجهزتنا الإلكترونية، اجتماعًا بعد اجتماع، ومراسلة بعد مراسلة.
مع فريقنا المتواضع المكوَّن من خمسة أشخاص، الموزّعين بين المنطقة وأوروبا، كنّا نمدّ مواردنا إلى أقصى حدودها. حاولنا الاستمرار بما نملك، ضمن الأطر التي أسسناها. واصلنا دعواتنا للمساهمة في عددنا حول الواقع الفلسطيني، على أمل أن تفتح هذه الجهود مساحة لخطاب فلسطيني يقوده الفلسطينيون أنفسهم، حتى وإن بقي محصورًا داخل شاشاتنا وعوالمنا الافتراضية.
مع تصاعد جميع أشكال العنف ضدّ شعبنا، أصبحت لغة التضامن بحدّ ذاتها مثيرة للغضب. لم يأتِ تصعيد الإبادة الإسرائيلية في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024 كمفاجأة، وتمامًا كما فعل الشعب في لبنان وخارجه، استخدم أعضاء فريقنا الخمسة شبكاتهم وجهودهم، سواء عن بُعد أو على الأرض، لتأمين الأموال والمواد الأساسية اللازمة لإعانة النازحين والمتضررين.
في ذلك الوقت، كان اتصالنا بمعظم الممولين محدودًا. ومع ذلك، برزت إحدى الصناديق النسوية، "ماما كاش" (Mama Cash)، بوعي خاص لظروفنا وظروف مجتمعاتنا. فقد تواصلوا معنا مرارًا، وقدموا الدعم لأعضاء فريقنا في لبنان، ولدعم جهود الإغاثة. شرعنا في دراسة المجموعات التي تتخذ إجراءات عملية، ورصد عدم التوازن في توزيع الدعم بين المجتمعات النازحة، بهدف فهم أين يمكن توجيه هذا الدعم بشكل أكثر فاعلية.
لم نرغب في إعادة إنتاج نموذج الإغاثة الإنسانية المؤسسي، ولم نحوّل الأموال إلى مواد استهلاكية فورية. سعينا بدلًا عن ذلك لتعبئة قدراتنا الفردية والمؤسسية لتحدّي الانفصال البنيوي بين النازحين واللاجئين والعمّال المهاجرين، أولئك المهملين في بلد قائم على استغلالهم. رأينا دورنا كوسيط؛ استخدمنا شبكاتنا لتفكيك مركزية المساعدات وربط الموارد بمن هم في أمس الحاجة إليها، مع ترك حرية استخدامها لتقديرهم، بما يوازن بين الدعم وإمكان الفعل الذاتي.
تماشى جمع التبرعات مع سياساتنا الرافضة لمنطق التمويل التقليدي لقد أعطى ذلك معنىً عمليًا للتمكين؛ فبالرغم من توضيحنا الخطط الأولية للمجموعات حول كيفية استخدام الأموال، فإن اقتراحنا للمموّل وتقاريرنا اللاحقة أكدت على أن للمجموعات إدارة حرّة للأموال، مع حدٍّ أدنى من تدخلنا في طريقة استخدامها. لحسن الحظ، أدرك المموّل بسرعة تطوّر الوضع، وأهمية عدم التدخل بعد تخصيص الأموال، وضرورة تجاوز البنى المؤسسية، لضمان فعالية الدعم وعمقه البنيوي.
المجموعتان الإفريقيتان القاعديتان للعاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية، اللتان جمعنا لهما التبرعات، شاركتا الهدف نفسه في دعم مطابخ مجتمعاتهن: كل مجموعة كانت تجمع المهاجرين لاستخدام المساحات المتاحة لطهي وجبات للنازحين بلا مأوى. إلى جانب صعوبة الوصول إلى المطابخ والأدوات اللازمة، كانت هذه المجموعات تموّل أعمالها من خلال أعضائها أنفسهم، الذين كانت دخولهم محدودة أو شبه معدومة منذ البداية. وكانت الوجبات التي يوفرونها تُوزَّع على النازحين الذين بلا مأوى، (أغلبهم تُركوا أو تمّ التخلي عنهم من قبل أصحاب العمل). ساعدناهم في استقصاء احتياجاتهم، تقدير التكاليف، وتحديد كيفية استخدام التمويل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مع الحفاظ على قدرة المجموعات على إدارة الموارد بحرية واستقلالية.
مع صعوبة استخدام العاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية للنظام المصرفي المتهتك أصلاً، اقتصر دورنا على تسليم الأموال نقدًا وتوثيق العملية. استمرت المجموعتان في إدارة الموارد بحرّية، وتكيّفتا مع الاحتياجات المتغيّرة بعد الهدنة، بما في ذلك تغطية تكاليف التنقل لأعضائها والدعم المباشر لمجتمعاتهم.
للأسف، لم نتمكّن من إشراك أي ممولين آخرين في هذه العملية كما كنا نأمل، رغم أن ذلك كان من الممكن أن يكون مفيدًا في دعم فئات مجتمعية أخرى.
الدروس
أدركنا مرة أخرى غياب أي خطة للعمل خلال الأزمات؛ وعندما تحلّ بنا مجددًا – وهذا أمر محتوم – قد لا تكون هناك رؤية تسعفنا. نحن ندرك حدود لغتنا وأدواتنا أمام أنظمة نحاول النجاة ضمنها يوميًا، أنظمة تواصل إدامة الخطاب الاستعماري. خيبة أملنا وطمس سردياتنا تضعنا في دوامة مظلمة، نعترف فيها بالخسائر الحالية لنتهيّأ للخسائر القادمة.
بعد أكثر من عام، لا يزال لبنان يتعرّض للقصف، لم يتوقف النزوح والكثيرون عاجزين عن العودة إلى منازلهم، فيما لم تطوّر الدولة أي خطط للاستجابة للكوارث. ما تزال غزة ترزح تحت وطأة الإبادة الجماعية، مما يوضح أن معاناة المنطقة والتخلي عنها هما سمة الحاضر. يبدو وكأن العالم، وسخرية القدر، وقادة الجنوب العالمي، قد باعونا للعدو، بينما يَعِد الغرب بالازدهار الاقتصادي مقابل المزيد من التنازلات ونزع السلاح. تتواطأ الولايات المتحدة مع إسرائيل لبناء ما وصفه ترامب بـ "منطقة عازلة اقتصادية" في جنوب لبنان، واعداً بالأمن والازدهار على شكل منتجعات وكيانات شركاتية. ومن خلال أطر السوق الحرة، تعرض القوى الاستعمارية مرة أخرى تقنيات "ثورية" عبر هياكل مثل Starlink، بينما تجني الطبقة الحاكمة المحلية دون خجل ما يُعرض عليها. وفي الوقت نفسه، يحاول الناس المضي قدمًا باللجوء إلى الروتين اليومي والنضال من أجل النجاة تحت ظل الرأسمالية. يبدو المستقبل أكثر قتامة من أي وقت مضى، وكما هو الحال دائمًا، يُترك المنسيون في ظلال المشاهد.
في مواجهة هذا اليأس، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن كلمات التضامن وحدها لا تكفي للحفاظ على الحياة. فالإعلانات والحملات والتصريحات التي تتداول دون تحريك الموارد تبقى ضمن لغة الرعاية الرمزية، بينما تواجه المجتمعات الإبادة بلا دعم مادي. لذلك، تصبح مسألة التمويل محورًا أساسيًا: ليس التمويل وفق منطق المانحين أو أطر المنظمات غير الحكومية، بل تداول الموارد التي تصل مباشرة إلى من يحتاجها، وتمكّنهم من العمل بشروطهم الخاصة. إن رفض أطر المنظمات غير الحكومية يعني رفض بيروقراطيتها وهوسها بالمساءلة أمام المؤسسات والدول الإمبريالية بدلًا من الناس. ويعني أيضًا الاعتراف بأن الدعم الفعّال لا يُقاس بالتقارير أو النسب المئوية، بل بالأرواح التي تُحفظ والمجتمعات التي تُستدام.
تتطلب هذه اللحظة مواجهة التعب ما بعد الحرب – ذلك التعب الذي يخدر الناس حتى ينسوا، ويقنعهم بأن البقاء الفردي تحت ظل الرأسمالية هو الخيار الوحيد. هذا التعب هو بالضبط ما يسمح للعدو بالتمدد، بينما نغرق نحن في اليأس. لتجاوزه، يجب أن نؤسس أشكالًا من العلاقات والممارسة العملية قادرة على الصمود أمام دوامات الدمار. وإلا، فإن إرهاقنا سيُستغل كسلاح ضدنا، وستنهار إمكانيات المقاومة نفسها تحت وطأة التناسي.
لتجاوز هذا التعب، لا بد أيضًا من تجاوز حدود جمع التبرعات التقليدي، وخصوصًا الاعتماد على المانحين الغربيين الذين يستخدمون الموارد كأدوات استعمارية للصمت والسيطرة. لقد كشفت هذه الحرب مرة أخرى أن بقاءنا لا يمكن أن يعتمد على أموال غربية تتبخر بمجرد أن نصرح بمواقفنا، ولا على هياكل "المنظمات غير الحكومية" التي تفرّق قدراتنا في مشاريع وتقارير. ما يجب أن نسعى إليه بدلًا من ذلك هو أشكال دائرية من التمويل، متجذرة في مجتمعاتنا وتضامناتنا، تحافظ على الاستقلالية وتتيح العمل في أوقات الأزمة. ليس هذا النهج نظامًا مكتملًا بعد، لكنه يزرع بذوره كلما تجاوزنا البيروقراطية ووصلت الأموال مباشرة إلى شعوب الأرض.
ما نسعى إليه الآن ليس إجابة نهائية، بل مساحة لتفكيك هياكل الأزمات، وتحليل الدمار، أساطيره، قوته الناعمة، ورفض حتمية هذا الواقع جماعيًا. لا يوجد هنا وعد بمستقبل محدّد، بل إصرار على أن العلاقات الأخرى ما زالت ممكنة – من خلال التعليم المستمر والدائم، ومن خلال الحوار الذي لا يستنزف بل يحوّل، ومن خلال أشكال الدعم التي تقاوم النفعية الرأسمالية الكائنة في آلة العمل الإنساني. ربما ما نحتاجه الآن ليس مخططًا جاهزًا، بل عتبة، مساحة يمكن من خلالها أن تدخل الإمكانيات التي كانت تُعدّ سابقًا غير قابلة للتصوّر، أو فاحشة، أو مستحيلة الى صدارة المشهد.
نخطو نحو تلك العتبة ليس باليقين، بل بالتردّد وبالرفض. نجمع كل ما يقاوم تماسكنا، لا لنصلحه ولا لنتشبّث به، بل لنفتح له المجال كي ينطق بتناقضه، حتى ولو بلغنا بلغة مكسورة أو جزئية. والأهم أن نلتزم بالاستماع معًا، دون أن نفرض عليه معنىً مسبقًا.
- 1. في 17 أيلول/سبتمبر 2800 وفي 18 أيلول/سبتمبر 608 https://www.hrw.org/news/2024/09/18/lebanon-exploding-pagers-harmed-hezb... https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-establish-international-inv...
- 2. https://www.newarab.com/news/what-israels-arrows-north-operation-lebanon
- 3. https://reliefweb.int/map/lebanon/lebanon-regional-displacement-overview...