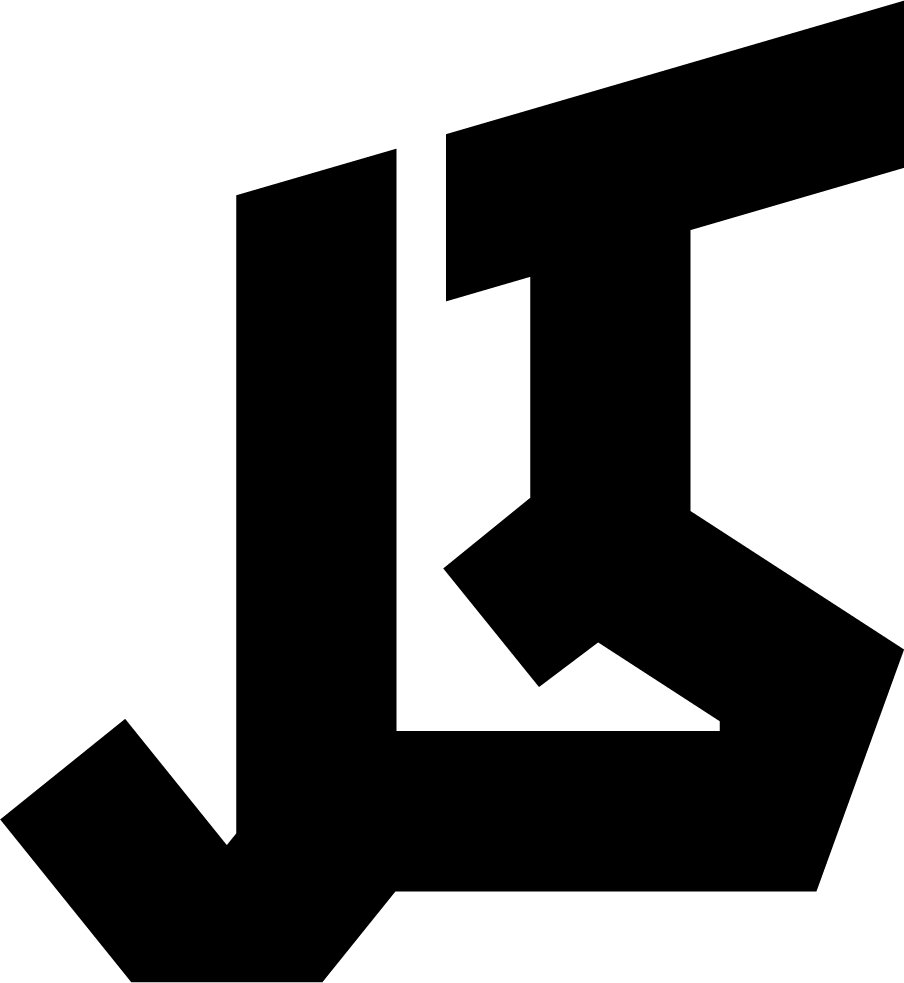لا مساومة تحت نير الإبادة
no_compromise_ar.jpg

ميرا المير
انبثقت فكرة هذا الملفّ الخاص قبل أشهرٍ قليلة من اشتداد الإبادة الجماعية في غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما زالت فصولها مستمرّة حتى اليوم. في البداية، كنّا نرغب في تسليط الضوء على أشكال قمع وتجريم الحركات النسوية الكويريّة في لبنان والمنطقة من قبل أنظمة الحكم البوليسية والسجنية، والمنتظمات المصرفية، وبيئات العمل الرأسمالية، كل هذا مضافٌ إلى إرهاصات الاحتلال الاستعماري.
يصدر هذا الملفّ الخاص بعد عامين من الموعد الذي كان مُقرَّراً له، ليكون نذيراً لحروب إفناءٍ غير مسبوقة. تستمرّ هذه الإبادة ويُسمَح لها بأن تتواصل دون رادع أو مساءلة، فيما يُواجَه من يجرؤ على رفضها بالتهديد بفقدان لقمة العيش، أو السجن، أو النفي. ليس كلّ ذلك إلا إثبات لحقيقةٍ كونيّة لم يَعُد في مقدورنا غضّ الطرف عنها: إن رفض الاستعمار في عالم اليوم، بات هو الجريمة الكبرى، سواء تَجسَّد في صورةٍ كويريّة أم اتّخذ وجهاً آخر. حتى في نطاق "كحل"، هذه المنصّة الكويريّة الراديكاليّة المتخصّصة، لم نسلَم من العقاب. فقد امتنعت جهات تمويل عدّة عن تجديد عقود المِنَح ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2024، أي أنّها ببساطة سحبت دعمها. ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية، كان لفقدان هذا الجزء الكبير من الموارد – ما يقارب ثلثي الميزانيّة – وقعٌ قاسٍ اضطرّنا العودة إلى نموذجٍ شبه تطوّعي، تُدار فيه المجلّة بجهد جماعيّ صغير يقدّم عمله عن طيب خاطر وبمعونة محدودة من صناديق نسويّة وشبكات ومجموعات تقودها شعوب الجنوب العالمي. إنّ أمراً واحداً بات جليّاً: لا الدول، ولا المؤسّسات، ولا الجهات المانحة، ستتمرّد يومًا ضد الغاية التي أُنشئت من أجلها: ترسيخ نظامٍ عالميٍّ لم نعد نطيق العيش في ظلاله. نظام يُطالِبنا بأن نُكرّس أجسادنا وحكاياتنا وأفكارنا في خدمة استمراره.
لا مفترقَ طرق ها هنا في عالمٍ يُقال إنّه متعدّد الأقطاب، بل هي وقفةُ تضادٍّ صارخة، لا تصدر عن انفعالٍ سياسيٍّ لحظي، بل عن نزاعٍ للبقاء، وثباتٍ أخلاقيٍّ لا تراجع فيه. حين التقينا من جديد مطلع هذا العام واستأنفنا العمل على هذا الملفّ، كان الكيان الإباديّ قد وسّع حربه الاستعمارية لتشمل لبنان، وتمتدّ إلى أرجاء أخرى من المنطقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من وضوح الترابط بين جغرافيّاتنا ونضالاتنا، ظلّت الكتابة عن لبنان أمراً يشبه المستحيل. أراد كتّابنا توجيه أنظارنا ومواردنا وجهودنا التنظيمية وعواطفنا نحو فلسطين، وإلى الاستجابة العاجلة لإيقاف الإبادة الجماعية بكلّ الوسائل الممكنة. ثانياً، بدأنا نتساءل عن مدى جدوى الاستمرار في منشورٍ مثل "كحل"، لأننا أصبحنا نشكّك في جدوى إنتاج المعرفة ككلّ، حتى حين يكون متجذراً في ما يُسمّى "الأصالة" والوفاء لعوالمنا. فالحقّ يُقال، إنّ الجماعات التي ترفع شعار التطبيع مع المحتلّين الصهاينة الإباديين كـ"الحل الوحيد للبنان" هي أيضاً محلية وأصيلة في هذه الأرض. ينتج الحديث عن لبنان بمعزل عن سياقه الإقليمي، والمحاولات الليبرالية لإضفاء شيء من الاستثنائية عليه إلى إغفال واقع جيوسياسي جوهري: لبنان شريك في الحفاظ على هياكل الدولة الاستعمارية الاستيطانية، وجزء من مشروع استعماري أوسع للمنطقة، يتعيّن عليه الاستمرار في مقاومته.1
بعبارة أخرى، يولي هذا الملفّ اهتمامه للتعبيرات المعرفية المحلّية التي تقف بكل وضوح وبدون مواربة في وجه ممارسات السلطة الاستعمارية والمؤسّسية. كما يسبر غور ثلاثة مآزق كبرى تواجه إنتاج المعرفة المناهضة للاستعمار في زمننا هذا، كاشفاً التحديات التي لا يستهان بها على طريق مقاومة الهيمنة وإعادة صياغة فعل الإنتاج المعرفي.
الأولى، تتعلّق بمأزق الطريق المسدود الذي يفرضه واقع الدولة القومية. فبعد عامين من الإبادة في غزّة، ومن الهجمات الاستيطانية وسرقة الأراضي في الضفة الغربية، تتسابق القوى الغربية للاعتراف بفلسطين كدولة، في الوقت ذاته الذي تستمرّ فيه بتزويد الكيان الصهيوني الإبادي بالأسلحة. فماذا يعني الاعتراف بدولة على أرضٍ مزّقتها المستوطنات؟ وماذا يعني القبول بنموذج دولةٍ يمنح الاحتلال غطاءه الشرعي؟ وفي الوقت ذاته، كيف للعالم حرمان الفلسطينيين من دولتهم، في عالمٍ صارت فيه الحدود ذات وظيفة وجودية لا يمكن تجاهلها، كما تتأمّل كل من نادين صايغ وهايدي سارة عفي بعيدًا عن التحليلات السياسية السائدة حول التنمية والاستدامة والديمقراطية، تكشف نصوص هذا الملفّ عن الفشل الجمعي لمفهوم الدولة. فهي، من خلال تحدّي حدود الدول القومية الاستعمارية، تبيّن أنّ هذه البنى بطبيعتها استعمارية، ولا مفرّ من إرثها البنيوي.
المأزق الثاني الذي يواجه إنتاج المعرفة المناهضة للاستعمار اليوم يكمن في التوتر القائم بين الواقع والخيال، ذلك الثنائي الذي يفرض علينا منطق "البحث" و"المناصرة"، التفرقة بينهما. فكما توضح جولي-يارا آتز، يُطلَب دائماً من المستعمَر إثبات الواقع من الأحداث كدليلٍ على وجود الاستعمار، بينما يُتاح للمستعمِر الحقّ في نسج الأساطير والخيال كيفما شاء، إذ أن صحّة ما يقول مبتوتٌ بها مسبقاً دون حاجة إلى برهان. من جانب آخر، يشير كريم قطّان، في روايته المعنونة "القصر على التلّة العالية" (2025)، إلى أنّ المستعمَر يُتّهم أنه نسيجٌ من الخيال، لكي يجري محوه وتخليده في الوقت عينه ضمن منطق متناقض لا ينتهي. فالتخليد هنا لا يعني إلّا أن يصبح المرء "من شخصيات الخيال الغابرة". بعبارة أخرى، مسألة التمييز بين ما هو حقيقي وما هو خيالي – أي من يعترف الاستعمار بوجوده ومن ينفي وجوده – تؤكّد مرّة أخرى أنّ هذه الحدود بين الحقيقة والخيال لا يحدّدها أي مقياس مطلق أو أداة قياس مستقلّة، بل تفرضها أنظمة السلطة فرضاً. مهما تكاثرت الأدلة التي تثبت وقوع الإبادة الجماعية، فإن الإبادة تواصل سيرها تحت ستار الحقائق،2 ويظلّ الفلسطينييون – موضوع الإبادة – "خياليّون" في عيون مستعمِرهم.
هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة: وَجَب علينا، مرّة وإلى الأبد، الانفكاك عن الأسطورة الاستعمارية المسمّاة بـ"الموضوعية العلمية". المأزق لا يكمن في الموضوعية ذاتها، بل في الدول والمؤسسات ومراكز البحث والتقنيات المبتكرة إلى المناهج الدراسية ووسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص التي سهّلت استمرار الإبادة الجماعية. لقد سقط حق تلك الكيانات في الادعاء بتبحّرها المعرفي، أو بالموضوعية المزعومة التي تتباهى بها. وإذا كان هناك ما تثبته إيلينا فاسيليو، فهو أنّ هذه الموضوعية تُستغلّ لتبييض جرائم الإبادة الجماعية. تستطرد فاسيليو بالقول، لقد اختارت فروع المعرفة، التي يفترض أن تعالج معضلات العالم، الحياد والصمت، فما هي أفعال العصيان المعرفي التي يمكن لنا أن نقوم بها حينئذ؟ بوصفنا منتِجي معرفة، يكمن مأزقنا في أنّ عصياننا يُروَّض قبل أن يولد، ونجد أنفسنا دائماً مضطرّين لاستخدام الأدوات ذاتها التي طوّرها الفكر الإمبريالي والاستعماري في مقارباته البحثية للعالم. بكلمات أخرى، مأزقنا ليس في مضمون ما ننتجه فحسب، بل في شكله أيضاً. غير أنّ هذا المأزق ذاته بات سؤال مقاومة، كما تجسّده الأعمال الكويرية التي تلتقي فيها حدود الفن بالبحث، مثل عمل ياسمين رفاعي ونديم شوفي بعنوان "في ساحات الملتقى" (2025)، الذي وُلد لا رغمًا عن أنف حروب الإبادة فحسب، بل بفضل رفضنا الإذعان للنظام العالمي القائم.
لا يحتمل زمن الإبادة أيّ "سهوَةٍ نقديّة"3 (آتز). في هذا الملفّ، يسعى كتّابنا إلى زعزعة مفهوم الزمن الاستعماريّ، عبر مساءلة الرأسمالية والعمل في لحظةٍ يتداعى فيها كلّ شيء، والتساؤل عمّا تعنيه لغة "وقف إطلاق النار" حين يكون العنف الاستعماريّ حالةً متواصلة لا انقطاع فيها (شعار وطالب). أمّا يوميّات لمى طالب، فليست مجرّد توثيقٍ لهذا الامتداد الزمنيّ للعنف، بل هي أيضاً تأمّلٌ عميق في معنى الذاكرة تحتضن تباينات دون خوفٍ أو مواربة. وفي ميدان "الحقائق" و"الأدلّة"، تصبح مطالبتنا بالكتابة والتذكّر بصفاءٍ واتّساقٍ ونحن تحت القصف شكلًا من أشكال الغطرسة الاستعمارية الفجّة. فأن نُجبَر على أن نظلّ دوماً "مسجَّلين" في مواجهة المحو (قطان)، إنّما هي طريقة أخرى لحرماننا من طرح السؤال الذي صاغته جولي-يارا آتز عقب تحرّر سوريا من حكم الأسد: "فكم من نصر يمكن أن يتحقق؟"
ماديّةٌ هي تداعيات الإخفاق السياسيّ والأخلاقي في حاضرنا. تبدأ بالتناقض الفجّ بين الاستمرار في تسليح كيانٍ إباديّ وبين التنديد بأفعاله، وتمتدّ إلى مخططات "المساعدات" و"التمويل" المُخزية التي تُقدَّم تحت لافتة "الإغاثة الإنسانية"، كما تبيّن بريسيكا شعار في دراستها المتعمّقة. هذه الممارسات لا تهدف سوى إلى خلق وهمٍ بأنّ أقصى ما يمكننا فعله هو الجلوس على الهامش، مرتجفين خوفاً، نحسب كلماتنا بدقّة، ونُمعن التفكير في كل خطوةٍ تالية مستجدين القوى الغامضة والمتقلّبة لـ"الدبلوماسية" و"القانون الدولي". ومع ذلك، فإنّنا نشهد، في كلّ مكان نذهب إليه – ولا سيّما عبر القارّة الآسيوية وفي بلدان الشمال الإمبريالي – حركاتٍ شعبية مناهضة للاستعمار وغير مسبوقة في زخمها ضد الإبادة، مهما بدت ناقصة أو متعثّرة. وبصفتنا منتِجي معرفة مناهضة للاستعمار، فإن واجبنا الأخلاقي لا يحتمل المواربة أو الاعتذار. فمهما اشتدّ بنا الخوف، ومهما أُنهِكنا، ومهما كان عزلُنا في سياقاتنا قاسياً، تبقى الحقيقة التي لا يمكن التنصّل منها أنّ إبادةً جماعيةً تتوسّع في رحاب فلسطين، ولا مجال للمساومة تحت نير الإبادة.
- 1. مايا زبداوي وزهور محمود، "لسنا بأبرياء، ولن نكون"، مجلة "كحل لأبحاث الجسد والجندر"، مجلد 10 عدد 1، 2024. https://kohljournal.press/ar/node/407
- 2. أحمد، 2016.
- 3. اخترتُ هذه الترجمة عن قصد لتجلية مقصد الكاتب من لفظة "مسافة" في سياق مفهومه لما يُسمّى بـ"المسافة النقديّة" (critical distance). فالمعنى المقصود يتراوح بين الترفّع عن النقد، أو الابتعاد عنه، أو التيه الذي يصل حدّ الإغفال. بناءً على ذلك، آثرتُ ترجمة اللفظة إلى "سهوة نقديّة"، لما تنطوي عليه من ظلالٍ دلاليّةٍ تجمع بين تلك المعاني المتباينة. (ملاحظة المترجمة)
Ahmed, Sara. 2016. “Evidence.” feministkilljoys, July 12. https://feministkilljoys.com/2016/07/12/evidence/
Zebdawi, Maya, and Mahmoud, Zuhour. 2024. “There Will Be No Innocents Amongst Us.” Kohl: a Journal for Body and Gender Research, 10(1). https://kohljournal.press/there-will-be-no-innocents-amongst-us