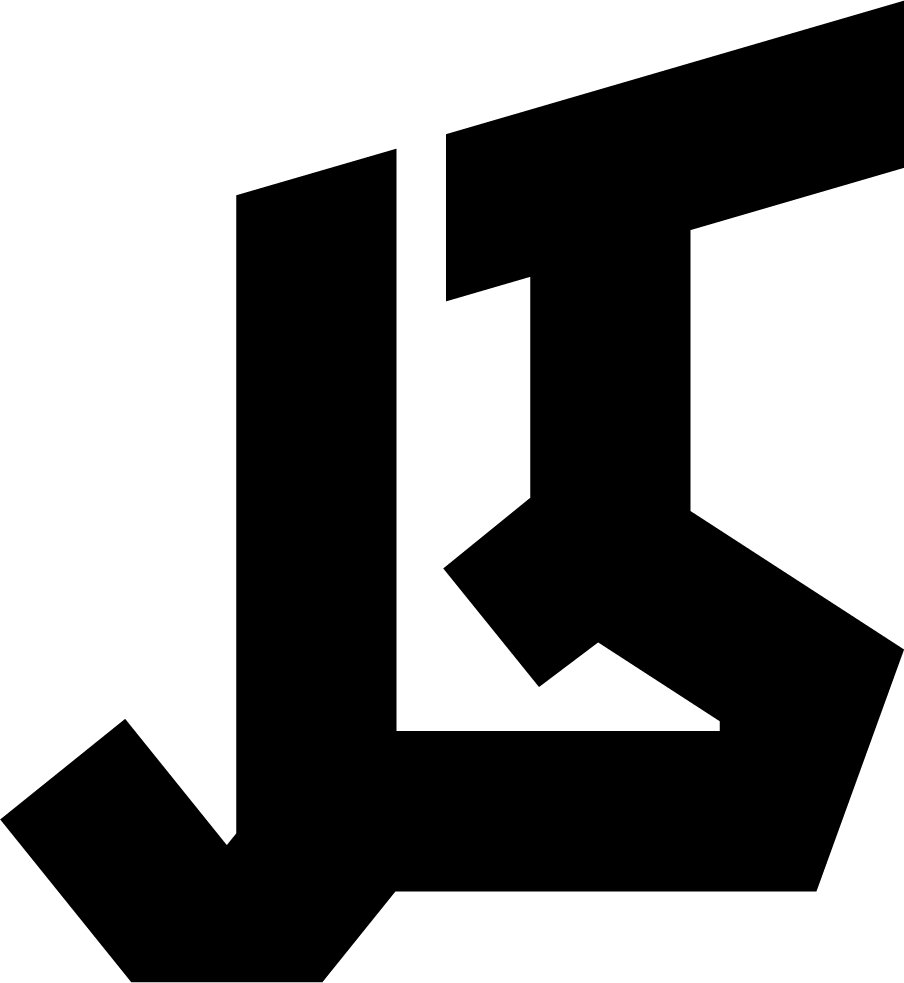الحقيقة في مرايا الخيال: حكواتية في زمن الإبادة
facts_and_fiction_ar.jpg
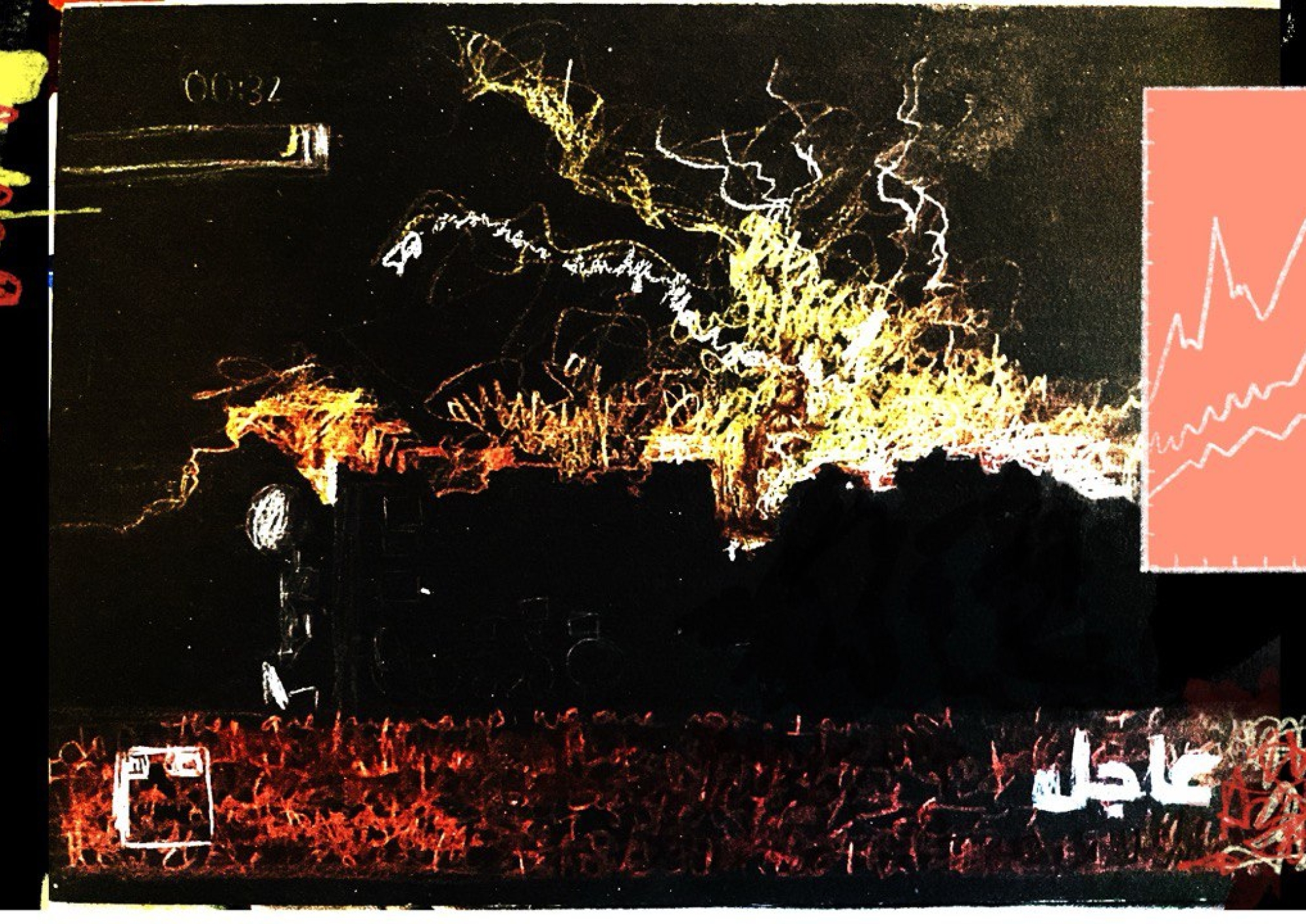
ميرا المير
بس بيخافوا اللي بيحبّ يطلعله صوت
– بو كلثوم، 2018
يأتي هذا المقال امتداداً لكتابتي الإثنوغرافية الذاتية السابقة بعنوان "محاولتي أن أكون حكواتية في زمن الحرب والخراب في سوريا" (Atz, 2023)، التي خطّيتها قبل سقوط نظام الأسد1 في سوريا. لقد كتبت ذاك النص قبل أن تتفاقم الإبادة الجماعية في غزة. غزة التي تبدو ديباجة لحرب عالمية ثالثة، سواء اخترت النظر إليها كواقعٍ أم كمشهد خيالي. في ظلّ هذا التشظّي العالمي الذي يتكّشف في الزمن الحاضر، حيث يُعاد تشكيل السرديات التاريخية، ويجري إقصاء الأصوات، وتتحوّل اللغة ذاتها إلى ساحة نزاع، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل ما زالت للكلمات فعالية ومعنى؟ هل يمكن للقصص أن تُروى بطريقة تتجاوز القوالب النمطية المهيمنة مثل: البطل، الضحية، والوحش؟ وكيف يمكن للكلام أن يجد منفذاً وسط منظومات العنف البنيوي، وإنتاج القبول الجمعي المصطنع، واللامبالاة العالمية المتزايدة؟ إنّها أسئلة ملحّة ومتعددة، ولا أدّعي امتلاك أجوبة جاهزة لها.
من خلال التأمّل في فضاءات السرد الروائي، والصحافة المواطنية، والتعاطف، والتمثيل، أجادل بأن السرد – حين يُنجز بعناية وبخيال خصب – يحافظ على تعقيد التجربة الإنسانية وغناها. فهو أداة للبقاء، وللشهادة، وللحلم. كما أنه يربك السرديات المهيمنة ويتيح تصوّر مستقبل يتجاوز الألم والعنصرية البنيوية، فاتحاً المجال أمام الأمل وإمكانيات التعاطف. وكما تكتب لورين برلانت: "القالب الروائي هو الخيار الذي تلجأ إليه للحديث عن مُجريات حدثٍ تقتل فيه الفاجعة أحدهم ولا تقتلك أنت" (2022:155). إن القالب الروائي، بهذا المعنى، قد يتحوّل إلى وسيلة لاستعادة الذات في مواجهة العنف، بما يقدّمه أحياناً من صدقٍ أعمق مما تستطيع الكلمات وحدها أن تحمله.
للشروع في هذا النقاش، أستحضر فكرةً طوّرها كلٌّ من جاك رانسيير وجان-لوك غودار، من شأنها أن تسهم في فهم التصادم الراهن مابين الواقع والخيال، في لحظة أخذ فيها العالم يتشابه مع حقبة "مطاردةٍ حديثة للساحرات"، تستهدف كلّ من يجرؤ على إبداء رأيٍ يناقض السردية السائدة.
بحسب جاك رانسيير، قال المخرج الأسطوري جان-لوك غودار في إحدى المرات إن النوع الأدبي لإسرائيل هو الملحمة (الأسطورة، الحكاية والخرافة)، بينما النوع الأدبي للفلسطينيين هو الوثائقي (الوقائع، القانون، والأرقام) […]. فمن زاوية الإبداع، تستطيع إسرائيل أن تروي سرديتها في سجلٍّ أسطوري لا ينازعها فيه أحد، في حين يُفرض على السرديات الفلسطينية أن تُقدَّم في سجلٍّ معرفيّ قوامه الحقائق والإحصاءات. ومن زاوية المتلقّي، تُقدَّم الرواية الإسرائيلية كي تُبتلَع كاملةً، من دون مساءلة أو تردّد، أشبه بحبّة دواء مصمَّمة لإدخالك في هذيان؛ بينما تُقدَّم الرواية الفلسطينية لكي تُدقَّق وتُفحَص، وليتفاعل معها المتلقّي بشيء من الشفقة أو التعاطف، إن شاء.
(...)
إن هذا التوزيع غير المتكافئ للقالب السردي مسؤول جزئياً عن التنافر الذي نلحظه في الإعلام اليوم: فمن جهة، هناك من يدفع بالسردية الأسطورية قُدُماً حتى في مواجهة أبشع الحقائق؛ ومن جهة أخرى، هناك من يلتزم بنقل الوقائع، بالشهادة عليها في كل لحظة، بل وبالمخاطرة بحياته ومكانته الاجتماعية في سبيل الحقيقة. ليس غريباً، إذن، أن استهلاك الإعلام في عصرنا الراهن يولّد شعوراً بالدوار أكثر من أي وقتٍ مضى: ننتقل من جنسٍ سردي إلى آخر، رؤوسنا تدور ونحن نحاول التوفيق بين ما لا يمكن التوفيق بينه.
(...)
وما أعنيه هنا أنّ هذه الأجناس السردية تفترض مسبقاً نوعاً من التواطؤ بين مَن يخلق السردية والمتلقّي في إنجاح الحكاية. فمَن يتلقّى الملحمة يغتسل في مجدها لأنه مؤمن سلفاً بأن الشعب (بدور البطولة) الذي تدور حوله يستحق هذا التقديس الملحمي. وبالمثل، حين يجلس المرء لمشاهدة فيلم وثائقي عن "الآخر المقهور"، فإنه يفعل ذلك لأنه قبِلَ مسبقاً بوجود ما ينبغي أن يتطلّع به هنا، وبأن ثمة في القصة مَن يحتاج إلى اهتمامٍ وعون. (Hariri, 2024)
قضيتُ عمري محاولةً، رغم الإخفاق مراراً، التوفيق بين ما لُقِّنته من جهة وما كان يعتمر في داخلي من جهةٍ أخرى. أعيش ممزّقة بين هويتين، سورية وسويسرية، وأشعر بعمق التناقضات التي تشقّ العالم وتعيد رسم طبقاته، حيث لم يعد التحيّز خافياً، بل صار شعاراً يتشدّق الناس به. أستعيد جدالاً مع صديق كان يؤمن بوجود "وجهة نظر موضوعية"، كأنّ الحقائق جميعها ينبغي أن تُصفّى من خلال عدسة واحدة متسلّطة. لكن ما أقرؤه بالعربية يروي حكاية مغايرة لما أقرؤه بالفرنسية أو الإنجليزية. هذا التباين ليس مسألة لغة فحسب، بل هو انعكاس لحقيقة معاشة، ملموسة (Hariri, 2025). كيف يمكن أن نفهم تجربةً ما زلنا نخوض غمارها؟ حين ينفتح الجرح الجماعي، يختلّ الزمن؛ نعيش في حلقة مفرغة يتداخل فيها الحاضر مع المؤجَّل، وتنهار الأزمنة بعضها فوق الآخر.
قبل أن أبدأ التمثيل، درست في معهد للسينما في سويسرا. أذكر أنّ أستاذاً وبّخني لأنني وصفت الأسد بالديكتاتور بدل أن أقول "رئيس". كنت في مطلع العشرينيات، قلِقة، متمرّدة، ومصمِّمة على أن أسمّي الأشياء بأسمائها. كان من حولي يمضون في حياتهم غير مُبالين لما يحدث، بينما كنتُ أفقد صوابي في صمت، أشعر أن نسخة بديلة من حرب عالمية ثالثة كانت تتكشّف أمامي. إنه واقع مختلّ: أن أكون في مأمنٍ جسديّاً، فيما يتعرّض أحبّتي للمخاطر هناك. كما تشير كراكي (Aubery, 2024)، العنف كامِن في الطريقة التي "تقاس" بها قيمة الحياة، وفق جواز السفر أو العرق. أدركت حينها أنّه لو هزّنا انفجار واحد جميعاً، فإن جواز سفري السويسري كان ليضمن لي أن أتحوّل إلى عنوان في الصحف، وكنتُ لأُصبح أنا القصة. ولم أكن قد فعلت شيئاً لأستحق لأجله جُلَّ ذلك الاهتمام، إنها فكرة فطرت قلبي مراراً وتكراراً.
إني قريبة حدّ الاختناق وبعيدة حدّ الغربة. حين طلبت تمويلاً لفيلم وثائقي عن الصدمات النفسية العابرة للأجيال في لبنان، حيث عشت، قيل لي إنني "عاطفية أكثر مما ينبغي"، وإنني أفتقر إلى "المسافة النقدية". وكأنّ العاطفة تجرّدني من الأهلية، وكأن الفن لا يمكن أن يكون سوى تنظير جاف. في المقابل، يجيز المموّلون الغربيون لأنفسهم، وهم لا يتقنون العربية أصلاً، أن يوجّهوا شكل الحكاية ومسارها كما يروق لهم. فلماذا لا أغضب؟ لبنان بالكاد أكبر من مقاطعة سويسرا الناطقة بالفرنسية. وحين تقول التقارير إن إسرائيل "تقصف الجنوب"، فهي في الحقيقة تقصف عائلات بعينها. وفي بلد بهذا الصِغر، لا ملاذ للفرار. أؤمن أنه لو قُصفت بلدة "فيفي" السويسرية، لانتفضت جنيف. ربما يكون هذا هو الفيلم الذي عليّ أن أكتبه.
مأزق الحياة […] يكمن في سيولتها الهلامية، في مرونتها المفرطة حدّ السخرية. أنظر إليها: حبكة واهية، شبه خالية من الموضوع، عاطفية ومبتذلة على نحو لا فكاك منه. حواراتها رديئة، أو على الأقل شديدة التفاوت. ومنعطفاتها إمّا متوقَّعة وإمّا مفتعلة بحثاً عن الإثارة. والبداية دائماً واحدة؛ والنهاية دائماً واحدة (Amis in Jackson, 2013:40).
يا للعبث ويا للوجع، أن تقف آمناً، تتأمّل أناساً يوثّقون بأنفسهم مسيرة فنائهم. أقولها انطلاقاً من جرح سوريا، ومن مشهد غزّة، وكل فلسطين، ولبنان... وكما حذّر جيمس بالدوين: "من يُغمض عينيه عن الحقيقة إنما يستدعي هلاكه، ومن يصرّ على التمسّك ببراءةٍ ماتت منذ زمن، يتحوّل إلى وحش" (1955:138). وهكذا أجدني أرقب المشهد، مصلوباً بين العجز واليقظة. ولسنوات، كما كثيرين غيري، غمرتني الصحافة المواطنية: ذلك التوثيق الأفقي العاجل، المتولّد من رحم الخطر، والذي يخطّه أناس يعيشون المأساة في لحمهم ودمهم، في قلب العاصفة لا على تخومها. وتشير منذر إلى أن الجذر الثلاثي للفظة ش-ه-د يجمع بين فعل الشهادة وفعل الاستشهاد: "كأنّ فعل الشهادة، إذا امتدّ حتى أبلَغ معانيه، انكسر تحت ثقل ما يُرى، فيسقط الشاهد صريع ما شهد عليه" (2016).
لقد أتاح الإنترنت منفذاً مباشراً إلى أصواتٍ لم تمرّ عبر قنوات مؤسساتية. وفّر ذلك صوراً مباشرة من أرض الحدث، مشبعة بطاقة احتجاجية، أسهمت في السياق السوري في بلورة ثقافة جديدة للاعتراض، يمكن قراءتها بوصفها شكلاً من أشكال إنتاج الحياة الجماعية (Boex in Della Ratta, 2018:137). إن السرديات الشخصية بما تتيحه من تعقيد، تواجه السرديات السلطوية القائمة على الاختزال والتبسيط؛ وبذلك يصبح منتجو الصور مستهدفين لأنهم يهدّدون الصورة المهيمنة ويقوّضون سطوتها. غير أنّ الحاجة الى إخفاء الهوية التي لازمت الصور السورية جعلتها عرضة للتهميش، حيث فقد الكثير منها، في غياب السياق، قوامه الإنساني وملمسه المعيشي. الأخطر من ذلك أنّ مواداً عديدة جرى الاستيلاء عليها وإعادة توظيفها من دون إذن أو من دون نَسبها إلى أصحابها، وهو ما يمكن تسميته بـالمحو المزدوج: محو الصوت ثم محو الإرادة التقريرية. وفي عالمٍ ما تزال فيه قوة السرد محتكرة إلى حد بعيد في "الشمال العالمي"، يبرز هذا المحو لا بوصفه حادثة عابرة، بل آلية بنيوية لإعادة إنتاج الهيمنة على تمثيل المقهورين.
لا يكمن العنف في مضمون الصور بحدّ ذاتها فحسب، بل في فعل تكرارها. هكذا تتحول الصورة من أسلوبٍ لأنسَنَة الضحية إلى قالب ما للفرجة، تُسطِّح المعاناة وتحوّلها إلى عاطفة قابلة للاستهلاك السريع العابر. وكما يشير حريري:
إنّ المشهديّة خادعة على هذا النحو تحديداً، فهي وإن كانت تغمرنا بانطباعات فريدة عن أشخاص وأشياء بعينهم، إلا أنها في الوقت ذاته تخون ذواتهم الفردية، وتصهر بذلك الحيوات تلك غير القابلة للاستبدال في قوالب عامّة جامدة ضمن أنماط استهلاكية صلبة. تنطوي هذه الرؤية المتحجّرة على خطر نزع الإنسانية عمّن يقع في مرمى الكاميرا، فتحوّلهم إلى مجرد أجساد عابرة، أو ضحايا عدوان إسرائيلي ــ لا شيء أكثر من ذلك. (2024)
هكذا، يأكل التكرار من حِدّة التعاطف، وبالأخصّ حين يتعلّق الأمر بأجساد غير البيض الغربيين، فيُختزل البشر إلى ضحايا بلا أسماء. ويقترح حريري ممارسةً يقظة تقوم على أن نكتب شيئاً مع كلّ مقطع نشاهده، علّ الكتابة تصبح وسيلة لمواجهة هذا المحو.
إن نزع الإنسانية لا يتجلّى في اللقطات المصوَّرة وحدها، بل يتسرّب أيضاً عبر القصص التي نرويها. فالسرد، بدوره، ليس محايداً قط. وكما يذكّرنا إدوارد سعيد، يمكن للحكايات أن تخدم السلطة: أن تضفي الشرعية على الحرب، وتسوّغ الرقابة، وترسم ملامح مَن يُصنَّف على أنه مصدر خطر (Hariri, 2025). ويوسّع حريري هذا المنطق ليشمل حتى قراءته لمدرسة القصص الخيالية فيقول: "حين تخبر العالم أن العرب مصدر للمخاطر– ولو بإيحاء خفي – فإنك تعلّم الناس أن يثقوا بالطائرة المسيّرة، وبنقطة التفتيش، وبقرار رفض لتأشيرة عبور" (2025).
حين وصلت الناشطة غريتا تونبرغ إلى باريس في حزيران/يونيو 2025، بعد مشاركتها في "أسطول الحرية" على متن السفينة مادلين في محاولة لكسر الحصار على غزّة، وجدت نفسها في مواجهة أسئلة الصحافة:
- كيف عاملَكم الإسرائيليون؟ لقد رأيناهم يقدّمون لكم سندويشات؟
* على الأرجح أنهم نشروا الكثير من الاستعراضات الدعائية. ما فعلوه في الواقع كان عملاً غير قانوني؛ لقد خطفونا في المياه الدولية. لكن هذه ليست القصة الحقيقية. القصة الحقيقية هي الإبادة الجماعية في غزّة وسياسة التجويع المنهجي.
- لماذا تعتقدين أنّ كثيراً من الدول والحكومات حول العالم تتجاهل ما يحدث في غزّة؟
* بسبب العنصرية، هذا هو الجواب البسيط. العنصرية، ومحاولة يائسة للدفاع عن نظام مدمّر وقاتل يضع الربح الاقتصادي قصير الأمد وتعظيم النفوذ الجيوسياسي فوق كرامة البشر وسلامة الكوكب. والآن بات من الصعب جدّاً تبرير هذا الموقف أخلاقياً، ومع ذلك فإنهم يواصلون الدفاع عنه بتوحّش.
لقد أعادت تونبرغ بتدخّلها تركيز الأنظار نحو غزّة لا نحو نفسها. فقد توجهت عمداً نحو دائرة الضوء، مدركةً أن حضورها سيجذب اهتمام الإعلام العالمي – ليس فقط لأنها شخصية معروفة، بل أيضاً لأنها بيضاء وشقراء. وكما رأينا في حالة أوكرانيا (Bayoumi, 2022)، ما زال التعاطف المؤطَّر بالعنصرية هو القاعدة السائدة.
كما تشير كراكي، فإن التعاطف لا يتمخض عن موقف محايد، بل يتشكّل بفعل القرب والانتماء والهياكل المنحازة (Aubery, 2024). فكلما تعرّفنا إلى شخص وارتبطنا به، أصبح من الأسهل أن نكترث لأمره – غير أن هذه الألفة قد تأتي بثمن، إذ تضيق معها دائرة اهتمامنا، ويصعب علينا أن نرى إنسانية الآخرين. عقب زلزال 2023 في تركيا وسوريا، قدّم زين العربي تصحيحاً هادئاً يوضّح مفارقات المسألة حين قال: "ليست 30 ألف وفاة. إنها 30 ألف حياة. ثلاثون ألف ’أحبك’" (2023). فكل حياة كونٌ قائم بحدّ ذاته.
يحذّر ثياغو آفيلا، أحد المشاركين في "أسطول الحرية"، من خطورة صناعة الأيقونات، إذ أن التركيز على "البطل الفرد" قد يحجب البعد الجمعي: تعدّد المخاطر، والعمل غير المرئي، والأسماء التي لا تتصدّر العناوين (2025). وهذا التحذير يجد صداه في تعاليم معهد المسرح، حين قُدِّم لنا مفهوم "رحلة البطل"؛ ذلك المسار السردي النمطي الذي ينطلق خلاله البطل ليواجه المحن، ويعود في حالة من النموّ البنيوي حاملاً الدروس والمواعظ أو الهدايا. ورغم جاذبية هذا الترحال، إلا أن هذا النموذج يقوم على مسلّمة أن ثمّة خيار وإرادة تقريرية ترسم معالم الرحلة. غير أنّ مراقبتي لأسرتي وهي تكابد الحرب كشفت لي قصور هذا الخط السردي في التعبير عن واقعنا. لم يختر أهلي الرحيل أوالقتال أو حتى الصمود. لم تكن الحرب نداءً للمغامرة، بل كانت عنفاً مفروضاً عليهم عنوةً.
دخلتُ المعترك السياسي في السابعة عشرة من عمري. قال لي ناشط مخضرم آنذاك إنني أصبحتُ "إنساناً جيداً". لطالما أبغضتُ هذه الثنائية، إذ أن قلّة هم من يصفون أنفسهم بأنهم "سيّئون". لم أكن قد تغيّرتُ، بل تبدّلت ظروفي. لم يكن الأمر يوماً خياراً إرادياً بقدر ما كان استجابة لقسوة السياق. تذكّرت ذلك وأنا أشاهد مقاطع من التظاهرات الباريسية التي احتفت بإطلاق سراح ريما حسن، إحدى روّاد أسطول "مادلين"، صاحبة الابتسامة التي تركت فيّ أثراً عميقاً. هتفَت الحناجر لها بعنفوان، لكن المشهد بدا لي مشوباً بشيء من التناقض. وجدتُ نفسي أتساءل: ماذا عن أسماء الذين قُتلوا؟ هل سيطويها النسيان؟ وهل سيُنظَر إليهم يوماً باعتبارهم أبطال القصة في ذاكرتنا الجمعية – لا ضحايا فحسب، بل بشراً مفعمين بالتعقيد، فيهم من الإرادة والشجاعة ما لا يحتاج إلى كلام رومانسي معسول؟
أريد مزيداً من "الأبطال" غير النمطيين، أبطالٌ يحملون عيوبهم معهم ويعملون من أجل الجماعة، ويُعيدون البوصلة نحو ذاك الآخر لا نحو ذواتهم. أشتاق إلى "ضحايا" أكثر تمرّداً، أولئك الذين يصرّون على البقاء أحياء في وجه ما لا يستطيع القلب احتماله – وقد حذّرنا كركي من أنّ موقع الضحية يمنح أحياناً راحة أخلاقية خادعة (2024). وأشتاق أيضاً إلى "وحوش" أكثر إنسانية – وحوش وُلدت من تصوّرات عنصرية ترى في الأجساد غير البيضاء تهديداً (Hariri, 2025)، أو من فظائع دفعت أناساً عاديين إلى حافة المستحيل. وحوش تذكّرنا أن الحياة لا تُختزل في خير وشرّ، بل تطلب منّا ألواناً أخرى، أكثر تعقيداً، أكثر صدقاً تبرز وسط أحوال هذا الزمن.
الواقع وحش معقّد إلى حدٍّ يجعل الإحاطة به أو حتى مقاربته بحاجة إلى ما هو أوسع من مجرّد الواقعية السردية. وهنا يدخل الأدب الخيالي، بما فيه من كائنات فضائية وسحر ومحركات تُطيح بالزمن والمكان، على خلفية هذا الكون نفسه. لكن، في عمق الغرابة كلّها، نجد المألوف من الحب والغضب والصراع والدهشة – نجد ذواتنا متنكرة، لكنها حاضرة. أوليست "المهابهارتا"، بكل ما تحمله من روائع الحكاية، سوى صورة للمعركة التي تضطرم في داخل كل فردٍ منّا؟ (Singh, 2021)
حتى في طفولتي، كنتُ أحلم بأن أكون ممثلة. لكنني كنتُ أرتجف أمام المرآة، أرى في وجهي مسخاً: حاجباً واحداً كثيفاً، شعراً داكناً، ملامح بدت لي خشنة لا تنسجم والمعايير الأوروبية التي كانت تحاصرني. بالمقارنة مع زميلتي البولندية الشقراء – بأنف صغير وشَعر خفيف – كنت أشعر أنني كائن غريب، يكاد يكون وحشاً. اليوم أدرك أن ذلك لم يكن إلا تجلياً للعنصرية الداخلية التي ابتلعتها دون وعي، رغم أنني – في نظر الآخرين – قد أُصنّف “بيضاء الملامح”. ومع ذلك، تظل التجربة شاهدة على هيمنة التمثيل والصورة على مخيالنا.
الممثلة الافريقية الأميركية فيولا ديفيس روَت عن تجربتها حين درست التمثيل في "جوليارد":
- ماذا كان الهدف من تدريبهم لك؟ أن يصنعوا منك ممثلة جيّدة؟ أم ممثلة بيضاء مثالية؟
* ممثلة بيضاء مثالية بالتأكيد.
- وماذا يعني ذلك؟
* إنه تدريب تقنيّ للتعامل مع الكلاسيكيات: ستريندبرغ، أونيل، تشيخوف، شكسبير. أتفهّم ذلك جيداً. لكن ما يجري محوه في كل هذه المعمعة هو الإنسان الذي يقف وراء كل ذلك. بوصفي ممثلة سوداء، كنتُ دائماً مكلّفة بإثبات قدرتي على لعب أدوار “البيض”. أستطيع أن أبذل أقصى جهدي مع تنيسي ويليامز، لكنه يكتب عن نساء بيض ضعيفات. نصوص جميلة، لكنها غريبة عمّن أكون. احزروا ماذا يحدث بعد التخرج؟ تُسنَد إليّ أدوار لشخصيات سوداء فقط، وفي الوقت نفسه يُقال لي إنني "لستُ سوداء بما يكفي". كل يوم، حين أفتح عيني وأضع قدمَي على الأرض، مهمتي الأولى ألّا أخون نفسي. جوليارد كانت تجربة خارجة عن حقيقة جسدي: كنت أشعر أنه لا يمكنني أن أستحضر “أناي” على خشبة المسرح. كان عليّ أن أتركها عند الباب. مع أن هذه الـ"أنا" هي ما أوصلني إلى هناك. أنا جديرة. من كان ليصدّق؟ (Fragoso, 2025)
بعد أن قال لي أحدهم إنني أبدو "بوهيمية أكثر من كوني سورية"، تركت شعري يطول، ظننت أن هذا سيمنحني فرصة أكبر للعمل. لم يفلح الأمر. ما حدث فعلاً هو أنني محوت عنّي ما تبقّى من ملامح غرابتي وكويريّتي. صرتُ أكثر "قابلية للتمثيل" وفق معايير السوق، لكنني أقلّ حضوراً في ذاتي. كنتُ مرئية في نظر الآخرين، غير أنني صرت غير مرئية لنفسي. في لحظة كهذه، أدركت أن المساومة لا تُغيّرني وحسب بل تمنعني من لقاء من يشبهونني. أولئك الذين يفهمون أن الثقافة ليست معزولة عن بنى القوة، بل متجذّرة بأنماط التمويل والانتاج، بالمعايير غير المعلنة التي تحدّد مَن يُرى أو بكلمات اخرى من يُعترف بهم ومَن يُستبعدون. لطالما بُنيت هذه الصناعة على أسطورة "الجدارة": إعمل بجدّ، وستصل يوماً، ستُصبح الاستثناء. لكن هذه الأسطورة تخفي شرطاً أساسياً: أن تنحني، أن تتماهى، أن تذوب في القالب المرسوم سلفاً. وحين نفعل ذلك، قد نحصل على اعتراف خارجي، لكننا نفقد شيئاً من صدقنا الداخلي – وربما من قدرتنا على أن نتصالح مع ذواتنا.
لقد أبقاني هذا الوهم منضبطةً فيما كان النظام يستنزفني حتى العظم. غير أنّ في الانكسار شيء يكشف بعضناً للآخر، كما تقول بهاتاشاريا: "هناك أمر في انكسار القلب يتيح لنا رؤية عمق بعضنا الآخر" (2023:49).
منذ الطفولة كنتُ مشدودةً إلى ما ينبذه الآخرون. كنت أفضّل اللعب المكسورة: تلك التي فقدت أطرافها، أو تشابَك شعرها، أو تعطّلت عجلاتها. بدت لي كأنها تحمل حكايات لم ينتبه إليها أحد. ومع الزمن، تحوّلت هذه الألفة مع اشكال الكمال المنقوص إلى قناعة: ليس بدافع الشفقة، بل لأنّ التصدّع أكثر صدقاً من مساعي الكمال الملمَّع. إنّ الفوضوي والمشوَّه والناقص يفتح باباً للمعنى، لأن في هشاشته تكمن بذور الحقيقة. كصانعة أفلام، استنزفني طغيان الكمال المصطنع الذي يملأ الشاشات: ابتسامات لامعة، شقق فارهة لا يطالها غبار، ثياب جديدة كل يوم. لا أجد فيه ما يُغري، بل ما يُثير الريبة: اقتصاد من الزيف يختبئ وراء بريقه. وأجد نفسي أتساءل: متى سيُسمَح لنا أن نطلّ من على الشاشات كما نحن، لا كمنتجات مصقولة معدّة للبيع، بل ككائنات فوضوية، غير معدّة لسوق الاستهلاك الرأسماليّ؟
أحيانًا يخطر لي أنّ العيوب قد تكون الشيء الوحيد الذي يميّز البشر عن الذكاء الاصطناعي: كم نحن رائعون في هشاشتنا، في تردّدنا، في تناقضاتنا الصغيرة وتفاعلاتنا غير المنضبطة. ولهذا تقول سولنيت إن الخيبة تكمن في "لقاء كائن جامد، لن يموت أبداً لأنه لم يعش أصلاً" (2022:79). تلتقط بهاتاشاريا هذا البُعد في تأمّلها:
الاكتئاب الممزوج بالفقدان لا يعطّل مسار الأشياء ولا يثير ضجيجاً، بل يشبه كما لو أنك خطَوت خطوة داخل الموت، تتصرّف كما لو أنك تذكّرت كيف يُفترض بامرئٍ عادي أن يتصرّف. تكشف لنا هذه الحالة عن أنصاف الموت الذي يفرضه علينا هذا العالم [في ظل الرأسمالية المتأخرة]: أن نتعلّم كيف نمضي في هذا الدرك دون أن نأمل كثيراً. (2023:71)
هذا، للأسف، ينسجم مع الأزمنة التي نعيشها اليوم. وهو يدعو إلى العصيان، إلى رفع الأصوات المكتومة. من غزة تكتب أبو عقلين:
شعري ليس إلا وجعاً مشذّباً. حين أنتهي من كتابة قصيدة وتبدو متقنة تماماً، أنظر إليها ودموعي تغمر عيني وقلبي. يا الله، ما أجملها. وما أخجَلني أن يكون للألم هذا القدر من الجمال. (2025:13)
ذلك الخجل يطاردني أنا أيضاً. قراءة شهادات حقيقية من غزة كانت أصعب ما طُلب مني القيام به كممثلة. لم أستطع أن أواسي نفسي بعدها، أو أذكّرها أنّ الأمر محض خيال ـ لأنه لم يكن خيالاً. بعد كل عرض، لم أكن أستطيع التوقّف عن البكاء. الشخص الذي حملت كلماتَه على ثغري كان قد مات. مات داخل الحكاية، ومات في العالم الواقعي أيضاَ. ربما عليّ ألّا أجد عزاءً. ربما هنا تنتهي النظرية: فهذه القصص ليست خيالاً، بل واقعاً يجري الآن، ولا يُمكن أن يكون لفقدانٍ كهذا وطءٌ بسيط. "لعلّ الحزن هو الخطوة الأهم، هو ما يجعلنا قادرين على رؤية بعضنا الآخر، ورؤية العالم وما جرى به ورؤية ما يجري افتعاله بنا جميعاً" (Bhattacharyya, 2023:8). أو كما اقترحتُ في مقالي السابق: "ليس الألم إلا عاقِبَة الحبّ" (Atz, 2023).
إن عملية صياغة تجاربنا وإخراجها إلى العلن هي بحدّ ذاتها فعل عصيان. إنّه تمرّد على عملية اختزالنا إلى مُجرد مأساة أخرى، إنه رفض لأن ينطق آخرون على ألسنتنا. غير أنّ السؤال يظلّ مُعلَّقاً: هل للكلمات القدرة على إسعاف هذا الألم؟ هل تشفي اللغة غليل حالنا؟
لن يعود البرميل يوماً برميلاً، سيبقى جسداً يتفتّت شظايا في الهواء. ولفظة"الخردل" لن تستدعي سوى الاحساس بغازٍ يلسع الجلد ويُغرق العينين بالدمع. وحين نقول "صبرا" أو "شاتيلا"، لا نسمّي مكانًا، بل نُشير إلى أكوام من أجسادٍ مُلقاة كيفما اتّفق، كأنها أسمالٌ عتيقة. أمّا "النكبة"، فلا تحتاج إلى تحديد، هي المدن وقد وقعت في أسر زمنٍ ماضٍ. إنها أشياء يمكن إعادة سردها أو إنشادها أو استذكارها، لكن يستحيل حلّها أو إخماد وطيسها، فلا خاتمة لهذه الحكاية، إنها الحكاية ذاتها، ممتدّة أبداً. (Mounzer, 2016)
في الأيام التي يتملّكني فيها شعور بالعجز، أنضم إلى المظاهرات كأسلوب للتعبير عن رفضيَ لليأسٍ الذي يحاول هذا العالم اخضاعي له. لأنّ ميري كان محقّاً: أن تخون مبادئك يعني أن تبدأ بالتخشّب، أن تفقد حسّك بالآخر (Pley, 2024). والصمت، عندها، ليس حياداً، بل هزيمة: علامة على أنّ النظام نجح في اقتلاعنا من انسانيتنا. "لأنك إن قبلتَ أنّ ما يحدث في غزة أمرٌ لا بدّ منه، أو واقعٌ لا يمكن تغييره، فإنك تقبل أيضاً بالعودة الأبدية لغزّاتٍ أخرى، ما دامت الأرض تحتضن جنسنا البشري" (Hariri, 2024).
ثم أستنهض من ذاكرتي سوريا وقد تحرّرت بعد أربعة وخمسين عاماً من الديكتاتورية. عقلي يكاد لا يستوعب الفكرة. تبدو غير قابلة للتصديق، كأنها قصة كُتبت في عجالة، غير متقنة الحبكة، أشبه بالخيال منها بالواقع. كنت قد توقفت حتى عن تخيّل هكذا مصير. الطغيان قد قلّص خيالي. لكن إن كان هذا النصر ممكناً… فكم من نصر يمكن أن يتحقق؟ الخيال يفتح نوافذ من التساؤلات والانكسار يمنح جرأة التأمل بتغيّرٍ مرجوّ في الأحوال، مهما بدا ساذجاً أو مستحيلاً. وفي زمن الأزمات هذا، قد يبدو الأدب ترفاً (Chaudhuri, 2024:31)، لكنه في الحقيقة فسحة للتحوّل، للعبث بإملاءات الواقع، إنه ضربٍ من الجنون التحرري. إنّه دعوة لأن نعيد كتابة مصيرنا بأيدينا.
الخيال – تلك الطاقة التي تدفع العقل البشري إلى اتّساعٍ لا حدّ له، بحجم الكون نفسه. هو ما يجعل التعاطف ممكناً، إذ لا يمكنك أن تتذوّق شيئاً من حياة الآخر دون أن يكون فيك شيئاً من الخيال. الخيال، يمنحنا القدرة على الحلم. فالخيال العلمي والفانتازيا لا يقدّمان مجرّد غرائب وعوالم متخيَّلة، بل يفتحان نوافذ على احتمالات أخرى: مستقبلات بديلة، ترتيبات اجتماعية مغايرة، تكنولوجيات متجدّدة، وطرائق جديدة للوجود. فالحلم يسبق الفعل. (Singh, 2021)
وهنا، في فسحة الخيال، نجد للمستحيل لساناً ينطق به.
أتذكّر الهَمهمة الخافتة لأبي – خيطاً رقيقاً من صوته يتردّد في داخلي، يوقظ فيَّ شعوراً بالفقدان لا تستوعبه الكلمات. يتفجّر في روحي ردّ فعل لا أقدر على تسميته. في ذاك الصمت بلاغة تفوق كلّ خطاب، صوت كلّما ضمر تجاوز في وضوح معناه اللغة وما اعتدنا أن نسمّيه كلاماً. (Campt, 2017:4)
في زمننا الراهن، أليست النزاهة تكمن ببساطة في أن تفصح عن موضعك، وعمّاً تراه وتعيشه من موقعك ذاك؟ أن تعيد تخيّل تجربتك، ماضياً ومستقبلاً؟ فإذا كان أورويل يرى أن "كل فنّ هو بروباغندا" (Orwell in Solnit, 2022:154)، فربما تكمن الحقيقة في المسافة الما بين بين، في الشظايا، في الجمل المقتطعة، وفي ما يتعذّر قوله لكن يمكن استدعاؤه بالإيحاء.
إنه فعل مربك، عاطفي، ومشحون سياسياً. يتطلّب جهداً، إذ يدفعنا للتحديق عبر شقوق السرديات المهيمنة، وملامسة التناقضات التي يقوم عليها النظام العالمي اليوم. تذكّر ترامب، مثلاً، الذي أبلغه مدير استخباراته الوطنية، تولسي غابارد، بأن إيران لا تطوّر سلاحاً نووياً. تجاهل الأمر، وأصرّ أنّه "يعتقد" أنّها تقترب من ذاك المبتغى (Megerian and Klepper, 2025). هذا "الاعتقاد"، المنفصل عن أي حقيقة، صار مسوغاً سياسياً. هذا حال اليوم: أنظمة كاملة تتصرّف انطلاقاً من شعور غريزي، بينما يتمّ تهميش السرديات القائمة على الوقائع. يصير التفكير المُتخيّل عقلانيةً رائجة، فيما نشاهد الفلسطينيين تُسقَط لهم المساعدات جوّاً، ثم يُطلَق عليهم الرصاص حين يحاولون جمعها – عقولنا تكافح لتستوعب أن ما يحدث ليس مسلسلاً ديستوبياً جديداً، بل خبراً آنياً.
وعندما عاد والد أبو لغد إلى فلسطين، كتب:
لا أشعر بالمرارة على الإطلاق. بل أشعر أن الوجود الإسرائيلي هو تحدٍّ لنا. ومن المستحيل أن نواجه هذا التحدي بالمرارة… مجيئي إلى هنا، كان جزءاً كبيراً منه رغبةً في تغيير هذا الواقع. لأنني لا أستطيع أن أقاتل بعيداً عن ميدان النضال. (2011:134)
أتذكّر ريما حسن وتياغو أفيلا، وابتسامتهما الدائمة. وأتذكّر محمد الكرد وهو يؤكّد أن التمرّد الساخر سلاح قوي في وجه مساعي نزع الإنسانية عن الشعوب (2024). والآن، بعد أن تحرّرت سوريا، لا يمحي الألمَ يقينٌ في أن الكوابيس يمكن أن تنتهي، لكن هذا اليقين يغيّر الطريقة التي أحمل بها الألم، كما تقول بهاتاشاريا: "كل حلم بعالم جديد يقتضي أن ندرك أننا قد تحطّمنا على يد العالم القديم" (Bhattacharyya, 2023:27). في هذا التصدّع، ثمة فسحة لأمل حذر، لإرادة شخصية، ولأحلام. فالخيال، إذا قاوم الانزلاق إلى أسطورة، قادر أن يحملنا إلى الأمام. قادر أن يعيد تخيّل المستقبل والماضي معاً، وأن يفسح لنا مجالاً لالتقاط الأنفاس في أزمنة خانقة. فإذا كان السرد هو أن تقف حيث أنت وترفض أن تُمحى – في أي زمن – فربما لا وجود لفصل أخير. ثمة الحكاية فقط، وأنفاسنا بسذاجتها تركض في تفاصيلها. أنفاسنا التي تحمل جسدنا الفردي والجمعي معاً.
إِذَا كانَ لا بُدَّ أَنْ أَموتَ
فَلَا بُدَّ أَنْ تَعِيشَ أَنْتَ
لِتَرْوِيَ حِكاياتيإِذَا كَانَ لا بُدَّ أَنْ أَموتَ
فَلِيَأْتِ مَوْتِي بِالأمَلِ
فَلِيُصْبِحْ حِكايةً
(Alareer, 2023)
- 1. في النسخة الأصلية من النص باللغة الإنجليزية كُتب اسم الأسد بهذا الشكل ASSad، وشرحت الكاتبة أن "انتقائها لهذه الصيغة الكتابية هو اختيار مقصود ذو دلالة متمردة، يعكس رفضاً للتطبيع مع الألم أو تهذيبه".
Abu Akleen, B. (2025). “Diary Entry.” In: B. Ghalayini, J. Harker and R. Page (eds). Voices of Resistance: Diaries of Genocide. Manchester: Comma Press, pp. 1–28.
Abu-Lughod, L. (2011). “Return to Half-Ruins: Fathers and Daughters, Memory and History in Palestine.” In: M. Hirsch and N. K. Miller (eds.). Rites of Return: Diaspora Poetics and the Politics of Memory. New York: Columbia University Press, pp. 124–136.
Alarbi, Z. (2023). “ﻗﺘﯿﻞ أﻟﻒ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻟﯿﺴﻮا! by yousef.aldomouky #syria #turkey #valentine.” Instagram, @thezaynalarbi. Available at: https:// www.instagram.com/p/Coo8jO9NS1B/
Alareer, R. (2011). “If I must die.” Available at: https://ifimustdie.net/
Aubery, L. (2024). “Samah Karaki, Docteure en Neurosciences – Apprendre à maîtriser son cerveau.” YouTube, @inpowerpodcast, 11 July [Podcast]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=G-QEYnaEWZE
Atz, J.-Y. (2023). “Trying to be a storyteller in times of war and devastation in Syria.” Traumascapes, 21 November. Available at: https://www.traumascapes.org/post/trying-to-be-a-storyteller-in-times-of-war-and-devastation-in-syria
Ávila, T. (2025). Interview. Instagram, @nacho.lemus, @thiagoavilabrasil and @telesurtv, 13 June. Available at: https://www.instagram.com/p/DK19aIOsldi/
Baldwin, J. (1955). “Stranger in the Village.” In: Notes of a Native Son. Boston: Beacon Press, pp. 17–28.
Bayoumi, M. (2022). “They are ‘civilised’ and ‘look like us’: the racist coverage of Ukraine.” The Guardian, 2 March. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/02/civilised-european-look-like-us-racist-coverage-ukraine
Berlant, L. (2022). On the Inconvenience of Other People. Durham, NC: Duke University Press. Bhattacharyya, G. (2023) We, the Heartbroken. London: Hajar Press.
Bu Kolthoum (2018). “Zamilou.” YouTube, @@BuKolthoumuzic, 4 May [Song]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=k9T0SuZ-xFg
Campt, T. M. (2017). Listening to Images. Durham: Duke University Press.
Chaudhuri, S. (2024). Crisis Cinema in the Middle East: Creativity and Constraint in Iran and the Arab World. London: Bloomsbury Publishing.
Della Ratta, D. (2018). Shooting a Revolution: Visual Media and Warfare in Syria. London: Pluto Press.
Fragoso, S. (2025). “Viola Davis on Worthiness, Juilliard, and the Impact of Meryl Streep | Talk Easy with Sam Fragoso.” YouTube, @talkeasypod, 27 April [Podcast]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=QuHydabht-w
Hariri, M. (2024). “Picturing Atrocity.” Medium, 12 July. Available at: https://medium.com/@muhannadmhariri/picturing-atrocity-f776d96d11cb
Hariri, M. (2024). “Writing Against Thoughtlessness I: The Negation of Discourse.” Medium, 5 January. Available at: https://medium.com/@muhannadmhariri/writing-against-thoughtlessness-4188d8514b94
Hariri, M. (2024). “Writing Against Thoughtlessness II: Neither Epic nor Documentary.” Medium, 7 January. Available at: https://medium.com/@muhannadmhariri/writing-against-thoughtlessness-ii-neither-epic-nor-documentary-4592ac56df31
Hariri, M. (2024). “The Madness of our Moment.” Medium, 27 May. Available at: https://medium.com/@muhannadmhariri/the-madness-of-our-moment-c73f05294624
Hariri, M. (2025). “Exiting the Mind.” Medium, 12 April. Available at: https://medium.com/@muhannadmhariri/exiting-the-mind-942ce8d4c0e4
Hariri, M. (2025). “The West’s Manufactured Fear: How Media Made “The Middle-East” the Enemy.” Everything is Political. Available at: https://everythingispolitical.com/readings/the-wests-manufactured-fear-how-media-made-the-middle-east-the-enemy
el-Kurd, M. (2024). “Why do oppressed people use humor?” Instagram, @mohammedelkurd, 9 July. Available at: https://www.instagram.com/p/C9LoXsutuWa/?hl=en-gb
Jackson, M. (2013). The Politics of Storytelling: Variations on a Theme by Hannah Arendt. Copenhagen: Museum Musculanum Press, University Of Copenhagen.
Megerian, C. and Klepper, D. (2025). “US spies said Iran wasn’t building a nuclear weapon. Trump dismisses that assessment.” Associated Press, 18 June. Available at: https://apnews.com/article/gabbard-trump-intelligence-iran-nuclear-program-51c8d85d536f8628870c110ac05bb518
Mounzer, L. (2016). “War in Translation: Giving Voice to the Women of Syria.” Literary Hub, 6 October. Available at: https://lithub.com/war-in-translation-giving-voice-to-the-women-of-syria/
Pley, G. (2024). “1% des Français sont psychopathes, il nous explique comment les repérer pour la sortie du film TRAP.” YouTube, @legendmedia, 26 July. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=aSwdPZUoJho
Singh, V. (2021). “A Speculative Manifesto.” WordPress, 20 October. Available at: https://vandanasingh.wordpress.com/2021/10/20/a-speculative-manifesto/
Solnit, R. (2022). Orwell’s Roses. New York, NY: Penguin.
Thunberg, G. (2025). “Greta Thunberg speaks to France 24 after her deportation from Israel • FRANCE 24 English.” YouTube, @France24_en, 10 June. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Hk1WEhO07Bw