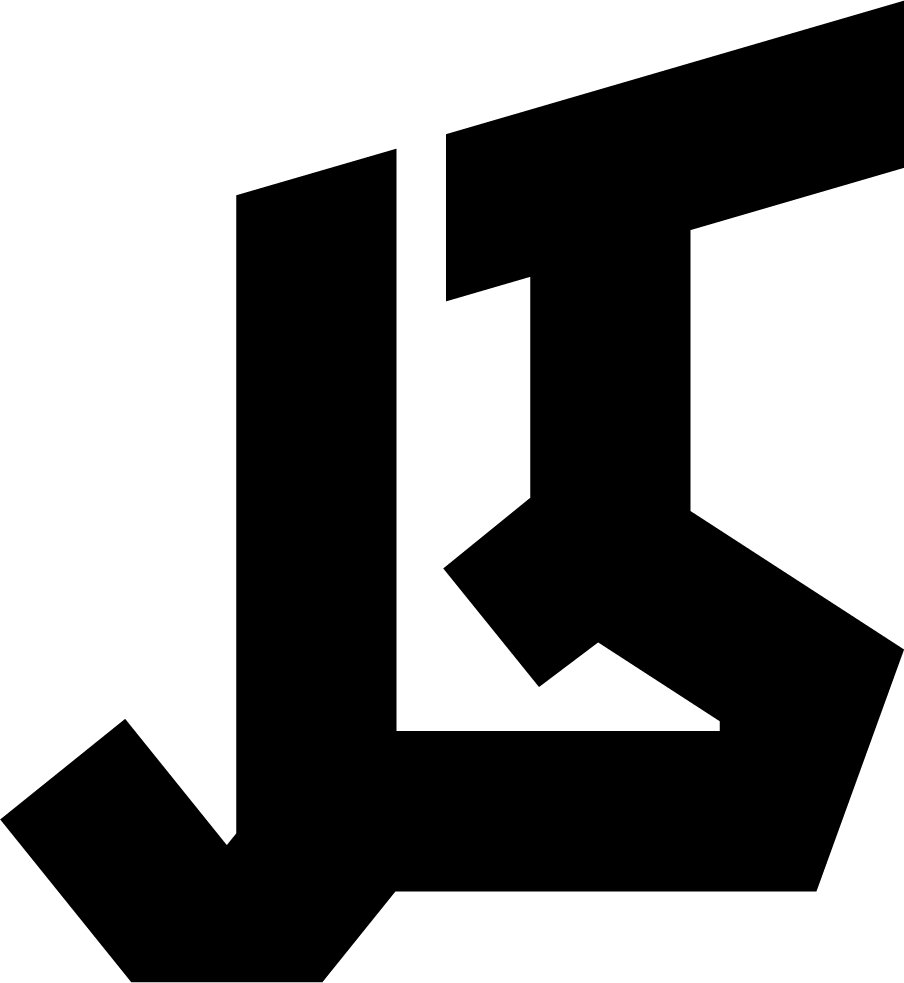في تشظّي الصهيونيّة: سيرٌ متعسّر في مساقٍ مستقيم
رياض الأيوبي دارس للاقتصاد وقارئ لحقول العمران والفلسفة واللغويات في تاريخ العرب، بادي البدء في ممارسته الترجمة لمّا عمل على نقل الأدبيات الشيوعيّة للعربية عبر صفحة «ما العمل؟» ومن ثمّ توسّع في هذا البحر من خلال تتبّع مخاض عمل شيوعيّي لبنان زمن الستينيات على نقل الإنتاج المعرفي من عالم الشمال إلى العالم العربي.
palestinians-in-lebanon.jpg
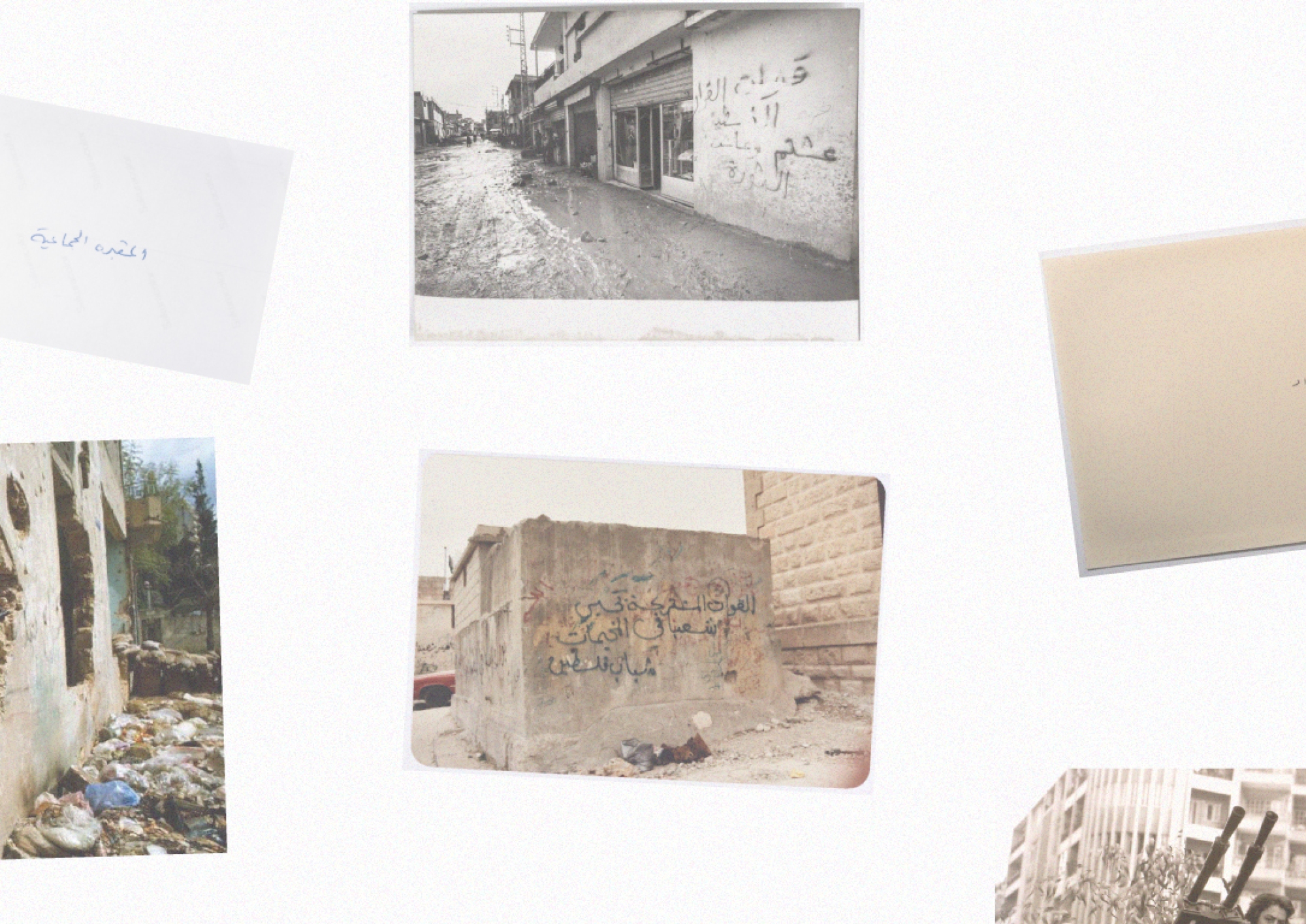
ملاحظة: سُطّرت هذه السطور في ذروة العمليّة المسمّاة "كاسر الأمواج"، بين سنتي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، في محاولة لتفكيك خرائط التصعيد التي رسمتها الحكومة الإسرائيليّة السابعة والثلاثون بعناية جارحة، وملاحقة أثر المنازلات الخطابيّة التي احتدمت حول عمليّتين نفذّتهما مجموعات مقاومة، لا تدين لأحد بالولاء الفصائلي، في الضفة الغربية.
لم يُنشر المقال لأسباب متعددة، من بينها عوائق مالية وإدارية، بالإضافة إلى الشلل الجماعي والارتباك الذي أثارته مجرد محاولة الإجابة على الاسئلة التي طرحها المقال والتي تكشّفت أجوبتها لاحقًا، بصيغة عمليات الإبادة المنظّمة التي تستهدف ما تبقّى من الكيان الفلسطيني المنظَّم في غزّة والضفّة الغربية – الابادة الجماعية ٢٠٢٣.
نمضي، ويا للمفارقة المريرة، كما اعتدنا، وفق الإيقاع الذي لا نخطّه نحن، بل يُملى علينا من ضفّة العدو. ومع ذلك، لا يتوقّف الفلسطيني المنظَّم، في أحيائه المكلومة ومخيّماته العصيّة، عن تذكيرنا بما يشبه البديهة: "سنظلّ هنا. فما البديل؟". وربما ذاك الموج الذي أرادوه كسيرًا، لا يزال قادرًا أن يحملنا، ولو على نحو آخر: لا من خلال بناء تحليليّ صلب، بل عبر تفكير متقطّع، ينجو بما تيسّر له من هواء بين قبضتي الليبرالية والحرب. هي هذه اللحظة المعلّقة، المتأرجحة بين الممكن والمستحيل، التي قد تفسّر لماذا، إلى الآن، يُكسر الموج بهذه السهولة، وكأنّه لم يُخلق ليعاند.
المقدّمة
عند أعتاب الإبادة، عام ٢٠٢٣، أعادة رئيس حكومة إسرائيل الخامس تلاوة تعويذة الهويّة التي نطقها بن غوريون، أباه المؤسّس، عام ١٩٥٥: "ليست إسرائيل جيشًا له وطن، بل وطنٌ له جيش" (على ما ورد في شلايم ٢٠٠٠:١١٢). لم تكن هذه العبارة مجرّد توصيفٍ عابر، بل مونولوغٍ إسرائيليٍّ، أو ربّما كان بمثابةِ استهلالٍ. هل إسرائيل دولةٌ خرجت من جلباب الاستعمار، تكابدُ لتجاوز تناقضاتها التكوينيّة؟ أم أنّها، في جوهرها، مجرد جهازٍ عسكريٍّ ينتحل صفة أمّة؟ هذه المسألة، بما فيها من توتّرٍ وتدافع، هي لبّ إشكالنا في هذا المقال، بل هي محوره وقطب رحاه: إسرائيل ذات الهويّة المزدوجة، فهي مضطهِد، وهي صورةٌ عاكسةٌ، تستثمر صدماتها التأسيسيّة في تبرير طغيانها التوسّعي. في هذه الحركة، لا تعكس إسرائيل ذاتها فقط، بل تعكس الشروط الموضوعية التي تنتج المشروع الصهيوني: من النيوليبرالية كمنظومة علاقات، إلى الرأسمالية العرقية كبنية على أسس إثنية، إلى الكفالة الإمبريالية التي لا تحضر كقوة خارجية، بل كشرط داخلي لإعادة إنتاج السيطرة. ولذلك، فإن اختزال إسرائيل إلى "عدوّ" يُقصي التحليل ويعيد إنتاج الأيديولوجيا. لا العداء يُفسّر، ولا الأخلاق تُنتج معرفة. إنّما الفهم يمرّ عبر تحديد موقع المستعمِر، وقراءة آليات العنف لا كحدث، بل كبنية قابلة للتعميم. إسرائيل مختبر استعماري في طور مبكر من تمفصل الحداثة مع أدوات السيطرة المعمّمة: حيث تُصاغ التصفية كسياسةٍ سكانية (وولف ٢٠٠٦)، وتُعاد هيكلة الدولة كجهاز جندريّ للانتماء القومي (شوحات ١٩٨٨)، ويُبنى الاقتصاد على منطق السلب باسم التحديث والتطوير (غوردون ٢٠١٨). لا يتفكّك هذا المشروع إلّا بتفكيك شروطه: لا بتمركز الخطاب حول الضحية، بل بتحليل التواطؤ البنيوي مع البنية الاستعمارية، لا بالموقف، بل بالموقع.
لا يروم هذا النصّ الإجابة عن السؤال الذي تُصاغ حوله معظم القراءات السياسية للكيان الصهيوني، أي سؤال "ماهيّة الدولة الإسرائيلية"، إذ إنّ صياغة هذا السؤال بصيغته الجوهرانية تُنتج الجواب قبل أن تُنتج المعرفة، وتُعيد إنتاج البنية الأيديولوجية ذاتها التي يُفترض تحليلها. فالوظيفة النظرية لا تقوم على تثبيت الكينونة بل على تحليل آليّات التكوّن، أي شروط الانتقال من المشروع الاستيطاني إلى تمأسس الدولة بوصفها جهازًا قمعيًا يُعيد إنتاج السيطرة. من هنا، لا يُقارب الكيان الصهيوني كـ"عدوّ" في ذاته، بل كبنية تتولّد عن تمفصلات تاريخية-اقتصادية، فالاستعمار الاستيطاني لا يشتغل في فراغ، بل في علاقة بنيوية مع الأنظمة التي سبقته، يُحاورها، ويعيد ترتيبها ضمن منطق السيطرة. وهنا تُصبح الحرب ليست فقط حدثًا عسكريًا، بل تمظهُرًا لحركة الجغرافيا داخل بنية السيطرة، إذ كلما اتّسعت طموحات الدولة، انغلقت البنية الاجتماعية على ذاتها، وأعادت إنتاج منطق الاستثناء والعزل. فالفصل العنصريّ، كما يقول إيفانز (١٩٩٧)، ليس فقط منظومة قانونية، بل منظومة إدراكية-أيديولوجية، تُنتج الواقع كما تُصنّفه. وفي هذا السياق، لا يمكن فهم لحظة ١٩٤٨ إلا باعتبارها لحظة تحوّل نوعيّ في البنية: حيث تمّ تهميش الكيبوتس، لا عبر صراع على الهويّة، بل نتيجة انتقال وظيفة الطلائعية من الشكل التعاوني إلى جهاز الدولة، الذي استوعب تدريجيًا مهام الاستيطان والضبط والتنمية والدفاع، أي المهام التي كانت تشكّل لبّ الأسطورة الاشتراكية الصهيونية. هكذا، ينكشف التناقض لا بوصفه فشلًا في تحقيق النموذج، بل بوصفه ضرورة داخل البنية، يُعيد ترتيب المواقع والمهام ضمن منطق السيطرة. والتحليل المادي لا يقرأ هذه التحوّلات بوصفها خيانة للخطاب، بل بوصفها تطوّرًا بنيويًا في جهاز السلطة، ينتقل فيه المشروع من الطوباوي إلى الأمني، ومن الخطاب إلى القانون، ومن الجماعة إلى الدولة.
إنّ التحوّلات التي أعقبت حرب عام ١٩٦٧ لا تُقاس بمقدار توسّع جغرافي فحسب، بل تُفهم من موقعها بوصفها لحظة في إعادة إنتاج البنية الاستعمارية نفسها، لا بوصفها احتلالًا عسكريًّا طارئًا، بل كجهازٍ سياسي-قانوني يعيد تنظيم الفضاء وفق منطق التوسّع القائم على تحويل الفوارق الاستعمارية إلى شكل قانوني. فالمستوطنة، بوصفها استحداثًا للكِيبوتس، لا تعبّر عن انقطاع رمزيّ في صورة الرائد الطلائعيّ (halutz)، بل عن استمرار وظيفيّ في شكلٍ إداريّ جديد، يُدرج الهيمنة ضمن منظومة مدنية تُخفي الفعل الاستيطاني وراء مبدأ المواطنة. غير أنّ ما يُعاد إنتاجه في هذا التحوّل ليس الشكل وحده، بل علاقة السيطرة ذاتها: فالمستوطن-المواطن لا يتحدَّد من داخل مفهوم "المواطنة" الليبرالي، بل من موقعه في جهاز التمييز الاستعماري، حيث يُعاد إنتاج الفارق بين "المواطن" و"المستوطن" كتمييز وظيفيّ لا يُلغى، بل يُدار عبر القانون بوصفه أداة تنظيم للسيطرة لا نفيًا لها. بهذا المعنى، فإنّ العلاقة بين "الاحتلال" و"المواطنة" لا تقوم على التعارض، بل على التمفصل. من هنا، لا يكون توصيف المستوطنة بأنّها "غير شرعيّة" سوى إعادة إنتاج لخطاب قانونيّ يفصل بين القانون والسيطرة، ويُخضع الاستعمار لمعيار الشّرعية بدل أن يُفكّك بُنيته. إنّ تحليل هذه العلاقة لا يمرّ عبر توصيف المراحل، بل عبر الكشف عن كيفيّة عمل جهاز الدولة الكولونيالية.
هذه التحوّلات في بنى الأرض والمواطَنة والهويّة لا تشكّل مسارات متوازية، بل لحظات متداخلة في جهازٍ واحد، حيث لا تُفهم العلاقة بينها من داخل سرديّة التقدّم الخطي، بل من موقعها كتناقض فعّال يُنظّم البنية بوصفه وظيفتها. هنا لا تعمل الدولة الصهيونيّة وفق منطق الاستمرارية التاريخيّة، بل بوصفها تمفصلًا بين أزمنة متناقضة يُعاد فيها استحضار ما قبل ١٩٤٨ – كمنطق فتحٍ واستيطان – لا كذاكرة، بل كجهازٍ يُفعَّل في الحاضر. هذا ما يُنتج المفارقة الزمنيّة التي تُشكّل شرط اشتغال الدولة: فهي تُقدّم ذاتها كمشروع حديث، صناعيّ، دينيّ، داخل حدود معترف بها، في حين تُمارس فعليًا منطقًا سياسيًا سابقًا على الدولة نفسها، يُعيد إنتاج العلاقة مع الجغرافيا كعلاقة غزو لا كعلاقة قانون. وفي هذا التمفصل الزمنيّ تُعاد صياغة الأدوار الاجتماعية والجندرية، لا بوصفها نتاج ضرورة مادية فحسب، بل كمواقع أيديولوجية. فالموقع الجندريّ لا يُنتج خارج الجهاز بل فيه، ويتحرّك بين زمنَين: زمن دولة القانون وزمن المشروع الاستيطاني، دون أن يُوحِّد بينهما. هكذا لا تتشكّل الجغرافيا كوحدة وطنية، بل كشبكة من الفضاءات المجزأة، حيث يُعاد إنتاج الهيمنة عبر مفارقةٍ زمنية تَحكمها الوظيفة، لا التسلسل، ويُدار التناقض فيها بوصفه شرطًا ضروريًا لاستمرار البنية، لا بوصفه خللًا فيها.
إنّ ما يُشار إليه بـ"ثورة الكيبوتس الصناعية" (فوجيل-بيجاوي ٢٠٠٧) في سبعينيات القرن العشرين لا يُمثّل مجرّد تحوّل في شكل التنظيم الاقتصادي، بل يشكّل لحظة مفصلية في الانتقال إلى صيغة دولة حديثة. هذا الانتقال لم يُنهِ الوظائف الجندرية في البنية، بل أعاد إنتاجها على نحو يسمح بدمجها كشرط من شروط استمرار الهيمنة، لا بوصفها فارقًا بيولوجيًا، بل بوصفها موقعًا يُدار فيه التناقض بين الاستعمار والمجتمع. إذ لم تُنتج "المرأة المستوطنة" بوصفها فاعلًا في صراع تحرّري، بل كوحدة أيديولوجية تضطلع بوظيفة مزدوجة: من جهة، إعادة ترسيخ البنية الإثنية للمستوطِنين من خلال إعادة تموضع الأدوار الإنجابية كوظيفة إثنية؛ ومن جهة أخرى، إدماجها في سوق العمل والتعليم بما يخدم التوسع المدنيّ للطبقة الوسيطة. إنّ ما يبدو كصراع داخلي بين تقليد وحداثة ليس إلا الشكل الأيديولوجي الذي يُدار من خلاله التناقض الطبقي-الجندري، لا بوصفه خللًا في البنية بل بوصفه آلية لإعادة إنتاجها. وما يُسمّى بـ"التحوّل الجندري الاستعماري" ليس انتقالًا، بل هو لحظة داخل السيرورة البنيوية التي تُحوّل التناقض إلى وظيفة، وتُقنن الجندر بوصفه نمطًا من أنماط الانضباط الاجتماعي، لا التمرّد عليه.
يشكّل التقسيم الجندري للعمل أحد المحرّكات الأساسية للتحوّل الاقتصادي الذي تتطلّبه ولادة الطبقة الوسطى الحديثة، وهي طبقة تُبنى على التمايز الوظيفي ضمن البنية. غير أن هذا التكوّن الطبقي-الجندري لا يحدث بشكل خطّي، بل يتّخذ مسارًا لا-تماثليًا، تُعيد الدولة من خلاله توزيع الوظائف بحسب موقع الجماعات داخل البنية الجغرافية-السياسية للسيطرة. فمع تشكّل الدولة-الأمة، تُفَعَّل آليات الفرز والتمايز، لا لتجاوز الفوارق، بل لتثبيتها كقانون إداري-أمني يُنتج الانقسام بوصفه شرطًا للتماسك السلطوي. في هذا السياق، لا تُرسَّخ الهيمنة العرقية كخطاب، بل كآلية تنظيمية، يُدار عبرها التهجير السكاني (الترانسفير) كسياسة ديموغرافية ممنهجة. أما المستوطنات والكيبوتسات، فتبقى جزءًا لا ينفكّ من مهامّ التوسّع، حتى حين يُعاد دمجها ضمن مسار التحديث المؤسّسي-العسكري للدولة، الذي لا يُبطل منطق الاستيطان، بل يُعيد إنتاجه في شكل قانوني-مؤسّسي. بذلك، يتحوّل ما كان يُعتبر "نقلًا" بسيطًا من تخوم زراعية إلى مراكز مدينية، ومن استيطان "غير شرعي" إلى آخر "شرعي"، إلى بنية تراتبية مندمجة داخل نموذج الدولة-المتروبول، حيث تُمارس السلطة لا من المركز فحسب، بل من خلال إشعاع غير متكافئ يُنَظِّم التفاوت ويُثبّته بوصفه ضرورة بنيوية.
ضمن هذا التشكيل، لم يعد الانقسام الثنائي بين اليهودي وغير اليهودي كافيًا لحمل عبء التماسك القومي. إذ بات ما يُسمّى "الوحدة الوطنية" يعتمد على شبكة أكثر تعقيدًا من الهويات والأدوار، والأهم من ذلك: من أنماط الإقصاء المؤسّس. هكذا، لا تعود المستوطنات والمستوطنون فحسب تجسيدًا للمشروع الاستيطاني، بل يتّخذون تموضعًا زمنيًا خاصًا، يتكامل ظاهريًا مع زمن الدولة، لكنه يتمايز عنه في البنية والوظيفة. أي أنّ زمنَين متناقضَين يمكن أن يتزامنا داخل الحاضر الواحد، من دون أن يتوحّدا، عبر جغرافيا مشرذمة بفعل ترسيم نفعيّ تُديره البنية العسكرية. هنا، لا تنتج الدولة الزمن بل تُنظّم تشظّيه، وتُحوّل التناقض الزمني إلى أداة إضافية لتثبيت السيطرة على الحيّز والسكان معًا.
في هذا النص، سأركّز على التصعيد الأمني الذي وقع في منتصف عام ٢٠٢٢، باعتباره لحظة مفصلية في التشكّل الإيديولوجي المتواصل للدولة الصهيونية، وخصوصًا في تزامنه مع التظاهرات التي اندلعت في الداخل الصهيوني كما في الضفة الغربية. فلا يُعالج هذا النص الحدث كظرف، بل كعُقدة خطابية تُنتج داخل بنية استعمارية-استيطانية تُعيد، باستمرار، تنظيم العلاقة بين العنف والشرعية. بهذا المعنى، تُفهم الحرب لا كقطيعة، بل كسيرورة خطابية تُؤسّس الثنائية الإيديولوجية للقوة والهشاشة، في صيغٍ تتبادل فيها الدلالات الجندرية الوظائف دون أن تنفي أثرها البنيويّ. ومن موقع الوعي بأن الخطاب نفسه شكلٌ من أشكال السلطة، يتّخذ هذا النص من حادثة ٧ نيسان ٢٠٢٢ في غور الأردن مدخلًا لتحليل آلية إنتاج الحرب في اللغة، لا بوصفها تسمية لحدث، بل كممارسةٍ لإعادة ترتيب الحقل السياسيّ.
عسكَرَة الوعي، وأزمة المواطنة في الراهنيّة الصهيونية
لنبدأ بما هو معلومٌ سلفًا، محفور في بنية كلّ إمبراطورية-بنية استعمارية حديثة: إنّ إسرائيل ليست استثناءً. لا تقع خارج منطق المتروبول، بل تُعيد إنتاجه بصورة لصيقة، حيّة. ما يميّزها ليس تفردها، بل اقترانها الزمنيّ: العيش في الحاضر بوصفه وعد الحداثة، وفي الماضي بوصفه صيرورة من الغزوات. في هذا التداخل الزمني، لا يكون الكيان استثناءً استعماريًا، بل نصًّا حيًّا يُفَسِّر تحوّلات السلطة الاستعمارية في القرن العشرين، حين أُلبِس الاستمرار ثوب القطيعة، وسُمِّي التراكم التاريخي "ما بعد الاستعمار". ليست إسرائيل انقطاعًا عن الإمبراطورية، بل مثالها المتأخّر، حيث تتجاور بنية ما قبل الدولة مع مؤسسات الدولة الحديثة، لا كمفارقة، بل كضرورة.
لكن اقتران الحاضر بالزمن المؤسِّس ليس محض سمة بنيوية، بل مكمن ضعفٍ بنيويّ، يظهر في مواجهة مقاومة فلسطينية متجذّرةٌ في فعلها التاريخي: نقض وهم الاستقلال الزمنيّ للدولة عن أصلها الاستعماري. فالعسكرة والميليشياوية تنشآن داخل بنية واحدة، تربط بينهما علاقة جدلية: كلّ منهما يُعيد تشكيل الآخر ضمن شروط مادية محددة. ومع ذلك، يختلف تموضع كلٍّ منهما داخل الخطاب، لا من حيث الشكل، بل من حيث الوظيفة الطبقية والانفعالية والاجتماعية التي تُحدّد بنيته. هذا التمايز يتجسّد بوضوح في عملية جندرة الهويات الأمنية، وخصوصًا هوية المستوطن، حيث تُدرج الميليشيا داخل الحيّز الأسري وتُعاد صياغتها كجزء من منظومة تقسيم الأدوار الجندرية، فتتحوّل العسكرة إلى وظيفة أُسرية لا تُناقض البنية، بل تُعيد إنتاجها من داخلها.
إن مساءلة معنى الجندر داخل مجتمعٍ مؤسّس على العسكرة الوظيفيّة، هي مدخلٌ لفهم وظيفة الميليشياوية في مشروع الدولة-الأمة. فالعسكرة لا تُختزل في البنية الأمنية، بل تشكّل منطقًا إنتاجيًّا للدولة نفسها، تُعيد من خلاله صياغة الوعي، وتُحمّل الذات أخلاقيات الانضباط بوصفها قيمة وطنية. هكذا لا تكون العلاقة بين الدولة والعسكرة علاقة أداة وسلطة، بل علاقة تكوينٍ متبادل. والعسكرة، بوصفها منطقًا اقتصاديًا، تنعكس في موازنة الدولة، لا كمجرد إنفاق عسكري، بل كآلية تُعيد إنتاج شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الخاضع، سواء داخل "الحدود القومية" أو في هوامشها المستعمرة. فالتكنولوجيا، والخطط الاستراتيجية، والخطابات الأمنية، كلّها تتوسّط العلاقة بين الأمة والعسكرة، وتعيد تشكيل ما يبدو مدنيًا بوصفه عسكريًا مقنّعًا. وفي كلّ ظرف – حربًا كانت أم "سلامًا"، أزمة داخلية أم طارئًا صحيًا أو بيئيًا – تظلّ وظيفة العسكرة ثابتة: إدارة السكّان، ضبطهم، وإعادة إنتاجهم وفق منطق السيطرة.
إن هدف العسكرة، ووسيلتها في آنٍ معًا، هو كوكبةٌ من التمايزات الطبقية والهوياتية داخل المجتمع، لا كوقائع قائمة بذاتها، بل كآليات تُستخدم لإعادة إنتاج العلاقة بين الوعي الاجتماعي – بوصفه مشروطًا ببنيته الطبقية – والبنية الفوقية للدولة، بما هي التعبير المؤسسي عن الإرادة البورجوازية. إن هذه التمايزات، حين تُوظّف داخل منطق العسكرة، يُعاد تشكيلها بما يخدم الوظيفة الأيديولوجية للمؤسسة العسكرية، فتُصبغ بالصفة المؤسسية التي تُمأسس الانضباط وتُعيد توجيه الذوات داخل حدود الطاعة السياسية. هنا يتحدّد الجندر لا كهوية بل كوظيفة، أي كأداة لإعادة تشكيل وعي المواطن الإسرائيلي المُفترَض، في مرحلة ما بعد الصهيونية، بوصفه فردًا خاضعًا لمنطق الدولة-الأمة عبر جهازها العسكري. إن الميليشياوية، بهذا المعنى، لا تمثّل خروجًا على الدولة، بل تجسيدًا لأيديولوجيتها تحت-دولتيًا، عبر تكريس نمط من الذوات المُعسكرة. وهذا ما توضحه قراءة أغاسي (١٩٨٩) حول موقع الجندر في الكيبوتس، حيث لم يُمحَ الطابع الجندري للاستيطان في المرحلة النيوليبرالية، بل أُعيد إنتاجه بأدوات جديدة. فالحرب، بما هي فعل إعادة تنظيم، تُعيد باستمرار تشكيل فاعليها، وعلاقاتهم، ووظائفهم، وهذه هي بالضبط ما سمّته النظرية النسوية "استمرارية الحرب" (war continuum).
بحسب سينثيا كوكبورن (٢٠٠٤)، لا تُفهم الحرب كفعل عنف مباشر فحسب، بل كبنية دائمة تتوسّطها المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُعيد إنتاج منطق العسكرة في الحياة اليومية. وفي السياق الاستعماري الاستيطاني، يتّخذ هذا المنطق طابعًا مضاعفًا من حيث التعقيد، حيث تعمل الدولة القومية على إعادة تشكيل المجتمع عبر آليتين مترابطتين: التوسّع الاستيطاني والاحتلال العسكري. هاتان القوتان، على الرغم من تكاملهما البنيوي، تُنتجان أحيانًا تباينًا في الإيقاع والوظيفة، يظهر كتوتّرٍ بين مسار التمدّد وموقع السيطرة. هذا التباين لا يُنفي وحدتهما، بل يُؤكّد ما ذهبت إليه كوكبورن من أن الحرب لا تُقابل السلام، بل تُمارَس كاستمرارية، كحالة متحوّلة تُنظّم الانتقال بين أشكال الهيمنة. من هذا المنطلق، تتحوّل الحرب إلى أداة لإدارة التحوّل الاجتماعي وإعادة ترتيب التشكيلة الاجتماعية في اللحظات التي تسعى فيها السلطة إلى تثبيت نظامٍ جديد من السيطرة، لا بالقطيعة، بل بإعادة تأهيل البنية نفسها. إعلان الحرب، في هذا السياق، لا يعني الانفجار، بل يعني إعادة ضبط الإيقاع – لا تحقيق الخلاص، بل تثبيت نمط جديد من الهيمنة.
في جغرافيا فلسطين التاريخية، ولا سيما داخل تخوم ما فُرض تسميته بـ"فلسطين الانتدابية"، لا تنتظم العسكرة ضمن مسار زمني خطي، بل تتوزّع على تشكّلات متعدّدة تُعيد إنتاجها باستمرار. فالعنف الإبادي المرتبط بالبنية الزراعية لا ينتمي حصريًّا إلى لحظة الدولة القومية، بل يُمارَس خارجها وداخلها، بوصفه شرطًا تأسيسيًّا لتحقّقها. وما يُسمّى بـ"تصنيع الحياة الزراعية" قبل ظهور مؤسسات الدولة، إنما يمثّل البنية التحتية لإنتاج الميليشياوية كبداهة، لا كاختيار. هذه البداهة ليست وعيًا حياديًّا، بل هي شكل خاص من إعادة إنتاج الهيمنة في الوعي، تُنتج وعي المستوطن كذات تاريخية تُدجَّن داخل منطق التوسّع، لا كمجرد تابع للمؤسسة العسكرية، بل كفاعلٍ يُنتج ذاته بوصفه تجسيدًا لمشروع الدولة. هنا، تتحوّل المستوطنة إلى جهاز أيديولوجي للدولة، تُصنّع من خلاله صورة "المواطن البطل"، ذلك الذي يُعاد تشكيله عبر آلية تموضع داخل خطاب التفوّق: من "الإنسان الأدنى" (Untermensch) إلى "الإنسان الأعلى" (Übermensch)، بحسب ماير (٢٠٠٠). إلا أن هذا التمثّل البطولي لا يقوم على فراغ، بل يُبنى فوق عمل الفلسطينيين الذين، تحت شروط الرقابة القصوى والتجريد من الحقوق، يشكّلون قاعدة إعادة إنتاج السوق النيوليبرالية الصاعدة. في هذا الترسيم الوظيفي للعلاقة مع المُستعمَر، لا تمثّل "الصهيونية الجديدة" انقطاعًا بل استمرارًا، لا كتطوّر، بل كمناورة خطابية تُعيد عبرها الدولة إنتاج بنيتها من خلال نقل التوسّع من الكيبوتس إلى الدولة، ومن المستوطن إلى المواطن، ومن الإبادة الزراعية إلى السحق الحضري للشعب المستعمَر.
إن الحرب، في منطق الدولة الصهيونية، ليست حادثًا طارئًا، بل شكلٌ من أشكال انتظامها البنيوي؛ إنها ليست لحظة عسكرية محدّدة، بل نمطٌ لإعادة إنتاج السيطرة ضمن شروط اجتماعية متحوّلة. فليست الغارات ولا المدافع هي التي تُحدِّد طبيعة التصعيد العسكري، بل تَسرُّب العنف إلى اليوميّ، إلى عبور الجسد الفلسطيني في الضفة، إلى الانتظام القسري للحركة في محيط غزة، إلى الحاجز بوصفه مسرحًا لا لضبط الأجساد فقط، بل لإنتاجها كأجساد مُراقبة-وظيفية. بهذا المعنى، يُعاد بناء العنف كممارسة إدارية، لا عسكرية فحسب، ويُعاد إنتاج الحرب كوسيط دائم بين الدولة والمُستعمَرين.
وحين تغيب الحرب بوصفها قصفًا، لا تغيب بوصفها بنية؛ فاللا-حرب ليس إلا طورًا آخر من الحرب. وفي هذا الطور، يظهر التناقض في قلب المشروع الاستيطاني نفسه: إذ تنكفئ الجماعة المستوطِنة إلى داخلها، فتنكشف بنيتها كتركيبة مأزومة، محكومة بمنطق السوق من جهة، وبهاجس التركيب الديموغرافي من جهة أخرى. هنا، يُعاد تعريف "المواطن المستوطِن" كذات غير مكتفية بذاتها، بل كذات لا تكتمل إلا بوجود دائم للمستعمَر بوصفه تهديدًا. وبذلك، لا يكون "الهدوء" لحظة سلام، بل لحظة أزمة بنيوية في إنتاج الدولة ذاتها كإيديولوجيا، أي في قدرتها على التخييل السياسي لوحدتها. وتنكشف هذه الدولة، في لحظات اللا-حرب، كدولة لا تستطيع أن تتواجد دون حرب، لأنها لا تملك بنية داخلية مستقرة، بل تقوم على ديمومة التوسّع كمصدر وحيد لوحدتها.
فـ"المواطنة" في إسرائيل لا تُدرَك كمُعطى قانوني متكامل، بل تُنتَج كحالة قلق مؤبّد، بوصفها شكلًا أيديولوجيًا لتخييل الوحدة. فهي لا تقوم على شروط الوحدة التاريخية، بل على التماثل مع مؤسّسة القسر ذاتها؛ إذ يُعاد تشكيل "الجماعة المتخيَّلة" لا بوصفها شعبًا، بل بوصفها امتدادًا وظيفيًّا مباشرًا لجهاز الدولة الأمني، حيث لا يُصان الانتماء إلا بقدر ما يُعاد إنتاجه ضمن شروط العنف.
المشهد
ليس المخيم – في جنين – مجرد جغرافيا للاشتباك، بل هو البنية المتبقية – وربما الوحيدة – التي لم تنخرط بعد في مشروع إعادة إنتاج السيطرة، لا من قِبَل الدولة الاستعمارية وحدها، بل من قِبَل السلطة التابعة كذلك. فمنذ الانتفاضة الأولى، والمخيّم لا يؤدي دوره بوصفه مساحة رفض، بل بوصفه نفيًا دائمًا للوظيفة التي أرادها له التنسيق السياسي-الأمني المشترك بين الاحتلال وبُناه الوكيلة. وفي هذا النفي، تتجلّى دلالته السياسية: لا كرمز، بل كعائق ماديّ-تنظيمي أمام مشروع إخضاع الأرض والناس تحت شروط السوق والاستقرار الأمني.
لقد فشل الاحتلال في تصفيته، كما فشل جهاز السلطة الأمنية في احتوائه، لا لعجزٍ في القوة، بل لأنّ ما يُستهدف هناك هو التنظيم الذي لا يخضع لبنية التنسيق الأمني، ولا يُعيد إنتاج ذاته كذراع محلّي للسيادة. المخيم، بوصفه بنيةً مقاومة، ليس بديلاً عن الدولة، ولا مشروعًا خارجها، بل هو تعبير عن استحالة دمج ما لا يمكن دمجه: الرفض المنظّم ضمن شروط الهيمنة الطبقية. من هنا، لا يُمكن تصفية المخيم دون تصفية فكرة التنظيم المقاوم نفسها؛ وهذه هي معضلتهما معًا – الاحتلال وسلطته التابعة.
بين كانون الثاني ونيسان من عام ٢٠٢٣، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من العمليات العسكرية تحت مسمّى "أمني"، تصفية ممنهجة لقيادات فلسطينية شابة، بعضها منخرط في العمل المقاوم، وبعضها الآخر بلا انتماء تنظيمي، في ما بلغ عدده ثمانين شهيدًا خلال ثلاثة أشهر. هذه التصفية لم تكن استثناءً في منطق الدولة، بل ضرورة لإعادة إنتاج جهازها بوصفه احتكارًا للعنف المشروع، بما يضمن استباق إمكان التنظيم كفعل سياسي داخل البنية الاستعمارية. وفي موازاة الاغتيال، لجأت السلطة إلى تفكيك البنية الاجتماعية المحيطة بالمناضلين، عبر هدم منازل عائلاتهم، وملاحقة أقربائهم، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني. وفي هذا الوقت بالذات، كانت جموع "المواطنين" الإسرائيليين1 تملأ الشوارع، ليس رفضًا للقتل، بل احتجاجًا على مشروع حكومة نتنياهو الرامي إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا. وكان مشروع الحكومة، المتشكّلة في كانون الأول ٢٠٢٢ من تحالف يميني-ديني-فاشي، يتمحور حول إعادة تنظيم علاقة السلطات عبر تمكين البرلمان من تعيين القضاة، ومنع المحكمة من إلغاء قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.2
إن حاجز حوّارة، الواقع شمال الضفّة الغربية وجنوب نابلس، ليس مجرّد نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، بل هو تجلٍّ مكثّف لوظيفة السيطرة المكانية كأداة بنيوية لإعادة إنتاج الهيمنة الاستعمارية. يقع الحاجز على شارع ٦٠، الذي يشكّل شريانًا حيويًا يربط المدن والبلدات الفلسطينية، لكن أهميته لا تكمن في موقعه الجغرافي فحسب، بل في موقعه ضمن البنية الأمنية-الاقتصادية للدولة الاستيطانية. لقد أُنشئ حوّارة كجزء من شبكة الحواجز التي تحكم الحركة في الضفة المحتلة، لكنه وُظّف منذ البداية لتنظيم عبور فئة محدّدة: الطبقة العاملة الفلسطينية. بهذا المعنى، لا ينظّم الحاجز "الأمن"، بل ينتج اختناقًا مقصودًا، يستهدف بالدرجة الأولى إمكانية العيش، ويُحوّل الحياة اليومية إلى عبور قسري تحت شروط السيادة العسكرية. ومع تطوّر البنية التكنولوجية للدولة، صار الحاجز موقعًا لتجريب أدوات المراقبة والتحكم، من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الرقابة المعلوماتية، في ما يُعيد تعريف العلاقة بين الاحتلال والعمل، لا بوصفها استغلالًا مباشرًا فحسب، بل بوصفها تطبيعًا للتبعية عبر وسيط تكنولوجي يمأسس الإخضاع. هكذا، يتجاوز الحاجز بُعده الوظيفي المباشر، ليصبح آلية بنيوية تُعيد إنتاج الطبقية الاستعمارية تحت غطاء "الإدارة الأمنية"، وتُكرّس الفصل المكاني، التبعية الاقتصادية، واستمرارية البنية الاحتلالية بصيغتها المعولمة.
يتجلّى الأثر العينيّ لحاجز حوّارة في حياة سكان المخيّمات الفلسطينية المجاورة، كمخيّم بلاطة، ومخيّم عسكر، وعين بيت الماء، الممتدّة ضمن نطاق لا يتعدّى الثمانية كيلومترات عن موقع الحاجز. لا تُقاس العلاقة هنا بمسافة جغرافية، بل ببنية علاقة تعيد إنتاج اللجوء كحالة مستدامة، لا كمجرد حدث تاريخي وقع عام ١٩٤٨. فالمخيّم، بوصفه نفيًا للمدينة، يتقاطع مع الحاجز، بوصفه نفيًا للطريق: كلاهما من بنى السيطرة، وكلاهما ينتج شكلًا مخصوصًا للزمن الفلسطيني، زمن العبور المؤجّل.
وإن عبور الحاجز ليس مجرد فعل تنقّل، بل ممارسة خضوع. فالمرور للعمل، للدراسة، أو للعلاج، إنما هو إعادة تأكيد موقعٍ في التراتبية الاستعمارية. بذلك، يصبح الحاجز آليّة تراكم وظيفي، حيث تتقاطع البنية العسكرية مع التكنولوجيات الأمنية الحديثة، لإعادة إنتاج الفارق الطبقي بين العامل واللاجئ، بين العابر والممنوع، بين من يُسجَّل ومن يُراقَب.
بهذا المعنى، لا يُختزل حاجز حوّارة في وظيفته المباشرة، بل يُدرك كنقطة تبلور لعنف بنيوي مركّب، يحكم العلاقة بين اللاجئ والمنفى، بين العامل والعمل، بين الجسد الفلسطيني والمؤسسة الاستعمارية. إنه ليس فقط حارس الفصل، بل مهندسه؛ لا يفرض العزل فحسب، بل يصنعه بوصفه علاقة إنتاج، تعيد إدماج اللاجئ في سوقٍ اقتصادي-أمني لا يتحرّك إلا بآلة القمع، ولا يُدار إلا بلحظة الاحتلال الممتدة زمنيًا خارج الحرب.
في إدراكي، يمثّل حاجز حوّارة ذروة درامية لصراعٍ خطابيّ تدور رحاه بين مؤسّسات سياسيّة متنافسة، تدّعي، من موقعها في الدولة الصهيونيّة، السعي نحو أفق ما بعد استعماري، يُفترض أنّه يتوّج طوراً ما بعد صهيونيّ من تشكّل الدولة القوميّة.3 غير أنّ هذا الادّعاء لا يُخفي ما يتواصل كركيزةٍ بنيويّة: ممارسة استعماريّة استيطانيّة لم تنقطع، بل يعاد إنتاجها ضمن بنى الدولة القائمة. يمتدّ هذا التنازع الإيديولوجي ليبلغ أقصى مستويات القرار في الحليف الإمبرياليّ الأوّل لإسرائيل، أي الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث يتحوّل إلى موضع تفاوض بين القوى الدوليّة، والحكومة الإسرائيليّة، ومعارضتها. في جوهر هذا الصراع، تُصاغ ثنائيّة بين العار والأخلاق، تتجلّى خصوصًا في تضادّ الأدوار المنوطة بكلّ من المستوطن الإسرائيلي، بوصفه فاعلاً سياسيّاً وإيديولوجيّاً، وبين الجيش كمؤسّسة قانونيّة تطبّق القوّة. هذه الثنائية ليست بريئة، بل تُستثمر داخل جهاز الدولة الأيديولوجيّ وتُسقط على آلياتها البنيويّة المتكيّفة مع متطلّبات الطرد، التهجير، إعادة التوطين، الأمننة، والتحكّم الحيويّ (biopolitical) بالسكان. يشكّل كلٌّ من التجمعات الاستيطانيّة وجهاز الدولة العسكريّ ما يمكن تسميته بـ"الجسدَين الناظمَين" لتجسيد هذه الثنائيّة وإعادة إنتاجها. والطريقة التي يُعاد فيها تأكيد هذه الثنائيّة أو زعزعتها داخل الخطاب اليوميّ للمجتمعات الإسرائيليّة تفترض مقاربةً تحليليةً جندريّة، ستكون موضوع القسم التالي.
أركان الخطاب: متطلّبات القوميّة والمظلوميّة
في السادس والعشرين من شباط/فبراير ٢٠٢٣، قُتل مستوطنان إسرائيليّان في عمليّة إطلاق نار بالقرب من حوّارة الفلسطينيّة، على الطريق ٦٠. تُفيد الروايات بأنّ إطلاق النار وقع بعد تصادم بين مركبتَين، الأمر الذي يتكرّر، لا من حيث الظرف الأمنيّ فحسب، بل من حيث بنيته الرمزيّة والسياسيّة: تصادُم مادّي يكشف تصادماً بنيويّاً. ففي السابع من نيسان/أبريل، تكرّر المشهد ذاته في غور الأردن، حيث قُتلَت مستوطِنتان، أيضًا بعد حادث سير أعقبه إطلاق نار. ليست المصادفة هنا سوى قناع لنسق يتشكّل داخل فضاء استعماريّ محكوم بمنطق الاحتلال، حيث تتكرّس علاقة القوّة من خلال عنفٍ يعيد إنتاج ذاته على هيئة صدامات يوميّة. في الحالتَين، يتكرّس نمطٌ من المقاومة، لا تكون بها المواجهة حدثًا طارئًا، بل تعبيرًا عن احتدام التناقضات داخل البنية الاستعماريّة التي تُعيد تموضعها في كلّ لحظة تصعيد.
عقب حادثة السابع من نيسان/أبريل، اعتلى رئيسُ الحكومة الإسرائيليّة منصّة الخطاب، لا بوصفه ناطقاً باسم الحداد، بل بوصفه مُمثِّلاً لجهازٍ أيديولوجيٍّ يُعيد إنتاج الحرب بوصفها ضرورةً وجوديّة. فبينما امتدّ مؤتمره الصحافيّ على مدار ساعة، بدت كلماته تُعيد تموضَع الألم في سياقٍ مُهيكل. لم يكن الربط بين الهجوم والمقاومة الفلسطينيّة فحسب، بل وُسِّع الإطار ليتّسع لـ"العدوان الإيراني" و"إرهاب حماس" و"التهديد" الذي يُمثّله الفلسطينيّ في ذاته – كذاتٍ داخليّةٍ في الجغرافيا الإسرائيليّة وكموضوعِ قمعٍ في الضفّة الغربيّة. هكذا يُعاد إنتاج الفلسطينيّ لا بوصفه خصماً، بل بوصفه تهديداً كينونيّاً. غير أنّ هذه البنية الخطابيّة لا تتّسم بالتماسك بل بالانتقائيّة: فبينما جرى تصنيفُ هجوم نيسان بوصفه "عملاً إرهابيّاً" موجَّهاً ضدّ الدولة، لم يُمنَح الهجومُ المماثل في شباط الوصفَ ذاته، وهو ما يُضيء على الطابع الأداتيّ للخطاب الأمنيّ – حيث يُنتقى "الإرهاب" بوصفه تصنيفاً لا توصيفًا لوقائع ماديّة، كآليّاتٍ لإنتاج سرديّات استعماريّة جندريّة تُعيد تشكيل السرديّة الاستعماريّة وتُرسّخ بُنى السيطرة، عبر التمييز بين ما يُحتسب فعلاً قابلاً للتأريخ وما يُلغى من حقل الدلالة.
برز التباين في تمثيل القتلى كذلك في اختلاف الصياغة الصحافيّة، التي تُعيد إنتاج ما تُخفيه، عبر ما تُظهره. ففي حادثة ٢٦ شباط/فبراير، قُتل مستوطنان، شقيقان، وفي ٧ نيسان/أبريل، قُتلت مستوطِنتان، شقيقتان. إلا أنّ التغطية الإعلاميّة، كما تجلّت في عناوين كلٍّ من بي بي سي، وسي إن إن، وهآرتس4 – وهي ثلاث وسائط تخاطب الوعي الليبرالي في العالم باسم "الموضوعيّة" – لم تتعامل مع الضحايا كفواعل استيطانيّة. لقد تحوّلت الشقيقتان إلى مجرّد "نساء"، يحملن صفةً مزدوجة، "بريطانيّة-إسرائيليّة"،5 بينما انمحى موقعهنّ المادّي كفاعل استيطاني في منظومة الاحتلال. ففي حين استخدمت سي إن إن، يوم ٢٦ شباط، تعبير "مستوطنَين إسرائيليَّين"،6 جاء عنوان هآرتس "مقتل إسرائيليَّين اثنين في حوّارة"،7 وفي يوم ٧ نيسان: "مقتل شقيقتَين إسرائيليّتَين-بريطانيّتَين"، واختارت بي بي سي لذلك اليوم عبارة "امرأتان بريطانيتان-إسرائيليتان تُقتلان في إطلاق نار".8
العنوان، لا يصف الحدث، بل يُنشئ له وعيًا؛ لا يكتفي بالإحالة على واقع، بل يصوغه كوعيٍ يُراد له أن يُؤسَّس. فالضحيّتان، كما قُدّمتا في الخطاب الإعلاميّ العالميّ، لم تُنظَر إليهما كفاعلَتين استيطانيّتين، بل كـ"نساء"، ثمّ، في الخطاب المحليّ الإسرائيلي، كـ"شقيقتَين"، أي كوحدة أُسريّة تُحمّل وظيفة إعادة إنتاج الأمّة. كان لا بدّ، إذًا، أن تتّخذ التغطية الإعلاميّة الإسرائيليّة، كما في "هآرتس"، شكلَ التعبئة: نداء من مفوّض شرطة المستوطنة إلى "كلّ مواطنٍ يمتلك سلاحًا مرخّصًا ويُجيد استخدامه قانونًا، أن يحمله".9 وهنا تُكشَف دلالة المستوطِنة: لا كذاتٍ فرديّة، بل كحالةٍ استثنائيّة، كنداءٍ للأمّة، كجسدٍ مُجنّس، هويّته مزدوجة (بريطانيّة-إسرائيليّة)، يستدعي تعبئة شاملة لأجهزة الدولة. هي الذكرى الحيّة للـ"عليا"، أي للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين التاريخيّة، وللشبكة الجيوسياسيّة العابرة للحدود والحاضرة في الحدث. أمّا مقتل الأخوَين، فلم يستدعِ، لا في التغطية الإعلاميّة ولا في الخطاب السياسيّ، التمثيلَ الجندريّ نفسه. لم تُستحضَر "الأسرة" كوظيفةٍ رمزيّة، بل جاء الردّ في إطارٍ مختلف: "الانتقام"، لا كفعل سياديٍّ صادر عن الدولة، بل كفعلٍ شعبيّ يُفترض ضبطه. في "هآرتس"، دُعِيَ "الإخوة المستوطنون" إلى ضبط النفس.10 وفي "سي إن إن"، اقتُبِس نتنياهو، في ٧ نيسان، وهو يأمر بتعبئة وحدات الشرطة والجيش.11 أمّا في ٢٦ شباط، فنُقِل عن المجلس المحلّيّ: "سنعانق العائلة، وسنكون إلى جانبها بقدر ما يلزم".12 وعليه، لا يُدرَك "المستوطن" – بوصفه رجلاً – في البنية الأيديولوجية للخطاب الصهيونيّ إلا كفعلٍ وظيفيّ، كموقعٍ متعيّنٍ في منظومة العنف. فالرجولة هنا وظيفة، لا هوية؛ تموقعٌ في آلةٍ تنظمها بنية الاستعمار الاستيطاني لا بوصفها عنفًا فحسب، بل كحالة دائمة من التعبئة؛ أمّا "المرأة المستوطِنة"، فتمثيلها لا يتموضع في خانة الفعل، بل في حيّز الخطر الرمزيّ: إنها ليست عنصراً في جهاز العنف، بل مؤشّراً على خللٍ فيه. هكذا تُنصَّب كحالة طوارئ تستدعي استنفاراً بنيوياً، حيث يتجاوز تمثيلها موقع الضحية، ليُعاد إنتاجها بوصفها وعاءً لأخلاق الأمة، وذاكرتها، وخطابها الدفاعي.
بفعل الحرب، لا تُقوَّض البُنى العائليّة بما هي وحدة اجتماعيّة فحسب، بل تُعاد صياغة علاقات القرابة كآليّةٍ لإعادة إنتاج الاجتماع السياسي تحت شروط التهجير والعنف المنظّم. ذلك أنّ انهيار العائلة، بوصفها حاملةً وظيفيّة لأدوار الرعاية والتنشئة والدعم الاقتصادي، لا يُنتج فراغًا، بل يستدعي، في ظلّ شروط الاستعمار الاستيطاني، أنماطًا بديلةً من القرابة، تتوسّع وتتقلّص بتقلّب الجبهات. وفي السياق الصهيوني تحديدًا، يتجلّى هذا في تشظّي نموذج العائلة المستوطِنة، المُؤَمْنَنَة عسكريًّا، والمؤطّرة ضمن نمط زراعيّ/صناعيّ، تلك التي شكّلت، لا كمفهومٍ اجتماعيّ بل كمؤسّسة أيديولوجيّة، العمود الفقريّ لهويّة المستوطن الصهيوني منذ بدايات المشروع الاستيطاني.
تُبيّن تحليلات آن لورا ستولر (٢٠٠٢) لبنى الحكم الكولونيالي أنّ الفضاءات الحميميّ، ذاك الذي يُظنّ أنه خاص وخارج عن المراقبة، هو في الواقع موضع مركزيّ لنفوذ السلطة. وهذا ما يتجلّى بوضوحٍ صارخ في تحكّم الكيان الصهيوني باشتراطات عيش الفلسطينيّين. تنهض النساء غالبًا بما هنّ فواعل تُعيد إنتاج القرابة ويُفكّكن، بإعادة التكوين، ما شُيّد على شكل التمزيق. لا تلتحم القرابة هنا على أنقاض العائلة، بل تنهض من تناقضها مع ما كان يُراد لها أن تكونه. وبهذا المعنى، لا تُعيد المرأة بناء ما تهدّم، بل تُعرّي في فعل الترميم نفسه طبيعة الهدم، لا كعنفٍ عابر، بل كبنيةٍ دائمة، كما تُظهره الممارسة التحليلية لنادرة شلهوب-كيفوركيان (٢٠٠٩)، حين تُفكّك هشاشة الهوية الاستيطانية عبر صلابة ما يقاومها.
ليس تفكّك العائلة المُؤَمْنَنَة عسكريًّا، والمؤطّرة ضمن نمط زراعيّ/صناعيّ، في سياق المشروع الاستيطانيّ الصهيونيّ، عرضًا طارئًا على البنية، بل هو ضرورةٌ كامنةٌ فيها، تنكشف كلّما اشتدّت الحاجة إلى تثبيتها. ففي ما يبدو أنّه خللٌ ظرفيّ، تعمل الأيديولوجيا عملها الخفيّ: إذ ليست العائلة هنا وحدة إنتاجيّة فحسب، بل هي، كما كشف شافير (١٩٨٩)، ناظمٌ للارتباط بين احتلال الأرض وتنظيم العمل، وما هذان إلّا ركيزتان لهويّةٍ استيطانيّةٍ تشكّلت لتُصدّر باعتبارها وطنيّة. غير أنّ ما يتكشّف، عند تعرّض هذه البنية لأزمة، كما في زمن الحرب، في زمن المقاومة، هو التناقض في قلب هذه الهوية عينها، ذاك الذي بيّنه روحانا (١٩٩٧) بوصفه تناقض المشروع الاستعماريّ ذاته، حين تُفصح الدولة عن عجزها في توحيد ما لا يتوحّد: الاستيطان كحركة، والدولة كأداة. إنّ ما تبدّى عند زرتال وإلدار (٢٠٠٧) لا يُفهم إلا بوصفه استمراريّةً أيديولوجيّةً لمشروعٍ ابتدأه المستوطن بوصفه طليعة، لا مواطنًا، وبهذا، يكون تهديد الدولة له، لا من خارجه، بل من داخل منطقها. وبهذا المعنى، فإنّ ما يُظهره فيراشيني (٢٠١٠)، من أنّ السيطرة الاستيطانيّة إنّما تقوم على تنظيم الحيّز الحميم، هو ما يجعل هذا الحيّز ساحة صراع دائم، لا مع الفلسطيني وحده، بل مع المستوطن نفسه، حين تنقلب أدوات السيادة على من أُنتج ليُجسّدها. هنا، تصير البنية، كما بيّن وايزمان (٢٠١٧)، لا أداة ضبطٍ فحسب، بل ساحةً تنفجر فيها التناقضات: فالهندسة المعماريّة، وقد خُصّصت للتطويق، تنقلب حلبةَ مواجهة، لا لأنّ الفلسطينيّ يقاومها، بل لأنّ المستوطن يرفض تموضعه كوظيفة ضمن جهاز، لا كذات فاعلة. وعليه، فإنّ البنية التي ظُنّ أنّها ثابتة، لا تتزعزع تحت ضغط المقاومة فقط، بل تتفسّخ تحت ثقل وظيفتها، حين لا تعود الأيديولوجيا قادرةً على إخفاء تصدّعاتها الداخليّة.
ليس الانقسام في بنية الكيان الصهيونيّ انقسامًا بين فكرتين تتنازعان الوعي السياسي، بل هو انقسامٌ يتجسّد في الفضاء، لا بوصفه خلفيّةً للصراع، بل بوصفه شكله العياني، حيث يتمفصل التناقض بين مواطنٍ ومستوطنٍ على أساس موضع كلّ منهما في المنظومة التي تُعيد إنتاج الاستعمار. فالمواطن المدينيّ، في موقعه الذي يَظهر كمُستقرّ، كمتمدّن، كمستفيدٍ من الأمن، لا يَتنعّم بالهدوء إلا بقدر ما تُزرَع حوله البؤر الاستيطانيّة – لا يحيا حداثته إلا بما تُنتِجه المستوطنة من حدودٍ لها. والمستوطن لا يظهر ناجياً من تاريخٍ "طلائعيٍّ" في محايثة المقاومة، في تماسٍّ دائمٍ مع الرفض، بل يُنتِج استمراره بوصفه حاضرًا مأزومًا لا يكتمل. هنا، لا تعود الذاكرة مجرّد استعادةٍ لِما كان، بل شرطاً مادّيًّا لِما يكون. المستوطنون، ومعهم أهل الكيبوتس، لا يسكنون تخوم الدولة وحسب، بل يسكنون تخوم الأيديولوجيا، حيث يُعاش التناقض، لا يُنظَّر له؛ يُختبر، لا يُدرَّس. هنا تقوم الطبقة العاملة الإسرائيليّة مقام حلقة الوصل بين هذين القطبين؛ في انقسامٌ يتنقّل بين حدَّي الحداثة والإرهاب الاستعماري. وهذا ما يجعل الحلف بين المواطن والمستوطن ممكنًا.
في الظاهر، ينفصل المستوطِن عن المواطن، في الإيديولوجيا كما في الجغرافيا، غير أنّ ما يفصلُهما في الظاهر هو ما يربطُهما في البنية: فالمستوطِن يؤدّي وظيفة الحاجز، بوصفه وسيطًا يحول دون الاشتباك الميداني المباشر بين المقاومة الفلسطينية والمدينة الكولونيالية. وهو، إذ يقوم بهذا الدور، لا يستقلّ عن الدولة، بل يتغذّى منها: في الشرعية، في الموارد، في الاعتراف الرمزيّ، وفي أنّه لا يكون إلا بها. فهل يكون التحالف إذًا ظرفيًا؟ أم أنّه، بما هو تحالف، هو تعبيرٌ عن تساند البنية لا عن تنوّع في الموقف؟ هذا التواطؤ بين المدينة والمستوطنة يتشكّل في وجدانٍ جمعيّ، تحرّكه خطابات الخطر الوجوديّ، وتتغذّى عليه أشكال التضامن، للانصهار في بوتقة سلطةٍ تُعاد هندستها باسم "الوطن الواحد".
في قلب هذا المشروع تقف الطبقة العاملة الإسرائيليّة، بوصفها الوسيط القائم على ردم الهوّة بين الزمان والمكان، بين التاريخ والجغرافيا – بين الجبهة والمدينة. هذه الطبقة هنا جسد يُناط به أن يُعيد لحمة الدولة حيث تتفكك، أن يوفّق بين المواطن والمستوطن، بين الهامش والمتروبول. لكن، كيف ينعقد تجانسٌ لم يتحقّق أصلًا إلا كتناقض؟ إنّ ما تقوم به الدولة، في اختلاق الوحدة، ليس إلا فعلاً من أفعال إعادة الهيكلة الإيديولوجيّة، يُمارَس لا في المجاز، بل في "البيت"، كحيّزٍ مادّيّ ورمزيّ في آن، يُطهَّر لا من الغبار، بل من التناقض، من بناه المتضاربة. فـ"تنظيف البيت"، كفعل سياسيّ، هو تعبير عن سعي الدولة إلى حلّ التناقض، لا بإلغائه، بل بإدارته، بصياغته من جديد كشرطٍ للتماسك. في هكذا "بيت" – الذي هو الوطن، وهو العائلة، وهو الجبهة الداخليّة – تُدار القرابة لا بوصفها علاقة دم، بل بوصفها بنيةً أمنيّة.
في التحليل الأخير، يتبدّى التماسّ بين المستوطِن والمواطن كمحورٍ بنيويّ تُعالج عبره التوتّرات بين الطبقة، والقوميّة، وبُنية الاستعمار الاستيطاني. هذا المحور لا يُفهم كخطٍّ نظريّ، بل كمسرحٍ للصراع، حيث تُصاغ الهويّات بقدر ما تُفكّك، وتُرسَم الحدود بقدر ما تُختَرق. فالطبقة العاملة في المدينة الإسرائيليّة، كما يُبيِّن روزنهِك وشاليف (٢٠١٣)، تُحتَجز في مفارقةٍ مركّبة: فهي من جهةٍ تتغذّى من بنيات الأمن ورأس المال التي ترعاها الدولة، ومن جهةٍ أخرى، تنفصل مكانيّاً ونفسيّاً عن خطوط التماسّ والمواجهة، حيث يُعاد إنتاج الشرط الكولونيالي في أقسى أشكاله.
هذا الفصل لا يُمكن أن يقوم من دون المستوطِن، الذي ليس بقايا مشروعٍ استيطانيّ بل بنيةٌ فعّالة عند تخوم الدولة، التخوم التي تُعيد إنتاج مركزها، تمدّها بذرائع البقاء، وتؤمِّن لها ما تحتاجه في بنيتها. المستوطِن ضرورةٌ عسكرية وسياسية، فهو وسيط العنف الذي تُمتَص به الصدمات المقاومة، ويُعاد عبر جسده ترسيم حدود "الداخل" و"الخارج". في المقابل، يتلقّى المواطن المدينيّ ميراث الدولة لا بوصفه وعياً بها، بل كحالةٍ مفارقة: هو وريثُ مستقبلٍ قوميّ قائم على ماضٍ لا يعترف به، لكنه لا يُبنى إلّا عليه. يتنكّر لهذا الماضي خطاباً، لكنه يُعيد استحضاره وجدانيّاً، بوصفه مادّة الوطن الخام. وما يُثبّت هذه العلاقة، بوصفها بنيةً لا حادثاً، هو ما يقوله وولف (٢٠٠٦): فالاستعمار الاستيطاني لا يُختزل في لحظة التأسيس، بل هو بنيةٌ مستمرّة، غايتها محو الأصلانيّ وإقامة نظامٍ اجتماعيّ جديد، لا يتجلّى فقط في التملّك، بل في نفي التملّك عن الآخر، وفي نفي هذا النفي بوصفه نظاماً. ومع ذلك، فإنّ هذه القسمة بين المواطن والمستوطِن، كما يعيدان توكيدها روزنهِك وشاليف (٢٠١٣)، ليست قسمةً ناجزة. فهي مثقلةٌ بتناقضاتٍ لا تُحلّ، بل تُدار: إذ تبقى الطبقة العاملة المدينيّة عالقةً بتواطئها في تذبذبٍ دائم، بين مشاركتها الماديّة في الاستفادة من البنى الاستيطانيّة، وبين الأكلاف المعنويّة للتهجير والإقصاء.
ليس "البيت" في الخطاب الصهيونيّ بيتًا، إلّا بوصفه نفيًا: نفيًا للمكان الذي سُلب، وللرابطة التي فُكّكت، وللجسد الذي حُوّل إلى أداة أمن. ففي نقد شوحات (١٩٩٨)، لا يُقرأ البيت إلّا كبنية أيديولوجيّة، يتأسّس حضورها في فعل الطرد ذاته – طرد الفلسطينيّ بوصفه الغريب، وتهميش اليهوديّ غير الأوروبي. في قلب هذا البيت-الحصن، يُعاد إنتاج المستوطن لا بوصفه مُحتلًّا فحسب، بل كضحيّة لوظيفة الاحتلال. فهو ليس فاعلًا حرًّا بل موقع وظيفيّ داخل آليّة التوسّع الاستيطانيّ، وقد باتت هشاشته شرطًا لاستمرار دوره. ولذلك، فإنّ الدولة لا تكتفي بإسناد العنف إليه، بل تُلبسه قناع الألم: ألم الجغرافيا، وألم الانتماء، وألم الرجولة المجروحة – رجولة لا كما تحلّلها ماير (٢٠٠٠) بوصفها أزمة هويّة ثقافيّة، بل تُعاد صياغتها هنا كشرطٍ سياسيّ: شرط لإعادة دمج المستوطن في الحظيرة الوطنيّة، عبر تحويله من فاعل حدوديّ إلى عائلة مؤسّسة، من بندقيّة إلى بيت.
لاستيعاب البنية التكوينية لوعي المستوطِن ضمن المشروع الاستيطاني الصهيوني، لا يكفي أن نُدرِج "المستوطن" كوحدة تحليلٍ واحدة متجانسة؛ بل تقتضي الضرورة المنهجية تفكيك هذا التصنيف الظاهري، للكشف عن التمايزات البنيوية بين أنماط متعدّدة من المستوطنين، وفي مقدّمتهم مستوطنو الكيبوتس. فهؤلاء، وقد تشكّلوا في لحظة التقاء المشروع القوميّ الصهيوني باليوتوبيا الاشتراكية، لم يتّخذوا موقعهم في الاستيطان إلّا بوصفهم طليعة أيديولوجيّة مناضلة: عمّال الأرض، حرّاس الحدود، بنّاؤوا الأمّة. غير أنّ هذه الوظيفة التأسيسية، وقد اقترنت عضويًّا بالبنية العسكرية للحدود، لم تظلّ على حالها. ففي لحظة انبثاق الدولة كمركز سياديّ، لم يُقصَ مستوطنو الكيبوتس، بل أُعيد إدماجهم بوصفهم بنى مزدوجة الوظيفة: فهم من جهة امتدادٌ لجهاز السيطرة، ومن جهة أخرى كتلة قابلة للوقوع كضحيّة، أي كجيش احتياطيّ من الألم، يُستَحضر عند كلّ تصعيدٍ ليبرّر، بحضوره المعذَّب، العنف البنيويّ الذي يمارسه المركز. فالمستوطِن، هنا، لا يَحرس الحدود فقط؛ بل يُستثمَر وُجوده لإعادة إنتاج سرديّة التهديد، ولإضفاء شرعيّة على التوسّع بوصفه دفاعًا لا غزواً. في المقابل، تتكوّن فئة أخرى من المستوطنين في مستعمرات رسميّة أقرب إلى المدن الفلسطينيّة أو متموضعة على عقدٍ جغرافيّة استراتيجيّة. هؤلاء لا يستبطنون سرديّة الطليعة المؤسّسة، بل يتموضعون كامتداداتٍ وظيفيّة للسياسات التوسّعيّة للدولة، حيث يُعاد تشكيل وعيهم الاستيطانيّ من خلال الاحتكاك المادّيّ والمباشر مع آليات الرصد، والتهديد، والسيطرة. فهم لا يعيشون على أطراف الجغرافيا فحسب، بل في داخل الجدل الحيّ بين الشرعيّة المزعومة والاحتلال العيانيّ.
هكذا يكون "المستوطِن" موقعًا يتشكّل بتغيّر الزمان، وتحوّل الجغرافيا، وتبدّل أولويات الدولة. وما الوعي الاستيطانيّ إلّا بنيةٌ تُنتَج وتُعاد إنتاجها في صراعٍ دائم مع شكل الدولة، ومع حدودها المتحرّكة، ومع سرديّتها التي لا تكتمل إلّا بإقصاء الآخر واستيعاب ما تبقّى من الذّات بوصفها مشروعًا قابلاً للتوسّع. تمامًا كما هي الحال في كلّ إيديولوجيا رأسمالية، ما بعد إقطاعيّة، تتّخذ الأسرة المستوطِنة، في المشروع الصهيوني، موقع الدعامة. إلّا أنّ خصوصيّة السياق الصهيونيّ تتجلّى لا في وظيفتها البنيوية فحسب، بل في معناها، في ما تُنتجه هذه الأسرة من "يهوديّ جديد" مُنتَشل من خنادق أوروبا المحطّمة بالحرب. ففي داخل هذه الأسرة – لا خارجها – يُعاد إنتاج الذكورة والأنوثة، لا كتصنيفين بيولوجيّين، بل كوظيفتين إيديولوجيّتين؛ ويُصهَر العنف العسكريّ في وعي طبقيّ، وتُعاد صياغة معنى القومية الصهيونية بما يتناسب مع لحظة تَحوُّلها من مشروع لجوءٍ إلى مشروع استعمار. وإذا ما قاربنا هذه البنية بمنظورٍ ماركسيّ نسويّ، كما فعلت آن ماكلينتوك (١٩٩٥)، اتّضح لنا أنّ الحرب ليست قطيعة مع الدولة، بل آليّة لإعادة إنتاجها؛ ليست استثناءً عن "السلم"، بل هي صورته القصوى. فباسم "الدفاع عن الوطن"، يُعاد تعليب مفاهيم الرجولة، البطولة، والتضحية، لتُشكِّل العقدة العصبويّة في جسد الأمة الحديثة. في هذا السياق، لا يُسمح للمرأة سوى بوظيفة رمزيّة: إما كضحيّة تستغيث، أو كأمّ للشهيد، تُعيد إنتاج شرعيّة العنف الذكوريّ من خلال الحداد عليه. لكنّ هذه الرمزيّة لا تُفرّغ من محتواها، بل تُحمّل وظيفةً تعبويّة، حيث يتحوّل خطاب "الانتهاك" إلى نداء تعبئةٍ عام، تُستَنهض فيه الغرائز القومية من خلال جسدٍ أنثويّ يُفترَض أنّه "دُنِّس".
في هذه البنية، كما بيّن جوزيف مسعد (١٩٩٥)، لا تكون "أنوثة منتهكة" فحسب، بل تكون معيارًا يُقاس عليه انحلال الشرف القوميّ، ومؤشّرًا لفشل الأجهزة الأمنية، ومحرّضًا على استعادة السيادة عبر عنفٍ مضاعف. وهكذا يتحوّل الخوف من "الإرهابي العربيّ" إلى مرآة تعكس العطب الداخليّ، ويُعاد ضبط البوصلة السياسيّة من خلال جسد المرأة، لا بوصفه ذاتًا، بل أداة وظيفيّة في تراتبيّة الدولة. لكنّ هذا التوظيف لا يمحو التناقض، بل يُظهره: إذ تظهر على هامش هذه البنية، وبفعلها، شخصية المستوطِن المارق، لا كفردٍ شاذّ، بل كبنيةٍ لم تعد الدولة قادرة على استيعابها أو تأطيرها. فتُطرَح، عندئذ، معضلةٌ جديدة: كيف تُعيد الدولة إنتاج أسرتها وهي على حافة فقدان السيطرة على الأبناء الذين أنجبتهم باسم مشروعها القوميّ ذاته؟
ليس المستوطِن، في البنية الراهنة، تهديدًا جسديًّا مباشرًا – فهو، إذ لا يحمل جسد العدوّ، لا يُنتج كعدوّ، بل كمُربِك، كخللٍ في انتظام البنية ذاتها. الفلسطينيّ هو التهديد لأنّ وجوده يُعاد إنتاجه كعبورٍ دائمٍ للحدّ، ما لم يُختزل في أدوارٍ وظيفيّةٍ معيّنة – كأن يكون قوّة عملٍ. أمّا المستوطِن، فهو الحدّ نفسه، لا يتجاوزه بل يؤسّسه، ويقيس عليه. إنّه الأثر المتجدّد للماضي الذي لا يمضي، والشرطُ الذي تُبنى عليه الدولة بوصفها حاضرًا يتهرّب من أصله. في التناقض الذي تحاول الدولة أن تُخضعه لا تلغيه، تُعاد موضعة المستوطِن لا كفاعل، بل كوظيفةٍ من نوعٍ آخر: منطقةٌ عازلة، جسدٌ يمتصّ عنف الصدمات المقاومة، ويؤدّي بذلك مهمّته المزدوجة: أن يُستثمر أمنيًّا، ويُستدعى رمزيًّا. وإذا كان التوسّع صنو التأسيس، فإنّ الضبط هو مهمة المرحلة الجديدة، وهي لا تلغي الاستيطان بل تُعيد إنتاجه كأداةٍ لاكتساب الشرعية – لا بوصفه مشروعًا يلتحم بل بوصفه فاعليّةً تابعةً لسيادة الدولة الحديثة. هنا، تتقدّم الصهيونيّة نحو طورها الجديد: من "جيش له دولة" إلى "دولة لها جيش". فليُفهم التحوّل، إذًا، لا بوصفه زخرفًا لغويًّا، بل كإعادة تموضع للسلطة الصهيونيّة. فإن كان الاستيطان، في لحظته الأولى، مفتوحًا على المطلق، خاضعًا لفكرة الحدود بوصفها قابلة للتوسّع الدائم – فإنّ الدولة، وقد استقرّت، لم تعد قادرةً على تحمّل هذا الانفلات. وهنا، لا تعود الصهيونيّة مجرّد حركة، بل تصير نظامًا، نظامًا يبحث عن استقرارٍ في الهويّة، وعن تطابقٍ بين الأرض والسيادة، بين الجيش والدولة، بين العنف المشروع وضبطه المؤسّسيّ. وهكذا، لا يكون ما تقوله القيادة الليكوديّة مجرّد بلاغة سياسيّة، بل إعلانًا عن ولادة شكلٍ جديد من الحكم: صهيونيّةٌ تُطوِّع ذاتها ضمن أطر الدولة، تُعيد توطين الفائض التوسّعيّ داخل منظومةٍ أمنيّةٍ إداريّة.
إذا كان المستوطِن قد وُجد، في لحظته الأولى، كوظيفةٍ تؤدّيها البنية الاستعمارية لتثبيت مشروعها التوسّعي، فإنّ إلغاءه لا يكون بإزالة الجسد بل بتجاوز وظيفته. وهذا التجاوز لا يتحقّق إلا على أحد نحوين: إمّا عبر إنجاز المشروع التوسّعي نفسه، أي بتحقيق الإشباع الكامل للحيّز الجغرافي عبر الضمّ والهندسة الديمغرافية، وإمّا بصوغ عقيدة أمنيّة نهائيّة، لا تكتفي بإدارة بقاء الفلسطينيّ كـ"مسألة"، بل تعيد تعريف هذا البقاء نفسه، كإرثٍ يجب أن يُزال. وهنا، لا يعود السؤال سؤال حدود، بل سؤال وجود، ولا يعود الصراع صراع أرضٍ فقط، بل صراع تعريف: أي صهيونيّة نُريد؟ تلك التي تُقيم مشروعها على التخوم، أم تلك التي تُعيد تموضع ذاتها كدولةٍ "مركزية" تُدير التناقض وتُطوِّعه؟ بهذا المعنى، لا تعود إعادة تعريف الصهيونيّة ترفًا فكريًّا، بل ضرورةً سياسيّة، لأنّ الاستمرار في الحكم يتطلّب إنتاج سرديّة جديدة، سرديّة تجعل من السيطرة لا فعلاً طارئًا، بل بنية دائمة.
ولذا، فإنّ ما يُسمّى بـ"الحلّ النهائي" ليس مصطلحًا من الماضي، بل أفقٌ مطروحٌ، يتقدّم لا بصفته خطاب إبادة فحسب، بل كسياسة عقلانيّة تُقدَّم، في منطق الدولة، بوصفها "إدارة نهائيّة للتناقض". هذا ما يجعل من الاستيطان لا نهاية مشروع، بل بدايته الجديدة: بداية دولةٍ تُعيد تعريف ذاتها باعتبارها سيادةً حديثة، تَحكم عبر الأمن، وتُبقي الأمن بوصفه الشكل الأعلى للعقل السياسيّ.
صرّح المسؤول العسكريّ الأعلى بأنّه يُفضّل إصدار أوامر اعتقال وقيودٍ لردع "العناصر الراديكالية" من بين المستوطنين. "قد تُحاول العناصر المتطرّفة زعزعة السلام، وقد تُهاجم قرى فلسطينيّة. ليست لدينا معلومات عن هجمات محدّدة، لكن... ينبغي نزع السلاح من أولئك المرشّحين للإخلاء"، أضاف المسؤول.13
إنّ هذا التصريح، وإن بدا تقنيًا في لغته، لا يُخفي ما هو أعمق من إجراء إداريّ أو ملاحظة أمنيّة؛ بل يُفصح، في بنيته، عن التواطؤ البنيويّ بين الثقافة والأمن، بين الجسد وتقديره العسكريّ. فالثقافة هنا ليست تمظهرًا حياديًّا للمعنى، بل هي ناتج مباشر لعلاقات القوّة، لاقتصاد المعنى كما يُنظّم داخل أجهزة الضبط والهيمنة. الجسد، في منظور آليّات الاستعمار الاستيطاني، لا يُقارب بوصفه ذاتًا حرة، بل كوظيفةٍ بيولوجيّة، تُنحت في الخطاب، وتُفرَض عليه لغة الدولة، ليُعاد إنتاجه وفقًا لمقتضيات الحاجة السياديّة؛ تلك التي تتبدّل بتبدّل مزاج الطبقة الوسطى، أو بانعطاف الجغرافيا نحو طورٍ من أطوار الحرب. وهنا، كما تُبيّن جوديث باتلر (٢٠١١)، ليست القيمة المُعطاة للجسد، إذًا، نابعة من جوهرٍ يهوديّ مفترض، كما لا تُختصر في نقيضه الفلسطينيّ كمستعمَر. إنّها تُمنَح وتُسحَب، لا كفعلٍ عفويّ، بل كتدبيرٍ أمنيّ، كتشكيلٍ قسريّ داخل مصفوفة السلطة، حيث لا يتحقّق الجسد إلا بما يُمكنه أن يؤدّيه في اقتصاد المعنى القوميّ، وما لا يُنتج يُمحى، لا كوجود، بل كدلالة. هكذا، وكما تفترض النظرية حين تُنتج من قلب التناقض، لا من خارجه، يصبح "المعنى" ذاته رهينة الوظيفة: ما يُفيد يُثمّن، وما يعجز يُقصى. وفي عالمٍ تحكمه علاقات الإنتاج الرأسمالي، لا يُدرَك الإنسان بوصفه إنسانًا، بل بوصفه موضعًا وظيفيًّا – يُقيَّم لا بما هو عليه، بل بما يُنتظر منه، وما إن ينتهي نفعه، يُعاد تموضعه في الهامش، حيث اللاجدوى تصير تعريفًا وجوديًّا.
إنّ المستوطنَ، بوصفه متحرّرًا من ثبات الهويّة، يُجسِّدُ بأدقّ ما يكون من التجسيد ذاك المنطق الذي تُعيد فيه الصهيونيّة الجديدة إنتاج أدواتها بقدر ما تسعى إلى كبحها. فالدولة، إذ تُحاول احتواء المستوطن ضمن هندستها الأمنيّة، لا تفعل ذلك من موقع النفي بل من موقع الاحتياط؛ لا تلغيه، بل تؤجّله، تحفظه في الجيب الخلفيّ للضرورة، كي يُستَخرج حين تعجز المنظومة عن الاستمرار دون الفوضى التي ادّعت أنّها جاءت لتحسمها. فالمستوطن ليس ذاتًا طائشةً خرجت عن نسقها، بل أداة مُعادة التعريف، مُهيّأة للتنشيط لا بالضدّ من الدولة، بل بها، وبحسب ما تستوجبه الحاجة، حاجة الدولة لا إلى النظام بل إلى إخلالٍ به يؤسّسُ لسلطتها من جديد. فإذا ما تراجع دعم الحلفاء، أو تصاعدت المقاومة الفلسطينيّة حتى بلغت نقطة اللّا-احتمال، أو استجدّت يقظة عربيّة تنبعث من رماد الإذعان، فإنّ من كانت تراهم الدولة خطرًا على صورتها سيُعادُ تجنيدهم كدرعٍ لمستقبلها. فها هو المستوطن، الذي بالأمس رُوِّض كعبءٍ فائض، يُستعاد اليوم كمُرادفٍ للنجاة. وهكذا تُثبت آلة الاستعمار الاستيطاني أنّ ما يُصنَّفُ اليوم كخطرٍ فائضٍ عن الحاجة هو ذاته ما يُنقذها حين تنقلب الحاجةُ تهديدًا. فالوظيفة لا تُمحى، بل تُؤجَّل؛ والهوية لا تُنفى، بل تُقنّن، إلى أن تستدعيها الدولة مرّةً أخرى، لا لتُعيدها إلى نسقها، بل لتُعيد بواسطتها تعريف النسق.
المنفعة من المستوطنِ المُجنْدَر في إطار الاستعمار الاستيطاني14
لم يعُد المستوطِن، في إسرائيل النيوليبراليّة المعاصرة، يُمجَّد بوصفه الطليعة الكيبوتسيّة، إذ تخلّى المشروع الاستيطانيّ عن صورته الرومانسيّة التي صاغها زمن العمل الجماعيّ والنشيد الصباحي، لا ليُنهي فعل الاستيطان، بل ليُعيد تأطيره وفق شروط المرحلة الجديدة، حيث تُصبح إعادة التموضع شكلاً من أشكال البقاء. فكما تُبيِّن لنا بنية الإقصاء عند وولف، لا يكفّ الاستعمار الاستيطانيّ عن ابتداع سرديّاتٍ تُبرّر فعله، بل يملك من القدرة على التحوّل ما يُبقيه مشروعًا حيًّا وسط تناقضاته. فالكولونياليّ الزراعيّ الذي حمل المعول، واستحال رمزًا لـ"الاستيطان المنتج"، لم يكن يومًا سوى قناعٍ أيديولوجيّ يُخفي السطو على الأرض تحت شمس التعاونيات، ليتحوّل، في صيغته النيوليبراليّة، إلى فاعلٍ سوقيّ، محاطٍ بسياجٍ كهربائيّ، محميّ بقرضٍ عقاريّ، وقريبٍ من مركز تجاريّ. إنّ منطق الإقصاء نفسه، الذي اتخذ بالأمس وجه الكادح، يظهر اليوم بوجه المستثمر، إذ لم تتغيّر البنية، بل لَبِست منطقها بسوقٍ حرّ، ومن الاستعمار ما استبدل الشعار دون أن يَخدِش الهدف.
تضيف الاشتراطات الجيوسياسيّة طبقةً أخرى إلى عمليّة إعادة تشكيل المستوطِن، لا بوصفها طبقةً خارجيّة تُركّب على الهيكل القائم، بل بوصفها توتّرًا داخليًّا يُعاد عبره إنتاج الهيكل نفسه. فبفعل الضغوط الدوليّة، لا يجد المشروع الصهيونيّ بُدًّا من فرز المستوطِنين إلى "مارقين" – كشباب التلال الذين يُستدعون عند الحاجة ثم يُدانون – و"شرعيّين"، كقاطني كتلة أرئيل، الذين تُرسم حدود مقبوليتهم بقدر ما تُرسم حدود الاستيطان. وكأنّ نتنياهو يُلقي خطابًا كتبه بنفسه، اختار أدواره، وزّع بطولاته، ثم ألقى باللائمة على الجمهور. هذا التمايز الداخليّ لا يُفهم كتناقضٍ عرضيّ، بل كآليّة جوهريّة تَكشِف، كما في تحليل وولف، أنّ البقاء الاستيطانيّ يتطلّب التخلّص من أكثر تمثّلاته تطرّفًا، حين يُصبح الامتداد الترابيّ حقيقة واقعة. وعلى إيقاع المقاومة الفلسطينيّة – سواء أكانت نضالًا مسلّحًا أم حملات مقاطعة – تتقلّب قيمة المستوطِن، رمزيًّا وماديًّا، بما يُعيد تأكيد أطروحة وولف (٢٠٠٦): إنّ الاستعمار الاستيطاني لا يحيا بالسكون، بل بالتحوّل، لا ليستبدل بنيته، بل ليُعيد تشكيلها في حركةٍ دائمةٍ تكفل له البقاء.
تُساق العائلة المستوطِنة، هي أيضًا، في تيّار التحوّل. فما كانت، في زمن الصهيونيّة العمّاليّة، سوى محرّكٍ لإعادة إنتاج الجماعة القوميّة، تؤدّي فيه بنيةُ الجندر وظيفتَها في رسم صورة المرأة كـ"أمّةٍ في هيئة أمّ"، لتتماهى هذه الصورة مع ما سمّاه وولف "سيادةً جيليّةً" (٢٠٠٦) تضمن بالإنجاب ديمومةَ المشروع الاستيطانيّ، لا عبرَ حدثٍ بل ضمنَ بُنيةٍ لا تفتأ تعيد إنتاج ذاتها. أمّا في المرحلة النيوليبراليّة، فتعاد صياغة وظيفة تلك العائلة: لم تعد تؤدّي فعل الإلغاء الجماعيّ باسم الاشتراكيّة المسلّحة، بل باتت تُنتج الإلغاء بآليّاتٍ خصخصيّة؛ حيث حلّت المجتمعات المُسوَّرة محلّ التجمّعات التعاونيّة، وغدت أجساد النساء رموزًا للصمود المُفرط في فردانيّته، حتّى ليغدو "استمرار الأمّة" مشروطًا بجلسات اليوغا قبل الولادة في ضواحي مصفّحة ضدّ الرصاص. هكذا لا يخفي هذا التحوّل النيوليبراليّ انقطاعًا، بل يموّه استمراريّةً، إذ لا تزال الأرض تُنتَزع، لكنّ آليّات السطو تتزيّا بزينة الحداثة: من الكيبوتس الاشتراكيّ المسلّح والمنعزل إلى تطويرٍ عقاريّ محروسٍ بالأمن والمراقبة. ليس تغيّر صورة المستوطِن انسحابًا من المشروع الكولونياليّ، بل إعادة تشكيلٍ له؛ تجميلٌ يغلّف البنية القديمة بقشرةٍ حديثة، دون أن يمسّ جوهرها، ذاك الذي أسماه وولف: "بنية لا حدثًا" (٢٠٠٦:٣٨٨) – بنيةٌ تتجدّد لا لتتغيّر، بل لتُبقي على الاستعمار حيًّا بالتكيّف.
ليس المستوطِن، في تشكيله البنيويّ، تاجرًا وحسب، ولا جنديًّا فحسب، ولا حاكمًا إداريًّا فحسب؛ إنّه، بالأحرى، كتلة سكانيّة مشبعة بانتماء وجدانيّ مستقلّ إلى أرضٍ مُطهّرة، لا كحيّزٍ مادّيّ فحسب، بل كحَقٍّ ميتافيزيقيّ مؤسَّسٍ على سرديّاتٍ دينيّةٍ ومطالب تاريخيّة تُضفي على هذا الانتماء مشروعيّة التدخّل في تقرير شؤون الأرض السياسيّة. وهكذا، لا يتجلّى الاستعمار الاستيطانيّ كعلاقة خارجيّة بين غازٍ ومغزوّ، بل كبنيةٍ، لا تسعى إلى الإخضاع وحسب، بل إلى الإحلال. فإنّه، إذ يُمارس السيادة على أراضٍ مُطهَّرة قسرًا، فإنّه لا يُعيد رسم الخريطة فقط، بل يعيد إنتاج المجتمع بما هو جهازٌ استعماريّ. هنا يتجلّى ما نظّر له وولف (٢٠٠٦)، لا تعود العلاقة الاستعماريّة مجرّد مقابلة بين مُستعمِر ومُستعمَر، بل تتحوّل إلى عمليّة إنتاجٍ لبنى اجتماعيّة جديدة، إذ لا يتحقّق الاستعمار الاستيطانيّ إلا بوصفه إعادة تكوينٍ للمجتمع، لا استغلالًا له فقط، بل إزاحةً واستبدالًا، حيث يُنظَّم الوجود الاجتماعيّ الجديد على قاعدة الإقصاء التامّ للسكّان الأصليّين، لا عبر حدثٍ وحيدٍ، بل كبنية دائمة لا يكتمل حضورها إلا باستمرار الإزاحة.
ولهذا، فإنّ المستوطَن لا يُباد فحسب، بل يُزال إداريًّا، اجتماعيًّا، قانونيًّا، عبر ما يمكن تسميتُه إعادة التكوين الديمغرافيّ من خلال تفكيكٍ دائمٍ للهياكل الأهليّة والمؤسّساتيّة للفلسطينيّين. وهذا التفكيك لا يُمارَس باسم الإخضاع العسكريّ وحده، بل من خلال استراتيجياتٍ مابعد-بُنيويّة، تعمل لا على قمعٍ مباشر بل على تفتيتٍ زاحفٍ، يتوسّل خطاباتٍ تنظيميّة، سلاسل لغويّة، وأنماط سلوكٍ تتحوّل، مع الوقت، إلى أنظمة معيارية تضبط الوجدان والفعل على حدّ سواء. بهذا المعنى، يتشكّل وعي المواطن-اليهوديّ الجديد بوصفه إعادة تركيبٍ لغويّ-سلوكيّ يخضع لمنطق الدولة لا كمؤسّسة، بل كمُنظّمٍ للمعنى نفسه، أي كجهازٍ يعيد تعريف الشرعيّة، والانتماء، والعدوّ، لا على مستوى القانون وحده، بل على مستوى الإحساس، والوجدان، والتصرّف، وفق ما يسمّيه فوكو، عبر ما أعادت بلورته جوديث باتلر (٢٠١١)، "الخطاب التنظيميّ".
إنّ التضادّ بين "المستوطن" و"الأصيل" لا يُشكّل مجرّد ثنائيّةٍ مفاهيميّة تُحرّك الخطاب الكولونياليّ، بل يُشكّل، في عمقه البنيويّ، آليّةً لإنتاج الهيمنة نفسها. فالاستعمار، كي يُثبّت وجوده بوصفه نظامًا، لا يكتفي بالاحتلال، بل يُعيد تشكيل العالم على صورته: فيُجنّس المُستوطِن ويُجرّد الأصيل من اسمه. هذه الهرميّة، وإن ظهرت في خطاب الهويّة والانتماء، لا تُختزل في الوعي أو الإيديولوجيا، بل تتجسّد ماديًّا في توزيع الأرض، وإعادة إنتاج علاقات الملكيّة، وتقنين العنف كوسيطٍ للتملّك؛ حيث تتمّ المصادرة لا بقرار قانونيّ فحسب، بل باعترافٍ رمزيّ ينزع الشرعيّة عن الأصل ويمنحها للتعدّي، إذ لا يكون "المستوطن" مجرّد فاعل اجتماعيّ، بل حاملًا لشرعيّةٍ مُفترضة، يُعاد تفعيلها مع كلّ عمليّة إعادة توزيع للمجال الجغرافيّ. غير أنّ هذه الثنائية لا تبقى على حالها. ففي مرحلة ما بعد التوسّع، يتحوّل التناقض: لا تُمارَس الهيمنة من قبل مجتمع مستوطن متجانس بل من خلال أجهزة السيادة ذاتها، تلك التي تُفرّغ الفعل الاستيطانيّ من خصوصيته المجتمعيّة لتُعيد صياغته كوظيفةٍ مؤسّساتيّة، تعمل بأدوات الدولة، باسم "القانون" لا باسم "الطلائعيّة". عندها، لا تُمحى ثنائية المستوطن/الأصيل، بل تُعاد قولبتها.
إنّ المشروع الاستيطانيّ لا يُنهي ذاته عند اكتمال الاستعمار؛ بل إنّ اكتماله لا يُعاش إلا من خلال إعادة إنتاج شروط نشأته، أي عبر محو الأصل وتثبيت الحاضر كـ"بديهة"، في حين أنّ هذه البديهة لا تكون إلّا لحظةً من لحظات صيرورة الاستعمار المستمرّ، لا كحدثٍ ماضٍ، بل كبنيةٍ راهنة. خلافًا لما يُروَّج له في الخطاب السائد، لا تنتهي البُنى الكولونياليّة بانفصال المستوطَنة عن العاصمة الكولونياليّة الأمّ. فالثقافة الاستيطانيّة لا تُغادر الاستعمار بل تُعيد تدويره، لا تهدم مركزه بل تُعيد إنتاجه من أطرافه. فالمشروع الاستيطانيّ، إذ يقطع علاقته الشكلانيّة بالمتروبول، لا يفعل ذلك إلّا ليُشيّد متروبولًا بديلًا، يحلّ محلّه، ويُكرّس ذاته كمرجعيّةٍ جديدة، لا زوالًا للبنية بل مضاعفة لها. وهنا يكمن جوهر المفارقة: فالاستعمار الاستيطاني لا يسعى إلى البقاء بوصفه استعمارًا، بل يسعى إلى محو ذاته كاستعمار، عبر إنكار وجود المُستعمَر. ليس الهدف الحفاظ على التفاوت بين السيّد والمقهور، بل على العكس، الغاية هي نفي التناقض بإلغاء أحد قطبيه: بتذويب الوجود السياسيّ للشعوب الأصليّة، لا عبر التفاوض معها، بل عبر إحلال هويةٍ وظيفيّة محلّها، هويةٍ لا تعود تعني "أصليّة" بل "أقليّة"؛ لا تعني "حضورًا سياسيًّا" بل "تصنيفًا إداريًّا"؛ لا تعني "حقوقًا تاريخيّة" بل "حاجةً أمنيّة" أو "عمالةً احتياطيّة". وهكذا، لا يتمّ إلغاء الأصيل جسديًّا فقط، بل رمزيًّا كذلك، عبر محو سرديّته التاريخيّة وتفكيك استمراريّته الزمنية. إنّها إعادة صياغة للأرض لا عبر الجغرافيا وحدها، بل عبر اللغة، والقانون، والمؤسّسة. فحين يُختزل الوجود الأصيل إلى أرقام سكانيّة، مصنّفة بين "معترف بها" و"غير معترف بها"، تُصبح المسألة الاستعماريّة مسألةَ إدارةٍ، لا مسألةَ تحرّر.15 وعند هذه اللحظة المفصليّة بالذات، تتكشّف عمليّة إعادة تشكيل العلاقة بين ثلاثة مكوّنات: مؤسّسات الدولة بوصفها أداة القسر المنظَّم، المستوطِن بوصفه حامل المشروع التوسّعي، والمُقتَلَع، بوصفه عنصرًا محوريًّا في معادلة الإلغاء المستمرّ.
في سعيه المحموم نحو التجانس القومي، لا بدّ من أن يُعاد تشكيل المستوطن بوصفه كائناً مشبعاً بالتصنيف الجنساني، وأن تُرفَع الأسرة إلى مقام التمجيد الرمزي، حيث تُعاد هندسة اللغة لتُطوِّع الجندر في خدمة العسكرة، فتغدو الرجولة المستوطِنة بنيةً إنتاجيّة لإعادة التوسّع، لا مجرّد دلالة ثقافيّة. فبهذه اللغة المسلّحة، يُعاد تكييف الجسد المستوطِن ليغدو أداةً وظيفيّة لاستدامة المحو. وفي هذا المعنى، لا يكون ما يُسمّى بـ"ما بعد الصهيونية" سوى محاولة متأخّرة لحلّ معضلة الاستيطان عبر إنفاذ "الإزالة النهائية" للمستعمَر: لا كمفعول سياسي فحسب، بل كحضورٍ ديموغرافي واجتماعي. إنّ تجديد البنى الاجتماعية بهذا الشكل، وإعادة إنتاج الوعي المواطناتي وفق هذا النسق، لا يمثلان خروجاً من مشروع الاستعمار، بل استمراراً له، حيث تُعاد صياغة العلاقات الاجتماعية في ما بعد لحظة الاستعمار الأولى، لا كتحوّل تاريخي، بل كاستمرار بنيويّ يعيد إنتاج آليات السيطرة من داخل المجتمع ذاته.
في استبطان المظلومية: القوميّة بوصفها سِحراً جندريّاً لما بعد الصهيونيّة
إنّ السعي من أجل اجتثاث الوعي الاستيطاني، في مشروعٍ استيطانيٍّ كولونياليّ، ليس إلّا سعيًا في سبيل بناء تصوّرٍ وطنيٍّ متناقضٍ في بنيته: تصوّرٌ يتأسّس على الانتماء إلى الوطنيّ، ولا يقوم إلّا على ارتهانه لما هو عبر-وطني، أي على تبعيّته لبنى القوّة العابرة للحدود. فالمستوطن، كما المواطن في دولة الاحتلال، لا يُقيم وجوده في وحدةٍ متماسكة، بل في ازدواجيّةٍ بنيويّة: هو، في آنٍ، فاعلٌ قوميٌّ منتمٍ للدولة، وفاعلٌ كوسموبوليتيٌّ مشدودٌ إلى منظوماتٍ عالميّةٍ من السطوة والامتياز. وهذه الازدواجيّة، في مشروع الدولة الكولونياليّة، ليست انحرافاً عارضاً بل شرطاً ضرورياً لاستمرار البنية الاستيطانيّة أمام مقاومة السكّان الأصليّين الذين لم يُهزموا. وهنا بالذات تنفتح أمام المشروع الصهيوني خياران متناقضان: إمّا القضاء على العدوّ الذي يوحّد – أي الفلسطينيّ – أو تفكيك البنية الاستيطانيّة ذاتها من خلال إنشاء دولة فلسطينيّة ذات سيادة. بهذا المعنى، يتحدّد الانتماء إلى الدولة الصهيونيّة بوصفه انتماءً يتصدّع في أساسه: إذ تصطدم مطالبة الدولة بالولاء الوطنيّ الجذريّ بالحاجة الدائمة إلى تغذيته من الخارج، من العابر للقوميّ. ومن رحم هذا التناقض بالذات، ينبثق خطاب ما بعد الصهيونيّة، لا بوصفه نقيضاً لبنيتها، بل كآليّةٍ لاحتواء الانقسام بين وطنيّةٍ مأزومةٍ وهويّةٍ عابرةٍ للقوميّ تُعاد صياغتها بما يخدم استمرار المشروع الاستيطاني في شكلٍ جديد.
إنّ ما بعد الصهيونيّة لا تقدّم مخرجًا موحّدًا من مأزقه البنيويّ، بل يتفتّت إلى استراتيجياتٍ متعدّدة، يتوسّل كلٌّ منها مفرداتٍ مختلفة لإدارة التناقض لا حلّه. بعضها يعتنق العولمة النيوليبراليّة، مُعوِّلًا على تذويب التوتّرات القوميّة في أسواق الكوسموبوليتانيّة، فيما ينكفئ بعضها الآخر إلى الداخل، متخيّلاً هويّةً يهوديّةً جديدة، تُعاد صياغتها عبر نقدٍ ثقافيٍّ أو تعدّديّةٍ شتاتيّة، تُخفّف من التماسك الترابيّ الحصريّ للدولة الاستيطانية. غير أنّ كُلَّ هذه المسالك، على اختلافها، تبقى أسيرة المأزق البنيويّ ذاته: كيف لمشروعٍ قوميٍّ أن يُبقي على نفسه، وأن يظلّ قائمًا ماديًّا وبنيويًّا، فيما شروط بقائه تقتضي خرق أُسسه القوميّة نفسها؟ إنّ المسألة، إذًا، ليست في تنوّع الاستجابات، بل في وحدة التناقض الذي يولّدها جميعًا: تناقض المشروع القوميّ مع ذاته، حيث يقتضي الاستمرار نفيًا لما هو في الأصل شرط وجوده – القوميّة ذاتها.
لا بدّ من حسم الهويّة الاستيطانيّة كي يُصار إلى انعتاق الدولة الاستيطانيّة من طابعها البنيويّ، وتحويلها إلى دولة-أمّة "حديثة". لكنّ هذا الحسم لا يتمّ إلّا عبر العائلة، بوصفها الموقع الذي تنتقل فيه المتخيّلات القوميّة – على نحو ما صاغه أندرسون في حديثه عن "الجماعات المتخيّلة" – ومن خلال "المرأة" كرمزٍ يُعهد إليه توحيد المجتمع الاستيطانيّ في مواجهة ما يُسمّى بـ"يد الإرهاب". وإذا ما استُحضرت أطروحة جيه-هيون ليم حول "قومويّة الضحيّة" (٢٠١٤)، تُدرَج الجندرانيّة في مصفوفة الوعي المعرفيّ بوصفها أداة إنتاج للمعنى، لا كهويةٍ قائمةٍ بذاتها. في الحقل الصهيونيّ، لا تُستَحضَر الضحيّة بوصفها ذكرى، بل بوصفها بنيانًا سرديًّا يُستهلك لغويًّا وتاريخيًّا على أساس الجندر. حين تُجندَر الضحيّة، تُستنهَض بوصفها نداءً إلى الوحدة القوميّة، لا لتحريرها، بل لإعادة هندسة الوظيفة العسكريّة في خطاب الدولة. فالضحيّة الأنثى، في هذا السياق، ليست شخصًا بل بنيةً إبستمولوجيّة، تؤسّس ثنائيّة الذنب الجماعيّ والبراءة الجماعيّة. عندها، تُبعث "الضحيّة" من جديد لا كمفعولٍ للاستعمار، بل كفاعلٍ في خطاب صهيونيّ يعيد إنتاجها ثقافيًّا بوصفها موقعًا لمواجهة الذات التاريخيّة. هي العائلة، لا بوصفها نواةً بيولوجيّة، بل بوصفها حيّزًا تُدمَج فيه البراءة والذنب ضمن كيانٍ تجانسيّ يُمكّن ما بعد-المستوطن من العبور إلى داخله. وهكذا، فإنّ تشكّل قوميّة الضحيّة في السياق الإسرائيليّ لا ينفصل عن الاشتباك البنيويّ مع حركات التحرّر، ولا عن موضوعها المستعمَر، ولا عن الدول "ما بعد-الكولونياليّة" التي تجاور الاستيطان.
في هذا المقال، عالجنا البُنية الجدليّة التي تربط المستوطِن بالمواطن. أمّا في المقال القادم، فسننتقل إلى تمفصلٍ مخصوصٍ من هذه الديناميّة: الدولة العابرة للحدود، لا بصفتها كيانًا ثابتًا، بل كحركةٍ دائمة – أي الشتات الإسرائيليّ. وسنبحث علاقته بالشتات الفلسطينيّ، بوصفهما طرفين في اقتصادٍ سياسيٍّ للحرب، يشتركان، وإن باختلافِ المواقع، في إعادة إنتاج شرط الحرب لا كحدث، بل كحالةٍ بنيويّة؛ وكجبهةٍ متعدّدة الأمكنة، لا كمسافةٍ بين جغرافيّتين. هدف هذا التحليل هو إضاءة جبهةٍ حاسمةٍ من جبهاتِ الصراع، لم نحسن، في خضمّ هذه الإبادة، التعبئةَ فيها لصالحنا، تاركين غزّة والضفّة وحدهما، في ميدانٍ أحاديّ الاختلال، لا توازن فيه إلا لمصلحة آلة الإبادة.
- 1. في لحظةٍ تُقدَّم فيها الدولة الاستيطانيّة كديمقراطيّة مهدّدة من داخلها، احتشد آلاف الإسرائيليّين في وسط تل أبيب، ضمن تظاهرات أسبوعيّة اعتراضيّة على مشروع "الإصلاح القضائيّ" الذي تقوده الحكومة الحاليّة، بالتزامن مع انطلاقة الدورة البرلمانيّة. لكنّ هذا الاحتشاد، وإن بدا تمرينًا ديمقراطيًا في فضاء مدني، لا يُقاس بشكله بل بوظيفته داخل البنية الأيديولوجية للدولة الاستعمارية. ليس الانقسام بين مؤيدي "الإصلاح" القضائي ومعارضيه إلا إعادة توزيع للتناقض بين الجهاز القانوني بوصفه جهازًا للهيمنة، ومن يدفع نحو تسريع الانكشاف الكامل للعنف بوصفه شرطًا للسيادة. بهذا المعنى، تتحدد "المواطَنة" لا كتجريد قانوني بل كعلاقة إنتاج داخل جهاز الهيمنة، تُعاد صياغتها بحسب الموقع في المشروع الكولونيالي. إنها مواطنة وظيفية، تُستدعى حين تحتاج الدولة إلى احتواء تناقضاتها لا إلى حلّها.
- 2. إن ما يبدو مأزقًا بيروقراطيًا هو، في جوهره، لحظة انكشاف للتناقض بين الشكل القانوني للدولة ووظيفتها الاستعمارية. فلا يُحلّ هذا التناقض بالإصلاح، بل بإعادة إنتاجه عبر استدعاء نموذج الكيبوتس وتكثيف مشروع الإبادة بوصفهما شرطًا لإعادة ضبط الهوية السياسية. في هذا السياق، تُعاد صياغة الهوية لا كموقع ذاتي، بل كوظيفة تُمارَس داخل جهاز الدولة، حيث تتقاطع آليات الانتماء مع أنماط القمع. إن تسارع العنف لا يُفهم كمجرد استجابة ظرفية، بل كآلية بنيوية تعيد تأكيد العلاقة العضوية بين تشكيل الذات القومية وآلة الإبادة، بما يجعل من الهوية ذاتها شكلًا من أشكال العنف المؤسسي.
- 3. إن قولي بـ"ما بعد الاستعمار" لا يُراد به، كما قد يُظنّ، الإشارة إلى حالة تاريخيّة اكتملت، بل إلى خطاب يُنتج الوهم بوصفه معرفة. فإسرائيل، بما هي كيان استيطانيّ رأسماليّ، لم تكن في يوم من الأيام مستعمَرةً ثم تحرّرت، لكي يُقال فيها "ما بعد الاستعمار"؛ بل هي الاستعمار وقد تمأسس كدولة. أمّا "ما بعد الصهيونيّة"، فإنّه ليس نقيض الصهيونيّة، بل قناعها الأخير. لا يُقدّم هذا الخطاب نقداً للصهيونيّة بوصفها مشروعاً تاريخيّاً عنصريّاً، بل يعيد إنتاجها كهوية ليبراليّة متصالحة مع ذاتها، باذلةً في ذلك مفردات "الكوزموبوليتانيّة" و"الدولة المدنيّة" لتُخفي بذلك عنف التأسيس الذي لم يتوقّف. هنا لا يتجلّى التناقض بين الصهيونيّة وما بعدها، بل يتكرّس التماهي العميق بين المشروعَين: فـ"ما بعد" لا يُجاوز، بل يُعيد إنتاج ما كان تحت مسمّى التقدّم. ولذلك، فإنّ ما يُطرح كقطيعة هو في جوهره امتداد. وهذا ما تنبّهت إليه نورة عريقات (٢٠١٩) حين أشارت إلى أنّ النقد الفلسطينيّ لا يُوجّه إلى "ما بعد الصهيونيّة" كمفهوم، بل إلى استمراريّة الصهيونيّة التي يتوهّم الخطاب أنّه تجاوزها، وهو في الحقيقة لم يفعل، لأنّه لا يستطيع إلّا أن يكون امتداداً لها، ما دامت شروطها المادّيّة لم تتغيّر. ما دام يعيد إنتاج وهم التقدّم بوصفه تجاوزاً للتاريخ، لا بوصفه صراعاً داخل بنيته.
- 4. وهي الوسائط الإعلاميّة الثلاث التي يتم تحليلها هنا.
- 5. https://www.haaretz.com/israel-news/2023-04-07/ty-article/three-israelis...
- 6. https://edition.cnn.com/2023/02/26/middleeast/west-bank-violence-intl/in...
- 7. https://www.haaretz.com/israel-news/2023-02-27/ty-article/.premium/israe...
- 8. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-65211160
- 9. https://www.haaretz.com/israel-news/2023-04-07/ty-article/three-israelis...
- 10. https://www.haaretz.com/israel-news/2023-02-27/ty-article/.premium/israe...
- 11. https://edition.cnn.com/2023/05/04/middleeast/israel-idf-operation-kills...
- 12. https://edition.cnn.com/2023/02/26/middleeast/west-bank-violence-intl/in...
- 13. https://imemc.org/article/10216/
- 14. ليست الصهيونيّة، كما تُفصح عنها بنية الدولة الإسرائيليّة، مجرّد مشروعٍ لتأسيس وطنٍ قوميّ، بل هي، كما تتبدّى في أطروحة كلّ من جيف هالبر (٢٠٢١) وإيلان بابيه (٢٠٠٨)، مشروعٌ استيطانيّ جوهريّ، لا يتقدّم إلّا بنفي الآخر الذي عليه يُقام. فوجود الفلسطينيّ، بما هو وجودٌ تاريخيٌّ على الأرض، يُصبح نقيضًا لا يُطاق لبنية الدولة، ويُستدعى نفيُه لا كفعلٍ عرضيّ بل كمقدّمةٍ تأسيسيّة لبناء مجتمعٍ يهوديّ جديد، يُنكر الأصل كي يُؤسّس ذاته كأصل. هكذا، لا يكون محو الفلسطينيّ حادثةً في مسار التوسّع، بل هو شرطٌ بنيويّ لولادة الكيان.
- 15. وغالبًا ما يتّخذ هذا الإلغاء شكلَ إنشاءِ بُنى سلطويّةٍ تابعة، تُحاكي السلطة ولا تُمارسها، وتُقسّم السكّان إلى وحداتٍ مجزّأة، منزوعيّة السياسة، مُفرَّغة من الفعل التاريخيّ. فحين تُمنَح هذه البُنى – كأدوات "محليّة" لإدارة القمع – هامشًا شكليًّا للتحرّك، فإنّ الدولة المستوطِنة لا تفعل سوى توكيل السيطرة، لا تفويض السيادة. ولأنّ وظيفة هذه الأدوات ليست التمثيل بل الاحتواء، فإنّ لحظة تمرّدها لا تُفهم كتحوّل في الوعي، بل كخيانةٍ وظيفيّة، تتطلّب القمع لا الحوار، والمحو لا الإصلاح. ولذلك، حين تُعيد أدواتُ الاحتلال نفسها كحواملَ لمقاومةٍ أهليّة، لا كامتدادٍ لسلطة الاحتلال، تنقلب العلاقة من شراكةٍ في الإدارة إلى مواجهةٍ في السيادة. وهنا، يُلمّح نتنياهو – بلغةٍ لا تستبطن الأمن بل الموت، لا تُدير الحياة بل تُسيّجها بالقتل – إلى ضرورة محوٍ نيكرُوبوليتيكيّ، أي إلى قتلٍ لا ضرورة له إلّا في كونه ضروريًّا للحفاظ على وهم السيطرة. إنّها إذًا لحظةٌ تتجلّى فيها استعارةُ فوكو حول السلطة، لا كحقّ في الحياة، بل كحقٍّ في القرار: من يَحيا ومن يُمحى. فالاحتلال لا يكتفي بإدارة أدوات الإخضاع، بل يُعيد إنتاجها في كلّ مرّة تثبتُ فشلها؛ لا لأنّها فشلت في القمع، بل لأنّها نجحت في التحوّل إلى نقيضه. وهكذا، تُصبح البنية القمعيّة ذاتها مهد التمرّد، وتُصبح إعادة الهيمنة ممكنةً فقط عبر العنف، لا كاستثناء، بل كشرطٍ بنيويّ لدوام الاحتلال.
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.
Agassi, Judith Buber. “Theories of Gender Equality: Lessons from the Israeli Kibbutz.” Gender and Society 3, no. 2 (1989): 160–86.
Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge, 1993 [2011].
Cockburn, Cynthia. “A Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace.” In Sites of Violence: Gender and Conflict Zones, edited by Wenona Giles and Jennifer Hyndman, 24–44. Berkeley: University of California Press, 2004.
Erakat, Noura. Justice for Some: Law and the Question of Palestine. Stanford: Stanford University Press: 2019.
Evans, Ivan. Bureaucracy and Race: Native Administration in South Africa. Berkeley: University of California Press, 1997.
Fogiel-Bijaoui, Sylvie. “Women in the Kibbutz: The ‘Mixed Blessing’ of Neo-Liberalism.” Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies & Gender 13 (2007): 102–22.
Gordon, Todd. “Capitalism, Neoliberalism, and Unfree Labour.” Critical Sociology 45, no. 6 (2018): 921–39. https://doi.org/10.1177/0896920518763936.
Halper, Jeff. Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionism, Settler Colonialism, and the Case for One Democratic State. London: Pluto Press, 2021.
Lim, Jie-Hyun. “Victimhood Nationalism in the Memory of Mass Dictatorship.” In Mass Dictatorship and Memory as Ever Present Past, edited by Jie-Hyun Lim, Barbara Walker, and Peter Lambert, 33–61. London: Palgrave Macmillan, 2014.
Massad, Joseph A. “Conceiving the Masculine: Gender and Palestinian Nationalism.” Middle East Journal 49, no. 3 (1995): 467–83.
Mayer, Tamar. “From Zero to Hero: Masculinity in Jewish Nationalism.” In Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation, 283–308. London and New York: Routledge, 2000.
McClintock, Anne. Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest. New York: Routledge, 1995.
Mosse, George L. Confronting the Nation: Jewish and Western Nationalism. Hanover & London: Brandeis University Press, 1993.
Pappé, Ilan. “Zionism as Colonialism: A Comparative View of Diluted Colonialism in Asia and Africa.” South Atlantic Quarterly 107, no. 4 (2008): 611–633.
Rosenhek, Zeev, and Michael Shalev. “The Political Economy of Israel’s ‘Social Justice’ Protests: A Class and Generational Analysis.” Contemporary Social Science 9, no. 1 (2013): 31–48. https://doi.org/doi:10.1080/21582041.2013.851405.
Rouhana, Nadim. Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in Conflict. New Haven: Yale University Press, 1997.
Shafir, Gershon. Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Shalhoub-Kevorkian, Nadera. Militarization and Violence against Women in Conflict Zones in the Middle East: A Palestinian Case-Study. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Shlaim, Avi. The Iron Wall: Israel and the Arab World. New York: W. W. Norton, 2000.
Shohat, Ella. “Zionism from the Standpoint of Its Jewish Victims.” Social Text, no. 19/20 (1988): 1–35. https://doi.org/10.2307/466176.
Stoler, Ann Laura. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley: University of California Press, 2002.
Veracini, Lorenzo. Settler Colonialism: A Theoretical Overview. London: Palgrave MacMillan, 2010.
Weizman, Eyal. Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation. London: Verso, 2017.
Wolfe, Patrick. “Settler Colonialism and the Elimination of the Native.” Journal of Genocide Research 8, no. 4 (2006): 387–409. https://doi.org/10.1080/14623520601056240.
Zertal, Idith, and Akiva Eldar. Lords of the Land: The War over Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967-2007. New York: Nation Books, 2007.