عدوى السموم
رولا علاء الدين هي مترجمة تعيش في بيروت، وتملك ما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة في مجال الترجمة والترجمة الفورية في اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. بالإضافة إلى حصولها على إجازة في علم اللغات والترجمة، تواصل رولا تعليمها الأكاديمي في مجال الوساطة، وتركز على الوساطة في النزاعات التي تشمل المهاجرين/ات واللاجئين/ات، مع اهتمام خاص على دور اللغة في الثقافة والنزاعات. قادها عملها مع اللاجئين/ات والمهاجرين/ات في لبنان للانخراط في الدراسات المرتبطة بالمهاجرين/ات، مع تركيز على الهجرة المتعلقة بالعمل بشكل عام، والعمّال/ العاملات المهاجرين/ات في لبنان تحديدًا. يستكشف بحثها الحالي دور المسارات العالمية والمحلية للهجرة المرتبطة بالعمل في تكوين القصص الفردية والحميمية للأفراد المهاجرين/ات.
kohl_closeup3.png
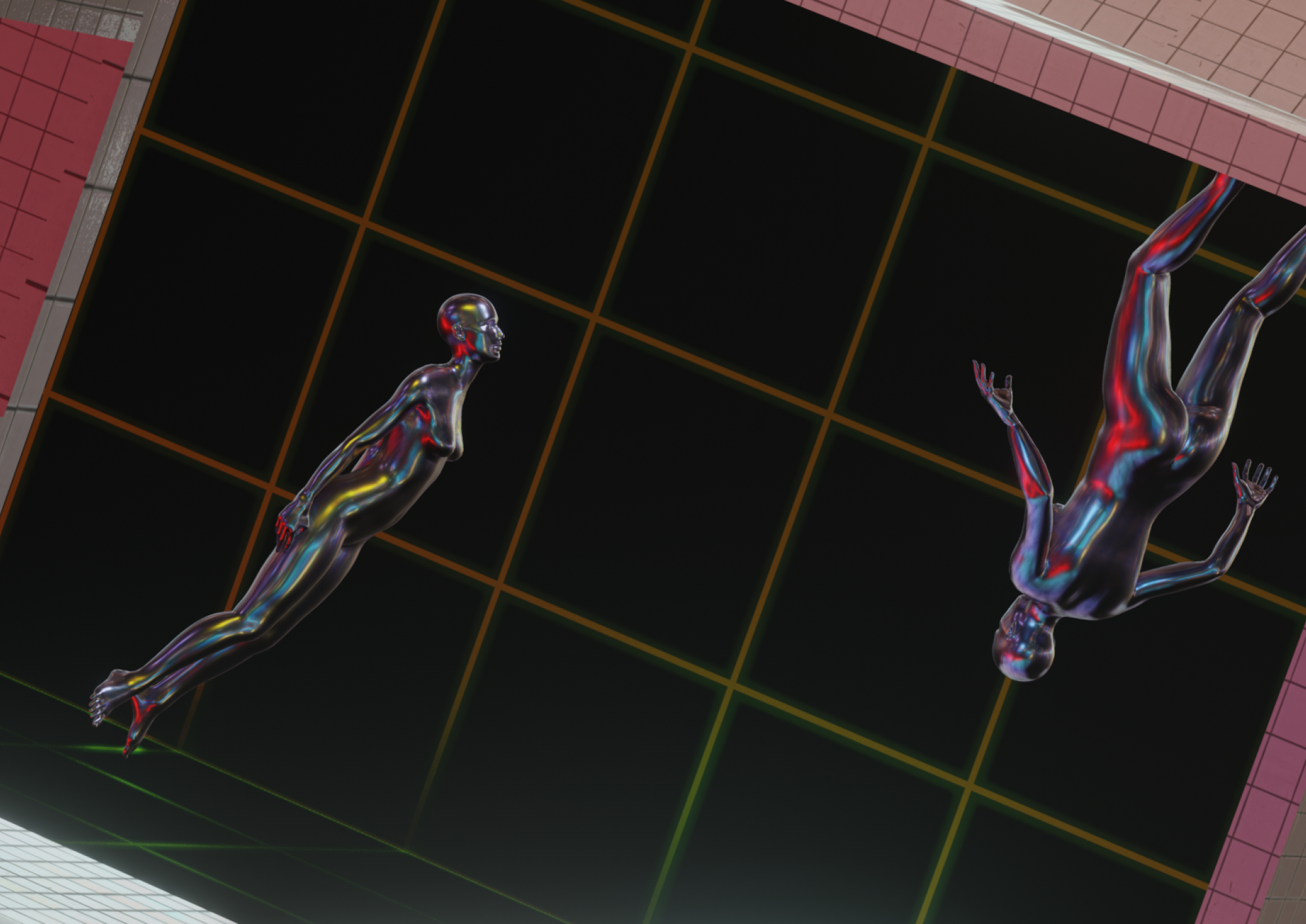
ظننت أنّي سأمضي وقتي على الطائرة أفكّر بكِ وبسبب رحيلي، إلا أنّه يصعب عليّ التفكير بكِ على الإطلاق تماماً كما صَعب عليّ أن أجد ما أقوله لكِ قبل رحيلي. وها أنا أجد نفسي أفكر بأوّل مرّة كنت فيها على متن طائرة. يأتيني مشهد أمّي وهي تخفي في حقيبة اليدّ أدوات الطعام الفضّية. فالطائرات في تسعينيات القرن الماضي لم تكن قد تحوّلت بعد إلى ساحات حرب على الإرهاب، والخطوط الجوّية الاسكندينافية كانت تقدّم وجبات الطعام مع الأدوات الفضّية. كانت هذه الأدوات تحمل إسم عمّي لأنّه هو من صمّمها، ويمكن بالتالي القول إنّ أمّي لم تكن تسرق بل كانت تستعيد الملكية التي استحوذتها شركة الطيران. ينتمي عمّي ’بو‘ إلى جيل الفنّانين الذين يشتكون من أنّ الفنانين الأصغر سنّاً لا يعرفون كيف يرسمون. ومن يرى أعماله لا بدّ أن يوافقه الرأي. عندما أقام عمّي في فندق تشلسي في أواخر ستينيات القرن الماضي، قدّم رسوماته بدلاً لأجر غرفته بعد أن أقام فيها ثلاثة أشهر هادراً موهبته وغارقاً في الخمر. لقد أهدر ما هو أهمّ من ذلك. أيّام طفولتي، كان يظلّ عارياً لا يغطّي جسده إلّا بعباءة، يجلس أمام لوح الرسم، ويحمل القلم في يده بثبات بالرغم من كأس الويسكي في اليد الثانية – ويسكي ممزوج بالماء لأنّها كانت الساعة العاشرة صباحاً – ويدندن على ألحان موسيقى الجاز التي لحّنها أباه. يراودني بشأنه الحلم المتكرّر ذاته حيث أراه جالساً على كرسيه الخاص بالرسم في وسط زحمة السير في مانهاتن ويغمزني بعينه وكأنّه يطمئنني ويؤكّد لي صحّة إيماني بأنّه سيعمّر ويعيش أطول منّا جميعاً.
في عالم اليقظة، لم يفِ عمّي بوعده هذا. بعد مرور عشر سنوات على دخول أدوات الطعام التي صمّمها ضمن تجربة السفر الاسكندينافية، قامَ بقطع شرايين يده في الحمام بعد أن ضاق ذرعاً بالانسداد الرئوي المزمن الذي يعاني منه وبقلبه المنفطر منذ وفاة زوجته، وهي شقيقة أمّي، قبل سنوات قليلة. انتظر ستّ عشرة ساعة ليأتيه الموت بفعل النزيف الدموي. يعني ذلك أنّه اضطر إلى ترطيب الجرح مراراً كي يستمر الدمّ في السيلان. كانت العائلة، وفيها عددٌ من الأطباء، في حالة ذهول. "لماذا لم يلجأ إلى الحبوب؟!" قال أحد أبناء العمّ إنّهم لو عرفوا بوضعه لقادوه إلى سويسرا، حيث المساعدة على الموت ليست خطيّة، كي يتخلّص من عذابه. ذهب عمّي تاركاً لنا طلباً مستحيلاً: ألّا يكون لموته مراسم دفن. نفّذنا ما طلبه عبر تحويل انتحاره إلى مسألة محرّمة. نادراً ما نأتي على ذكره، لكنّ البيت الذي بناه ما زال قائماً وابن عمّي الذي بات مالك البيت يدعني أستخدمه أحياناً. هكذا جئتِ لتمضية ليلة هناك الصيفَ الماضي. لعلكِ ظننتِ أنّه يمكنكِ أن تتسللي من دون أن يراكِ أحد، لكنّ عمّي كان قد زوَّد المرآب بنظام إضاءة يضيء العقار كلّه عند أقلّ حركة.
طاردتني أيضاً أضواء عمّي هذه طوال الصيف الذي غادرَنا فيه. كنت مقيمة في عمّان وقتها وكنت أعجز عن النوم حتى صلاة الفجر وتراودني صورة الرجل المنهار في حوض الاستحمام وقد خارت قواه لدرجة أنّه عجز عن قتل نفسه. هل يكون وقع الخسارة مختلفاً بالنسبة لمن يؤمن بالآخرة؟ لو كنّا عائلة من المؤمنين هل كنّا سنتصرّف بشكلٍ مختلف تجاه فعلة عمّي السيئة؟ طرحت هذه الأسئلة على صديقتي المقرّبة لينا. كنّا نتمشّى ليلاً في البلدة الصغيرة التي غادرناها كلانا بعد المدرسة الثانوية ولم نعد إليها إلّا للتوديع مجدداً. لينا التي كان والدها يحتضر بسبب مرض السرطان وصفت لي وجعها قائلةً: "كأنك تحبسين أنفاسك ورأسك فوق الماء. تشعرين برأسك يحترق وكلّ ما تريدينه هو أن تغمسيه في الماء، ولكنك عاجزة عن ذلك لأنّ أنفاسك مقطوعة".
مشينا في شوارع الضواحي التي لا تضيئها إلّا الثريات داخل المنازل حيث اجتمعت العائلات احتفالاً بعيد الميلاد. مررنا بملاعب كرة المضرب التي شهدت في الماضي على سعينا لفقدان عذريتنا. كنّا وقتها نتوق لنكبر ونتمكّن من مغادرة هذا المكان. هذا الغليان، كما تبيّن لي لاحقاً، هو حالة اعتيادية. نعم، الشراهة خصلة من خصالي لا سيّما عندما أكون معكِ. أذكر ذاك الصباح قبل سنتين حين استفقنا من النوم في بيروت وجسدانا متشابكان، نكاد نغرق في عرقنا، واللهبة للآخر ما زالت فينا.
أتذكرين يوم الأحد ذاك حين مشينا لننضمّ إلى مسيرة المرأة؟ كلّ أخواتي اللبنانيات والاثيوبيات كنّ هناك وعَلَت أصواتهنّ، وكانت عيناكِ الخضراوتان تضيقان بفعل وهج الشمس في أولى أيّام الربيع. "الكويرية لامتناهية!" شعارٌ كتبته صديقاتي على أحد الجدران يومَ انتفضت بيروت، وبالفعل هذا ما شعرنا به وقتها. لم نكن نعرف ما الذي يحصل لنا ولأجسادنا. لم يكن بوسعنا أن نتوقّع ما جرى للمدينة، لكنّنا علمنا أنّ ما يجري سيتخطى عوالمنا الصغيرة وأحداثها الدرامية. شعرنا أنّ كلّ شيء ممكن في تلك الفترة الوجيزة التي شهدت غضباً بين آلات البيع في الشوارع، وعناقاً بين الغرباء في الساحة. كان دمكِ في فمي.
علمتني النظريات السياسية الكثير عن مفهوم الأخوّة، لكنّ النساء في الساحة هنّ من علّمنني معنى الأخت. الأخت ليست صديقة، فهي لا تسعى لتحسين مشاعري بل لتعليمي، ومن المهمّ أن أستمع وأتعلّم.
بعد أقلّ من أسبوع تمّ إعلان الإغلاق الشامل في مختلف أنحاء العالم ومعه انتهى الدرس الأوّل لي. وما كنت قد تعلّمته لم يهيّئني لحالات التسمّم المتربّصة بنا.
نحن الناجون من انفجار 2750 طنّاً من نيترات الأمونيوم في بيوتنا وفي عقولنا، يوم الرابع من آب 2020، مدَّدنا حدودَ لامحدوديتنا في الأشهر التي تلت. إنّ انفجار مرفأ بيروت قسَّم المدينة إلى حيّزيْن: حيّز الملائكة وحيّز الخَطأة. الملائكة هم الشهداء المدفونون تحت الركام والمفقودون الذين تعذَّر دفنهم. أمّا الخطأة فهم الساسة الملطّخة أيديهم بالدماء الذين استحالت مقاضاتهم. وبين الإثنين هناك الناجين والناجيات، لبنانيين وغير لبنانيين، الذين نظّفوا المدينة من الركام وأعادوا بناءها.
كنّا نعيش كارثةً من دون أيّ دليل إرشادي لعبورها. أصدقائي الذين نشأوا في الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي قالوا إنّ ما يحصل الآن أصعب بكثير من تلك الأيام. في الجامعة الأميركية في بيروت، قامت إحدى الأساتذة باعتماد الخيال العلمي لفهم الواقع اللبناني1، ولتخيّل مستقبل مختلف. لكنّ مخيّلتنا خارت قواها. "الأمونيوم"، المادة الغريبة التي شظّت نوافذنا وتسللت إلى أجسامنا، باتت صيغة مجازية تعبّر عن كلّ ما يقتحم حياتنا وكلّ ما هو بغيض. لقد لجأنا إلى الخيال لوصف واقعنا.
" نحن نحلّق فوق كرة نار"، هذا ما قالته ’ليلا‘ لصديقتها ’لينو‘ في عالمهما الموازي عبر البحر الأبيض المتوسط.2 "يطفو الجزء الذي برد على الحمم، وعلى هذا الجزء نشيّد المباني والجسور والشوارع. وبين الحين والآخر، تتدفق الحمم من جبل فيزوف أو تتسبب بهزّة أرضية تدمّر كلّ شيء. هناك جراثيم في كلّ مكان تجعلنا نمرض ونموت. هناك حروب. هناك فقرٌ يجعلنا جميعاً قساة. في كلّ لحظة يمكن أن يحصل ما يتسبّب لك بالعذاب وستستنزفين دموعك سريعاً. وماذا تفعلين؟"
ما الذي نفعله بأنفسنا؟ يُقال إنّ من ينجو يحمل معه شعوراً بالذنب. انحسر مفعول الأدرينالين الناتج عن الانشغال بالمساعدة في أعقاب الحدث، وأعيد توجيه اتجاه السؤال الاتهامي الجَماعي، "ما الذي فعلوه بنا؟"، نحو الذات. لم يكن كافياً أننا كنّا نستنشق ذرات الألياف الزجاجية من بيوتنا المدمّرة وأقدامنا ترتطم بالزجاج الذي غطّى شوارع المدينة، بل صرنا نستهلك أجسادنا أيضاً بين الأطباق التي توزَّع في المنازل التي نزورها. في إحدى الليالي، أغميَ عليّ وسقطت أرضاً في الحمام. صحوت بعدها وأنا ألهث. "هذا أمر طبيعي". هكذا علّق أصحابي على ما حصل مع بعض القلق المكتوم. مشينا متأبطين بعضنا البعض في طريق العودة إلى البيت ورمينا حمل قلقنا الممزوج بالكوفيد وبالكلاميديا. لم نكن محميين. كيف يحمي المرء نفسه وقد تمّ تفجيره أشلاءً؟ لم نكن حريصين تجاه بعضنا البعض… وأسمينا ذلك مجتمعاً. حاولنا قتل أنفسنا… وأسمينا ذلك بقاءً. كان هذا نوع من العلاج بالصدمة. هذا كلّ ما قدرنا على فعله وقتها كي نحافظ على أنفسنا.
لقد تفككنا سريعاً كما اجتمعنا سريعاً. أنا وأنتِ هذا الشتاء صرنا ندير ظهرنا لبعض وننام. استيقظت قبلك ومشيت إلى أقرب بلدة وشمس كانون الأوّل ساطعة، ليس لشيء إلّا لأبتعد عنكِ. أن أرحل أفضل من أن تلتهمني نيرانك. لقد قضيتِ الشتاء مستلقيةً في اكتئاب جسدك في غابة طفولتك، تتساءلين لماذا لم تكن ظروفك مختلفة. كيف أمكنكِ أن تقبعي هناك كلّ هذا الوقت في جليد كانون الثاني؟ ألم تشعري بشيء أم أنكِ، على العكس، أفرطتِ في الشعور؟
إذا كانت الكويرية لامتناهية، فماذا يعني أن ننسج الروابط والحميمية على أساس اللامحدودية؟ ماذا يحصل للصداقة لمّا يكون اللامتناهي هو مبدأ حياتنا؟ فلنفترض مثلاً أنكِ وقعت في غرام أخت لكِ، فما علاقة القرابة التي تربطكما حينها؟
"أن تكوني كوير يعني أن تدخلي الفراش مع أصدقائك وتخرجين منه برابط صداقة أقوى"، هذا ما قالته صديقتي ’س‘ وهي تلعق صلصلة الثوم عن شفتيْها. "يجدر بنا ممارسة الحب مع أصدقائنا كطريقة لنسج الروابط معهم ولرعايتهم". كنّا يومها في أعقاب ليلة صاخبة قضيناها في ملهى البالروم في بيروت. أثرنا ليلتها قلق حارس الملهى الذي حذّرنا بتهذيب أنّه يجدر بنا التوقّف عن التقبيل قبل أن يتصل أحدٌ ما بالشرطة. أجبت: " تلتقي صبيّة بصبيّ، تخسر الصبيّة الصبيّ، تستعيد الصبيّة الصبيّة الظريفة3، إلّا أنّنا في هذه الحالة نعود كلنا معاً إلى المنزل". إنّ نظرة ’س‘ للصداقة الكويرية أعادت إلى ذاكرتي أغنية "freexone" (المساحة الحرّة) لجانيت جاكسن التي شغلتنا أنا وصديقاتي في تسعينيات القرن الماضي والتي كانت موسيقى أيام صبانا. لم نكن نفهم وقتها معنى الكلمات التي نغنّيها ولكننا أدركنا راديكاليتها. تبدأ أحداث الأغنية على متن طائرة، تماماً كما بدأت دورة أفكاري هذه. وفيما أكتب الآن، أتذكّر كيف تنتهي الأغنية. في المقطع الثالث (Xone 3) تستبدل جاكسن ثنائية العلاقات المثلية/المغايرة أحادية الشراكات العاطفية إلى التوصية التالية: "أحبّ/ي أختك، أحبّ/ي نفسك".
ضمن مجموعة العلاقات العاطفية الكويرية (تعددية الشراكات العاطفية) لا وجود لمفهوم "الحصول" على شخص أو "فقدان" شخص. في العلاقات الكويرية، ننشئ صلات القرابة. هذا ليس أمراً سهلاً لأنّ العلاقات العائلية تتسم بالصعوبة، حتى تلك التي نختارها اختياراً ولا تُفرَض علينا، وأحياناً نخسر هذه العلاقات بفعل الظروف الخارجية. الكويرية لامتناهية، ولكنّها ليست منيعة ضدّ سموم العنف الذي تمارسه الدولة وضد الأمراض الجماعية التي تتناقل حولنا وتجعلنا نرغب في ما قد يؤذينا. بوسعنا أن نجعل من الأصدقاء أقرباءً ولكن لا يمكننا أن نحميهم من العالم الذي نعيش فيه حتى ونحن نسعى لتغييره. لمّا تحرقنا قوى غير مسمّاة بالغاز المسيّل للدموع وتحوّلنا مواداً إشعاعية، كيف لنا أن نتجنّب الاستنزاف وانهيار صفتنا التعاضدية؟ كيف نحرص على ألّا ينتهي بنا المطاف وحيدين على أرض الحمّام؟ هل فينا ما يكفي من إرادة؟
- 1. https://www.societyandspace.org/articles/teaching-science-fiction-while-living-it-in-lebanon
- 2. رواية للكاتبة إيلينا فيرانتي، 2012، ’صديقتي المذهلة‘Ferrante, Elena (2012). My Brilliant Friend. New York: Europa Editions, p.261.
- 3. من أغنية جانيت جاكسن "Free Xone" 1997
