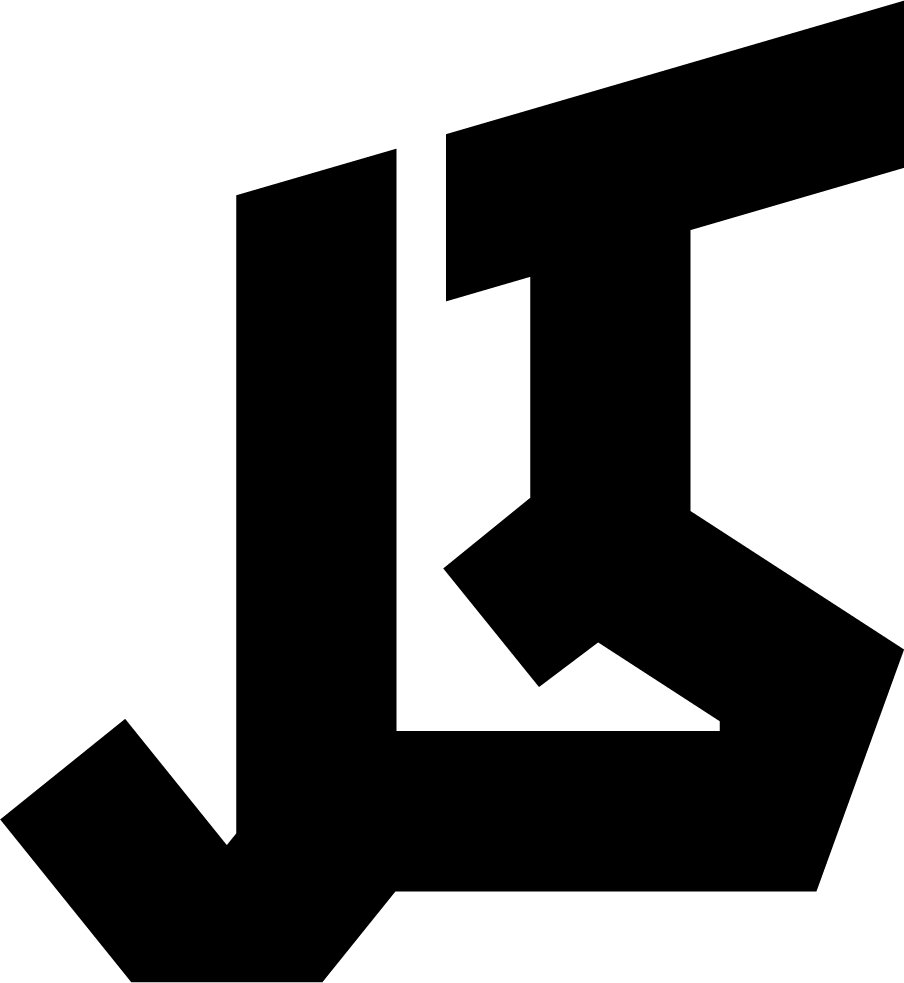قومٌ بلا دولة: تشكيل الهوية الفلسطينية والعنف البنيوي في لبنان
nation_without_state_ar.jpg
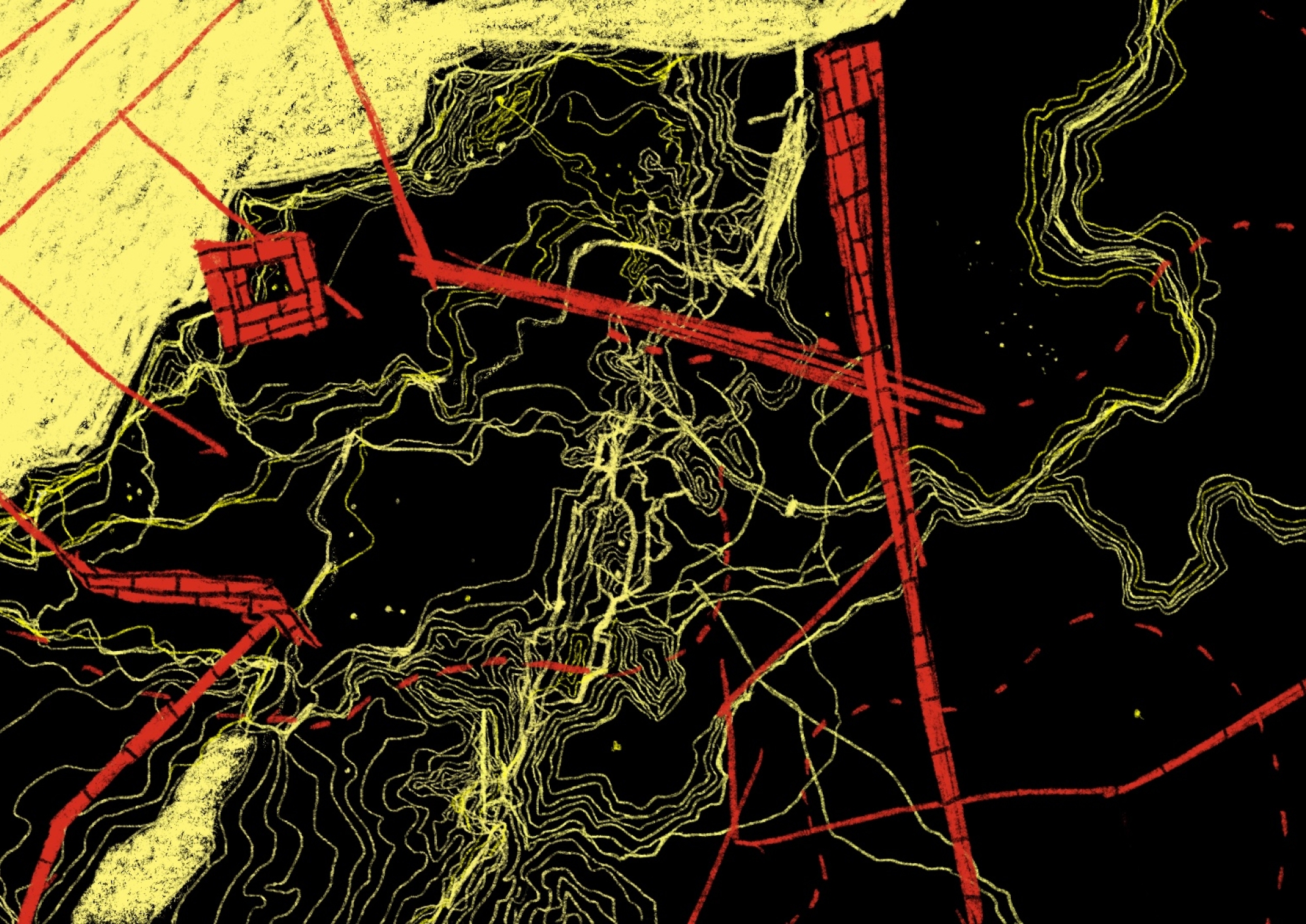
ميرا المير
المقدّمة
تقدّم هذه المقالة دراسةً لمناشئ تَشَكُّل الهويّة الفلسطينيّة في لبنان، متتبّعة بذلك الديناميات الثقافية والسياسية والتاريخية في منطقة المشرق العربي ضمن فترة ما قبل الحداثة، مروراً بنكبة عام 1948 وما يُسمّى بـ"الحرب الأهلية اللبنانية"، وصولاً إلى الزمن الراهن. الحضور الفلسطيني في لبنان ليس شاذّاً عن ظاهرة الدولة القومية، بل هو ركنٌ من تبايناتها (Zebdawi 2021; 2024). وعلى امتداد هذه اللحظات المفصلية، تشكّلت التجربة الفلسطينية تحت ضغطٍ مزدوج: ضغط خارجي فَرَضَ حالة انعدام الجنسية، وضغط داخلي سعى إلى بلورة هوية وطنية متمايزة، متجذّرة في المقاومة والذاكرة وحقّ العودة. ومن هذا المنظور، تُدرَس حالة انعدام الجنسية لا بوصفها مصدراً للقيود فحسب، بل أيضاً منبعاً للبصيرة (Zebdawi 2020)، إذ تكشف محدودية إطار الدولة القومية التي تبدو، في أفضل صورها، قاصرة، وفي أسوئها عنيفة بنيوياً و"محكومة بالفشل". ومع ذلك، يبقى قيام الدولة الفلسطينية ضرورة لا تحتمل المساومة.
في المشرق، ولا سيما في بلاد الشام، ساد منذ زمنٍ طويل خطابٌ اختزاليّ يصوّر "الهوية الوطنية" والسياسات الطائفية بوصفهما المحرّكَين الأساسيين لمعظم الصراعات المسلّحة في التاريخ المعاصر للمنطقة. غير أنّ الحالة الفلسطينية تكشف حدود هذا التصوّر، إذ تُبرز قصور الإطار الحديث للدولة القومية ذات الطابع الكولونيالي الجديد. فالفلسطينيون المنتشرون في أرجاء المشرق، ومن بينهم من يُعَدّون قانونياً عديمي الجنسية لكنهم على درجةٍ عالية من الوعي والانخراط السياسي، يجسّدون في الوقت نفسه الترابط العضوي بين دول المنطقة، ويقوّضون بصورة جوهرية البُنى القُطرية التي تسعى إلى تهميشهم وإقصائهم. إنّ وجودهم لا يمكن اعتباره طارئاً أو ثانوياً، بل هو تعبير حيّ عن نقدٍ جذري للتناقضات وأشكال العنف البنيوي الكامنة في النظام الاستعماري الجديد.
نضع هذا التحليل في إطارٍ أوسع يرمي إلى نقد الدولة القومية ذاتها، مقاربين تأسيسها وبنيتها واستمراريتها كأشكالٍ ممتدّة من العنف الاستعماري الجديد، الهادف إلى إنتاج هويات هرمية تُصنَّف بين الانتماء واللاانتماء. فالإدماج والإقصاء يخضعان للمبدأ ذاته: مبدأ الهيمنة، فيما يمثّل النفي الممنهج لقيام الدولة الفلسطينية ليس إخفاقاً عرضياً، بل ضرورة بنيوية في مصفوفة الدولة الاستعمارية. نستند في تنظيرنا لهذا الطرح، إلى مفهوم إتيان باليبار حول "أسطورة" الأمّة: لا باعتبارها كذبة، بل بوصفها سردية تأسيسية يُقدَّم من خلالها تاريخ الدولة على أنه متّصل، محتوم وطبيعي، في حين يجري إغفال تصدّعاته وإقصاءاته وأشكال عنفه على أنواعها.
في السياق اللبناني، وضمن إطار نظام الحوكمة الطائفية، ورغم الإقصاء العنيف الذي يتعرّض له الفلسطينيون من بنى الدولة، يكشف الوجود الفلسطيني زيف أسطورة الأمّة، ويفضح وهم المشهد المشرقي "المُقنَّن ديموغرافياً". غير أنّ الانقسامات السكّانية في كلٍّ من الأردن وسوريا تؤكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على لبنان، بل تعبّر عن شرطٍ إقليمي متجذّر في بنية الدولة القومية ما بعد الاستعمارية. إنّ تواريخ الفلسطينيين وسردياتهم وآفاقهم المستقبلية تتجاوز الحدود السياسية، وتستمرّ رغم التهجير، لتقدّم شكلاً حيّاً من المقاومة التي تتحدّى أنماط الإقصاء البنيوي التي تفرضها الدول.
في السياق ذاته، وبصفتنا كاتبتين وباحثتين، فلسطينية وسورية، فقد عايشنا وشهدنا على نحوٍ مباشر التداعيات العميقة للعنف الاستيطاني–الاستعماري "الإسرائيلي"، بما في ذلك استشهاد أحبّاء لنا في الإبادة الجارية في غزّة، والخسارات المتواصلة التي أشعلتها وحشية الاحتلال في الضفة الغربية. نرى أن استعادة الإرادة الفكرية والتاريخية تمثّل مهمّة عاجلة وملحّة في آنٍ واحد؛ إذ لا ينهض هذا العمل بوصفه تدخّلاً أكاديمياً فحسب، بل يشكّل أيضاً رفضاً قاطعاً للسرديات المفروضة التي تشرعن السلب والتهجير والمحو. نسعى من خلال الكتابة، إلى تكريم ذكرى من فُقِدوا، وإلى مواجهة البُنى الأيديولوجية التي تكرّس معاناتهم المستمرّة. من خلال مقارعة منطق الاحتلال بمنطقنا نحن، نطمح إلى الإسهام في صياغة سردية مضادّة، متجذّرة في تفاصيل الحياة اليومية، وفي التاريخ المشترك، وفي المخيّلة السياسية لمن استشهد ومن نجى.
بلاد الشام
عقب سقوط الإمبراطورية العثمانية، خضع المشرق العربي لعملية تقسيم فرضتها القوى الاستعمارية، ولا سيما بريطانيا وفرنسا، من خلال التفاهمات التي تُوّجت باتفاقية سايكس–بيكو عام 1916. قبل ذلك، كانت بلاد الشام، أو ما يُعرف بـ"سوريا الكبرى"، منظَّمة ضمن تقسيماتٍ إدارية مرِنة ومتغيّرة داخل السلطنة العثمانية، تضمّ أجزاءً واسعة مما يُعرف اليوم بسوريا والأردن ولبنان وفلسطين. فعلى سبيل المثال، كانت مدينتا صيدا في جنوب لبنان وعكّا في شمال فلسطين المحتلّة تُداران ضمن سنجق واحد (Dulkadir and Özüçetin 2022; Abu Manneh 2007). ولا تزال بين صيدا وعكّا حتى اليوم سمات عمرانية وثقافية وجمالية متشابهة، كما أن كثيرًا من العائلات اللبنانية والفلسطينية تتقاطع أنسابها بين المدينتين، حيث الأب من عكّا والأم من صيدا، أو العكس، وأقارب ممتدّون على جانبي الحدود الحديثة. كان هذا النمط من "التقسيم" العثماني شائعًا، إذ كانت مناطق لبنانية وسورية متداخلة تُدار كوحدة واحدة إداريًا. أمّا فلسطين فقد خضعت لتقسيمات متعدّدة؛ إذ أُلحقت بدايةً بولاية دمشق، قبل أن تتحوّل القدس إلى متصرّفية مستقلّة (Abu Manneh 2007). كذلك، جرى تقسيم ما يُعرف اليوم بالأردن بين سنجق نابلس والقدس ومصر، فضلاً عن ارتباطه الإداري بولاية سوريا (المصدر نفسه).
خلال الحقبة العثمانية، كان التدخّل الإداري الداخلي من قِبَل السلطات الحاكمة محدوداً، إذ انحصرت غاية التقسيمات الإدارية أساساً في تنظيم جباية الضرائب وتلبية المصالح العسكرية والاستراتيجية، أكثر من كونها ترسيمات تحدّد "أصول" الأفراد أو تضع حدوداً تعيق حركة التنقّل والتفاعل بين المجتمعات. ومع ذلك، لم يكن الحكم العثماني بمنأى عن ممارسات العنف ذات الطابع الإثني، التي رافقت مراحل متفرّقة من سيطرته الإقليمية. مع أفول الإمبراطورية العثمانية، جاءت اتفاقية سايكس–بيكو لترسم حدوداً نهائية لتقسيم موارد المشرق بين فرنسا وبريطانيا. وقد أسهم عهد الانتداب في إعادة تشكيل البنى الاجتماعية والسياسية للمنطقة برمّتها، بما يخدم مشروعاً استعمارياً استغلالياً يكرّس التجزئة والتبعية. نصّت الاتفاقية، باستثناء شبه الجزيرة العربية، على أن تؤول فلسطين والأردن وأجزاء من العراق إلى النفوذ البريطاني، بينما تخضع سوريا ولبنان وأجزاء من تركيا ومنطقة كردستان للسيطرة الفرنسية. واستمرّ نظام الانتدابات هذا حتى انطلاق حركات التحرّر الوطني في منتصف القرن العشرين، حين بدأت الدول القومية الناشئة في المنطقة بالسعي إلى مشاريع مستقلّة، في الوقت الذي كان فيه الكيان الصهيوني المُعلن يمزّق فلسطين.
لا تزال البُنى المعاصرة لهذه الدول تحتفظ بجزءٍ كبيرٍ من أطر مستعمريها السابقين، سواء عبر الإكراه أو الاستيعاب، ولا سيما في تنظيم الحكومات وتصميم التشريعات. ففي أجزاء من بلاد الشام، ما تزال مؤسسات الدولة تعمل ضمن شروط كولونيالية جديدة، تستضيف قواعد عسكرية أجنبية وتُبقي على أنظمة سلطوية مدعومة فعلياً ومموَّلة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. ويُضمن خضوعها السياسي والاقتصادي من خلال العقوبات والمساعدات المشروطة والتهديد الضمني بالتدخّل العسكري. وفي لبنان، ما يزال نظام المحاصصة الطائفية في التمثيل السياسي، الذي أُرسِي إبّان الانتداب الفرنسي، يشكّل مبدأً أساسيًا في الحوكمة. كما تحمل النظم التشريعية بصمات استعمارية واضحة؛ فنظام الكفالة، الذي أُدخل بدايةً في الخليج تحت الإدارة البريطانية قبل أن تتبنّاه الطبقة الحاكمة اللبنانية، ما يزال معمولًا به حتى اليوم، مقيّدًا الوضع القانوني للعمّال الأجانب برعاية صاحب العمل، ومقنّنًا على نحوٍ صارم حقوقَهم وحركتهم، جاعلًا توظيف غير المواطنين رهْنًا برقابة الدولة المُنهِكة (على سبيل المثال، AlShehabi 2019). وبالمثل، تمنع قوانين الجنسية المستمدّة من "القانون النابليوني" لعام 1804 النساء من نقل جنسيتهن إلى أبنائهن (Sayegh 2025; Guerry 2020). فيما جرّمت "قوانين الأسرة" التي فرضتها حكومة فيشي فعلياً المثلية الجنسية. أما الوثائق الرسمية للحالة المدنية، مثل "دفتر العائلة" في لبنان وسوريا، فتعكس نموذج livret de famille الفرنسي. وتستمرّ القيود الكولونيالية الجديدة على التحالفات والتجارة ومقاومة الكيان الصهيوني في تقويض محاولات إعادة التفاوض على هياكل الحوكمة ضمن إطار الدولة القومية المفروض.
وبموازاة هذه الترِكات البنيوية، شهدت مرحلة ما بعد منتصف القرن موجات من الحركات القومية الساعية إلى بناء "سرديات ذاتية" متماسكة لتكريس السيادة إقليمياً ودولياً. وقد تزامن هذا البناء مع التدهور المتعمَّد لإمكان قيام دولة فلسطينية، ما أفرز سرديات تحاول استيعاب هذه الحدود والهويات المستحدثة.
في كتابه "العرق، الأمة، الطبقة: هويات غامضة"، يوضح إتيان باليبار (1991) أن السلطة المهيمنة تجد في إقناع السكّان بأهمية حدودهم وسيلةً لتعزيز هيمنتها. ومن أبرز الآليات التي تستخدمها لتحقيق ذلك بناءُ ما يسمّيه "الأسطورة الوطنية". إذ يقول باليبار:
تبدو لنا جميع هذه البُنى، من منظورٍ استرجاعي، كياناتٍ ما قبل وطنية، لأنها أفسحت المجال لظهور بعض السمات الجوهرية للدولة القومية، تلك التي جرى لاحقاً استيعابها ضمنها بدرجات متفاوتة من التحوير. وبناءً على ذلك، يمكننا الإقرار بأن التشكّل الوطني هو حصيلة "مسارٍ تاريخي طويل سابق على تشكّل الأمة" – أي سلسلة من التطوّرات التاريخية التي مهّدت لقيام الدولة القومية دون أن تكون في ذاتها قومية بعدُ. غير أن هذا المسار السابق يختلف في خصائصه الجوهرية عن الأسطورة القومية التي تصوّره كأنه قَدَرٌ خطّي متّصل. أولاً، يتكوّن هذا المسار من تعدّديةٍ من الأحداث المتمايزة نوعيّاً والممتدّة عبر الزمن، ولا يستتبع أيٌّ منها بالضرورة حدثاً تالياً. ثانيًا، لا تنتمي هذه الأحداث في جوهرها إلى تاريخ أمّةٍ بعينها، بل وقعت ضمن أطرٍ سياسية أخرى غير تلك التي نراها اليوم وكأنها تمتلك هويةً أخلاقيةً أصلية. (1991:88)
الفلسطينيون يمثّلون التجسيد المادي لـ"التاريخ السابق" المشترك للمنطقة. هذا التاريخ السابق يتحدّى ما يُعرف بـ"تاريخ الدولة القومية" الاستعماري، ويتجاوزه ليقوّض جذرياً أسطورة الصهيونية القومية التي تقتضي سيرورتها القضاء على الدولة الفلسطينية، وبالتالي على الأمّة الفلسطينية. ويخلص باليبار (المصدر نفسه) إلى ملاحظةٍ نقدية مفادها: "إنّ الميزة الفارقة للدول من جميع الأنواع هي تقديم النظام الذي تُؤسَّس عليه على أنه أبديّ، رغم أن الممارسة تثبت أن العكس هو الصحيح في الغالب". وجود الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها يبرز الطبيعة التعسّفية والإقصاء المتعّمد ضمن حدود بلاد الشام، ويكشف ويفكك المصالح والأساطير والآليات (النيو)كولونيالية. من الضروري التذكير بأن لبنان نال استقلاله عام 1943، ما يعني أن الدولة، من الناحية القانونية، لم تكن قائمة سوى خمس سنوات قبل النكبة. وإذا كان من المفترض أن يبدأ تاريخ أي أمّة من لحظة استقلالها، وأن تُبنى أسطورة الهوية الوطنية عبر سرديةٍ تاريخية مشتركة ومستقبلٍ آمنٍ ضمن حدود الدولة، فكيف يُستبعَد الفلسطينيون بشكلٍ منهجيّ حتى من المشاركة الجزئية في الدولة اللبنانية؟ وكيف يُمنع شعب يشكّل جزءًا كبيرًا من التركيبة الديموغرافية من المشاركة في الشؤون المحلّية والمهن والمناطق السكنية بالقوة (Eloubeidi and Reuter 2021; BADIL 2019; 2022)؟ إلى أي مدى تُبنى الهوية الوطنية اللبنانية في علاقة مع الوجود الفلسطيني أو الأمّة الفلسطينية؟ وعلى أي أساس، ومن خلال أي إطار أيديولوجي، تُصاغ السياسات اللبنانية الراهنة تجاه اللاجئين الفلسطينيين والسوريين؟ وفي صالح أي بنية توظَّف هذه السياسات في نهاية المطاف؟
أمّة… رغماً عن إرادة الدولة القومية
نتيجةً للعنف الصارخ والمستمرّ، والتهجير القسري، والإبادة الجماعية المعاصرة في غزة، تُعاد صياغة الهوية "الوطنية" الفلسطينية ضمن قوالب تفككاتها، فتتجلّى في "الوجود والمقاومة" في أماكن متفرّقة حول العالم، مرتبطة ومنفصلة في الوقت ذاته بالمكان المادي والغاية والتاريخ المشترك. كما أنّ هذه الهوية مرتبطة ومنفصلة أيضاً بعدم وجود دولة فلسطينية مستقلّة، حيث تحلّ دول الإقامة الأخرى والهيئات مثل "الأونروا" مكانها بشكل جزئي.
شهدت أحداث النكبة والنكسة تهجير نحو 700 ألف إلى مليون فلسطيني في عام 1948 (IMEU 2023; IPS 2020; Pappé 2007)، وما يصل إلى 325 ألف فلسطيني في عام 1967 (Nuseibah 2017; Pappé 2007; Bowker 2003)، إضافة إلى ملايين آخرين متقطّعي الأوصال داخليًا. وبحسب تقديرات أيار/مايو 2025، بلغ عدد النازحين في غزة وحدها 3.2 مليون شخص (IDMC 2025). وفي ما يُسمّى بـ"دول اللجوء"، اختلفت درجة اندماج الفلسطينيين قانونيًا في "المجتمعات المضيفة" من دولة إلى أخرى، كما اختلفت درجة تأثّر الهوية الوطنية لهذه الدول نفسها بوجودهم.
في لبنان، يحتفظ الفلسطينيون بهويتهم الوطنية كفلسطينيين، سواء في أبعادها الموحِّدة أو المفرِّقة، متشابكةً تاريخياً مع نسيج الدولة "السيادية" نفسها. ويبدو هذا الواقع أكثر وضوحاً في لبنان مقارنةً بالأردن وسوريا المجاورتين، نظراً للسياسات التمييزية الصارخة المطبَّقة فيه. فعلى الرغم من درجات التواطؤ المتفاوتة للحكومتين الأردنية والسورية في استمرار الإبادة القومية وقمع المقاومة الفلسطينية، فإن تعامل هاتين الدولتين مع اللاجئين الفلسطينيين كان أفضل نسبياً بعد النكبة. في الأردن، حصل عدد كبير من الفلسطينيين على الجنسية القانونية (al-Husseini 2013). أمّا في سوريا، فقد نصّ القانون رقم 260 لعام 1957 على أن الفلسطينيين المقيمين في سوريا وقت صدوره يتمتّعون بذات الحقوق والواجبات التي يلتزم بها المواطن السوري في مجالات التعليم والعمل والتجارة والخدمة العامة والعسكرية، مع احتفاظهم بجنسيتهم غير السورية (UNHCR 2013; Brand 1988). ومنذ سقوط نظام الأسد، بات الفلسطينيون يُسجَّلون رسميًا بصفتهم "مقيمين فلسطينيين" بدلاً من "فلسطينيين سوريين"، كما كان الحال سابقًا، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول الدلالات السياسية والآثار طويلة المدى لهذه التغييرات الإدارية. وعلى الرغم من محدودية الشمول في السياسات الأردنية والسورية، فإنها تبقى أفضل نسبيًا من الوضع في لبنان، حيث لا يزال الفلسطينيون حتى عام 2025 محرومين من العمل في 39 مهنة "ذات أجر مرتفع"، مثل الطبّ والقانون والهندسة، ومن الالتحاق بالمدارس الحكومية، ومن تملّك العقارات خارج المخيمات (De Schutter 2022; Mellies 2023). هذا الوضع، الذي يضعهم في مرتبة "الدرجة الثانية"، يجعلهم عرضة لظروف عمل ومعيشة قاسية، دون أي تغطية صحّية أو حماية عمّالية، ويُرسّخ وضعهم القانوني كـ"آخرين" داخل إطار الدولة القومية (Eloubeidi and Reuter 2022).
مسألة "الانتماء" واستجواب الهوية لا تقتصر على السياق اللبناني وحده، بل تشكّل هاجساً وجودياً مشتركاً لدى شريحة واسعة من أفراد الشتات الفلسطيني، الذين تناولوا هذه القضية في إنتاجهم الأكاديمي والإبداعي والأدبي. من بين هؤلاء، على سبيل المثال، إدوارد سعيد، فدوى طوقان، غسان كنفاني، محمود درويش، وليد خالدي، حنان عشراوي، وغيرهم كثير. يؤكد باليبار أن تشكُّل "المخيال"1 الخاص بالهوية الوطنية يستلزم تحقّق شرطين أساسيين. أولاً، أن تختبر جماعةٌ من الناس المقيمين في مكانٍ واحد سلسلةً من الأحداث بشكل موحَّد، بحيث يتكوّن لديهم إحساس مشترك بـ"الدولة" و"الشعب"، وهو ما يتيح بناء سردية تاريخية ضرورية لتشكيل الدولة القومية الحديثة. ثانيًا، أن يترسّخ لدى هؤلاء الأفراد الانطباع بأنهم سيظلّون في المكان الجغرافي ذاته لتحقيق "مصيرهم" الوطني (1991:86–87). كيف يجعل الوجود الفلسطيني في الشتات رابطة النضال من أجل التحرّر، أكثر قوة لا أكثر هشاشة؟
في الزمن الراهن، أن تكون فلسطينياً يعني في الغالب أن تعيش خارج فلسطين، مرتبطًا بعائلةٍ مشتّتة في أنحاء العالم، أو نازحًا داخليًا داخل الأراضي المحتلّة (Aouragh 2008; Gabiam 2018; Joudah 2012). ورغم ما خلّفه هذا النفي القسري والحصار والاحتلال العدائي من تباعدٍ عن الهوية "الوطنية" بمعناها التقليدي، تظلّ فكرة فلسطين كوطن متأصّلة بعمق في ذاكرة الشتات الفلسطيني، ونادرًا ما تظهر استثناءات.
تتجلّى دلالات هذه "الأمّة" أو "القوم" بوضوح، إذ يشير بيطار إلى أن الشتات يسهم في تكوين بيئة اجتماعية للهوية الثقافية بما يعزّز الارتباط بالوطن الأصلي، عليه وفي هذا السياق تمسي اللغة الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الارتباط (2009:38). يستمرّ الفلسطينيون في التمسّك باللهجات المحلية حتى عند الإقامة في دول عربية تستخدم لهجات مختلفة، مثل دول الخليج. ففي مقابلة مع سلمان رشدي عام 1986، يوضّح إدوارد سعيد أنه حتى داخل مخيمات اللاجئين في لبنان، ومع وجود لاجئين من مواليد لبنان، يمكن سماع خصائص لغوية مميّزة للمناطق الفلسطينية، مثل يافا. كما تلاحظ روزماري صايغ هذه الظاهرة:
حتى في حال وجود دولة صغيرة، سيبقى عددٌ كبيرٌ من الفلسطينيين خارجها، إما طوعاً أو بسبب محدودية مساحتها؛ وستظلّ حالتهم ودورهم مختلفين جداً عن باقي العرب القادرين على الهجرة الداخلية. وحتى إذا اكتسبوا جنسيةً عربيةً أخرى أو هاجروا، فإن ولاءاتهم ومهنهم من غير المرجح أن تفقد صبغتها الفلسطينية. (1977:4)
في مواجهة حملة محو الدولة الفلسطينية، تواصل السرديات الفلسطينية وأشكال القومية الفلسطينية البقاء، لا سيما بين اللاجئين. يُنظر إلى هذا الاستمرار بوصفه صراعاً مادياً وأيديولوجياً على الجغرافيا والسردية والهوية (Khalili 2007; Said 1993:7). كما يتجلّى مفهوم "القومية" على المستوى المؤسسي، لا سيما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين المسجَّلين، الذين يستفيدون من خدمات التعليم التي تقدّمها "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا).
ساهمت أنشطة التعليم التي تقدّمها "الأونروا"، بشكلٍ غير مقصود، بتشكيل بنية أساسية ساهمت ليس فقط في استمرار الهوية الفلسطينية ونموّها، بل وفي إعادة بناء الهوية الوطنية بين الفلسطينيين في المخيمات وما وراءها، ذلك من خلال وسائل متعددة تشمل الشعر والموسيقى والمسرح والرسم والقصص القصيرة والأغاني والرقصات التقليدية وورش العمل. علاوة على ذلك، ساهم توظيف "الأونروا" للمعلّمين والإداريين من داخل مجتمع اللاجئين بشكل شبه حصري في تعزيز شعور بـ"الذات" و"الآخر" داخل المدارس والمخيمات، لا سيما في الأردن ولبنان وسوريا. (Shabaneh 2012:2)
يتجسّد هذا الالتزام الثابت بالهوية الفلسطينية في قالبٍ قومي يتجاوز محدّدات الأرض والتراث. فهذه "القومية" ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال المناهض للاستعمار من أجل تحرير فلسطين والالتزام بحقّ العودة. بذلك، تتحدى الهوية الوطنية الفلسطينية، العابرة للحدود والدول، المعايير التقليدية للشتات والتشكيلات المألوفة للدولة القومية التي رسمها السائد من البحوث. ورغم أن القومية في المنطقة ليست بمنأى عن النقد الواجب، فإن "القومية" الفلسطينية تقوم على مقاومة المستعمرة الاستيطانية الصهيونية، وصدّ محاولات القضاء على الحياة الفلسطينية، والسعي نحو بناء الدولة الفلسطينية. وتكتسب الحركات السياسية والمسلّحة الفلسطينية الناشئة، والتي تميل أحياناً إلى نوعٍ من الحذر أو "الرهاب" من الدولة، أهميةً بالغة، إذ تقوّض التوقّعات الإثنية للدولة ضمن مشاريع الدولة القومية الجديدة في بلدان الشتات وفي "إسرائيل" نفسها (Abu-Assab and Nasser-Eddin 2018; Mignolo 2021). ومع ذلك، يظلّ السعي نحو شكلٍ من أشكال الأمّة والدولة الفلسطينية مسألة مرتبطة مباشرة بسؤال البقاء.
أمّة فلسطينية بلا دولة تمثّل بذاتها تحدّياً للبنية القومية الحديثة؛ فهي تكشف عن هدف الدولة القومية في بلاد الشام، والمتمثّل في محو الدولة الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام. إنّ استمرار الهوية الفلسطينية، ومكانتهم الاجتماعية والمدنية داخل لبنان، يشير مباشرة إلى أن الدولة القومية ما بعد الاستعمارية محكوم عليها بالفشل في نهاية المطاف. وعلى المدى القصير، إذا اعتبرنا أنّ أشكال الإبادة جزءاً جوهرياً من بناء الدولة القومية (Hage 1996)، فإنّ إطار الدولة القومية سارٍ على قدمٍ وساق.
هويّةٌ متمرّدة ضمن تاريخٍ مشترك2
بعد حرب أكتوبر عام 1973، أصبحت مصر، التي كانت تُعدّ الداعية الرئيسية للحركة القومية العربية، أول حكومة عربية تُطبّع علاقاتها مع الاحتلال عبر الاعتراف رسمياً بـ"إسرائيل" كدولة. وقد شكّلت هذه الخطوة ضربة قاصمة للقضية "العربية" لتحرير فلسطين، ورسّخت لدى الفلسطينيين شعوراً متزايداً بالعزلة. ومن هذا المنظور التاريخي، ومن خلال فشل أو عجز الدول القومية العربية ما بعد الاستعمارية عن تفكيك الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، يمكن فهم ما يُسمّى بـ"الحرب الأهلية اللبنانية" (1975–1990). إذ شكّلت فلسطين، وما انطوت عليه من شمولٍ للفلسطينيين أو استبعادٍ لهم، عنصراً مركزياً في الأساطير المؤسسة للبنان الحديث، سواء لتثبيت وَهْم الدولة القومية أو لتفكيكه لاحقاً. وبقدر ما كان الفلسطينيون جزءاً من التاريخ السابق ومشاركين في بناء لبنان، فإن تعمّق الانقسامات الداخلية جعل الإطار "الطائفي" الذي أرساه الانتداب الفرنسي أكثر هشاشة وإشكالية (Traboulsi 2012; Chamie 1976/77).
تصاعدت التوتّرات في لبنان في مطلع عام 1975، في ظل تزايد السخط الشعبي إزاء تقاعس الحكومة عن الردّ على الهجمات "الإسرائيلية" التي استهدفت مخيم اللاجئين الفلسطينيين في النبطية وقرية كفر شوبا في جنوب البلاد. وتفاقمت هذه الأزمة الاجتماعية والسياسية مع اندلاع إضراب الصيادين في مدينة صيدا في شباط/فبراير من العام نفسه، احتجاجاً على احتكار النخب الاقتصادية للثروة وموارد البحر. وقد تحوّل الإضراب إلى مواجهة دامية بعدما أُطلقت النار على معروف سعد، الزعيم السياسي البارز في صيدا والمدافع عن حقوق الصيادين الصغار، ما أدّى إلى إصابته إصابةً قاتلة ووفاته لاحقاً متأثراً بجراحه. أسفرت الأحداث كذلك عن سقوط عددٍ من المتظاهرين والجنود (Chamie 1976/77:175).
بعد فترة وجيزة، في الثالث عشر من نيسان/أبريل 1975، قُتل أحد الأعضاء البارزين في حزب "الكتائب"، وهو تنظيم قومي مسيحي ماروني يميني متشدّد عُرف بمعارضته الشديدة للوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان. وتمّت عملية القتل في أحد الأحياء المسيحية في ظروف مثيرة للجدل، ليسارع الكتائبيون إلى اتهام المقاتلين الفلسطينيين بالمسؤولية عن الحادث. في اليوم نفسه، أقدم مسلّحون من الحزب على مهاجمة حافلة تقلّ فلسطينيين ولبنانيين غير مسلّحين كانت تمرّ في المنطقة، ما أسفر عن مقتل سبعةٍ وعشرين منهم (Chamie 1976/77:175–6). رغم أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد لاندلاع الحرب، فقد أصبحت مجزرة الحافلة في 13 نيسان رمزاً فاصلاً يُشار إليه بأثرٍ رجعي على أنه اللحظة التي تحوّلت فيها التوترات الكامنة إلى صراعٍ شامل. تسود رمزية تلك الحادثة في الذاكرة الجمعية في البلاد حاجبةً العوامل الاجتماعية والسياسية البنيوية الأعمق التي كانت تُضعف الكيان اللبناني حينها.
وُظّفت الطائفية بسرعة وبفعالية، إلى أن اتسعت لتغدو منظومةً من التقسيمات المناطقية والجغرافية. أمست مجالاً لصراعٍ سياسي متنامٍ بين منطقَي "الإصلاح" و"الأمن". وقد تزايد الهوس الأمني، الذي تمحور حول الوجود المسلّح الفلسطيني، سواء بوصفه قوة دفاعية في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، أو – في نهاية المطاف – باعتباره تهديداً داخلياً للاستقرار اللبناني (Traboulsi 2012:175). ومع ذلك، ظلّت المقاومة وحرب العصابات تشكّلان ركناً محورياً في بناء الهوية الوطنية الفلسطينية؛ إذ يستمرّ النضال من أجل تحرير الوطن المحتلّ، وتحقيق الدولة المستقلّة، وضمان حقّ العودة.
تُسهم فكرة المصير المشترك، وما يرافقها من أواصر الأخوّة والطقوس الجماعية، في توطيد الروابط بين المقاتلين. ففي إحياء ذكرى المعارك، تُقدَّم هذه الرموز بوصفها تجسيداً للمعركة باعتبارها تجربة خطرة – وبالتالي جديرة بالرجال – لكنها في الوقت نفسه تُصوَّر كمسعى نبيل ومجزي. (Bourke 1999 cited in Khalili 2007:153)
ضمن هذا الإطار البطولي، كان يُنظَر إلى المقاتلين الفلسطينيين في ذلك الوقت من قبل مجتمعاتهم كخصومٍ أشدّاء في المعارك. وقد حظوا بدعمٍ شعبيٍّ من شريحة واسعة من السكّان المحليين اللبنانيين، العديد منهم مرتبط بأحزاب شيوعية واشتراكية. في هذه المرحلة، أخذ هذا التشكّل الجماعي للأسطورة يُظهر انفصالاً أوضح عن هوية الفلسطينيين في فلسطين، داخل الحدود الاستعمارية لـ"إسرائيل"، وفي مناطق أخرى من الإقليم. وقد تجلّى هذا الانفصال أحياناً في أعمالٍ فنّية محدّدة، كالبوسترات السياسية والجرافيتي، التي تناولت الشؤون اللبنانية حصراً. فعلى سبيل المثال، دعا ملصقٌ صدر عام 1982 إلى التضامن بين الفلسطينيين وسكّان جنوب لبنان، مميّزاً بصرياً بين الطرفين عبر الملبس: الفلسطيني في هيئة مقاتل يعتمر الكوفية، واللبناني في الزي الجبلي التقليدي (Tripp 2013:263). ورغم ما انطوت عليه هذه الأساطير من سماتٍ مميّزة، فقد أتاحت، في الوقت نفسه، تشابكاً عميقاً بين المجتمعين.
ومع تصاعد القتال، غلبت عليه مجازر متعدّدة الأبعاد، وهجماتٍ "إسرائيلية" متواصلة، وصعوبات شبه مستحيلة في التنقّل عبر الانقسامات العرقية والوطنية داخل نظام دولة ذي طابع (نيو)كولونيالي. وقد رافق هذا التصعيد في العنف نشوء تحالفات بين الميليشيات اللبنانية، لا سيما المسيحية منها، و"الإسرائيليين"، إلى جانب تراجع التعاطف مع الطموحات السياسية الفلسطينية. تشتَّت الفلسطينيون تباعاً، ما أسفر عن إضعاف موقع "منظّمة التحرير الفلسطينية" التي كانت متمركزة في لبنان.
أصبح تشكيل الهوية الوطنية والحضور الفلسطيني ملموسًا بشكل واضح نتيجة سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال عام 1982 وما تلاه. فقد شهد المخيّم مجزرة صبرا وشاتيلا بعد الانسحاب التدريجي للقوات الدولية، بدءًا بالقوات الأميركية، ثم الإيطالية، وأخيرًا الفرنسية في صباح 12 أيلول/سبتمبر 1982 (al-Shaikh 1984:59). ومع غياب مقاتلي "منظّمة التحرير الفلسطينية" المحلّيين وتدمير البنية التحتية للمخيم بفعل "إسرائيل" وحلفائها، وجد سكّان المخيّم أنفسهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. ونتيجة لذلك، قُتل ما يصل إلى 3500 فلسطيني على يد حزب "الكتائب" اللبنانية، الذي دخل المخيّم بتسهيلٍ من القوات "الإسرائيلية" المتمركزة في بيروت آنذاك.
تراجعت السردية الفلسطينية في لبنان إلى "هوامش المخيال الوطني" بعد مجازر المخيمات (Khalili 2007:151)، ليست مجزرة صبرا وشاتيلا إلّا مثالًا واحدًا على ذلك. فقد سُلّمت القوة العسكرية والسيادة الذاتية للفلسطينيين إلى الدولة اللبنانية بعد إضعاف "منظّمة التحرير الفلسطينية" ونفي مقاتليها. وأصبحت المجازر أبرز محطات في ما يُعرف بـ"المشهديات الوطنية التذكارية" (نفس المرجع)، واستُبدلت صورة المقاتل الفلسطيني بصورة اللاجئ الفلسطيني.
التتابُع التاريخي للمجازر خلق شعوراً بـ"نحن" أي من ارتُكِبت بحقّهم الفظائع – "نحن" اللاجئ الفلسطيني، الذي كانت هويته السياسية خطيرة إلى درجة أن المواطنين اللبنانيين المتزوجين من فلسطينيين كانوا هم أيضاً عرضةً للقمع. (2007:150)
لم تكن إعادة بناء الهوية هذه خياراً مقصوداً أو مرغوباً فيه على نحوٍ خاص، ولكن في ظلّ "غياب البدائل البنيوية والمؤسسية"، أصبح تبنّي فئة "اللاجئ" "ضرورةً استراتيجية" (Peteet 1996) اقتضتها متطلّبات البقاء في الحياة اليومية.
ازدادت صعوبة المعركة البيروقراطية التي كان على الفلسطينيين في لبنان خوضها إلى جانب استمرار الاحتلال المتّسع والعنيف وغير الأخلاقي وغير القانوني في فلسطين. يمكن هنا العودة إلى معيارَي باليبار لـ"المخيال" الهوياتي الوطني. أولًا، مرّ الفلسطينيون في لبنان بسلسلة من الأحداث التي رسّخت لديهم إحساسًا بالانتماء الجماعي وسردًا تاريخيًا مشتركًا. ثانيًا، أصبح الفلسطينيون في لبنان محايدين سياسيًا، وتضاءلت أمامهم الخيارات الجغرافية نحو دولة قومية. هذا المأزق السياسي أوجب بقاء الفلسطينيين في لبنان، محرومين من الحريات ومن القدرة على التنظيم العسكري والسياسي اليساري التي مارسوها سابقًا. لقد أُعيد توجيه "مصيرهم" إلى نضالٍ من أجل الحقوق المدنية في إطار حياتهم الاجتماعية. وتستند هذه الرواية التاريخية الجديدة، مرة أخرى، إلى استبعادهم الضروري داخل المنطقة وبين دولها القومية.
لا يمكن فصل إعادة تشكيل الهوية الفلسطينية في لبنان عن المشروع الاستعماري الأوسع الذي مزّق بلاد الشام. فمشروع الدولة القومية، سواء على المستوى الإقليمي أم العام، يسير وفق مخطّطه، حيث تُحرَم بعض الشعوب بالكامل من إقامة دولة، بينما يُحتَجز آخرون ضمن تسلسلات هرمية داخل الدول القومية القائمة. ويعكس استمرار القوانين اللبنانية التمييزية، إلى جانب المحو المنهجي للوجود الوطني الفلسطيني ومنع قيام دولة على أرض فلسطين التاريخية، استمرارية للهيمنة المكانية (Zebdawi 2025)، بدءًا من الأحياء المحاصرة للاجئين في بيروت، وصولًا إلى الاستيلاء المستمر على الضفة الغربية ضمن مشروع "إسرائيل الكبرى" التوسّعي. وتواصل إسرائيل ضمّ الضفة الغربية، والسيطرة على مساحاتٍ واسعة من الأراضي السورية، والتعدّي على الأراضي اللبنانية، والتحكّم بالأردن من خلال السيطرة على الموارد، ولا سيما المياه، وفرض "اتفاقيات سلام"، جاعلةً من نفسها "إسرائيل" العدو الأوحد في المنطقة.
منذ 7 أكتوبر 2023، صعّدت "إسرائيل" مشروعها الاستيطاني الاستعماري إلى مستوى يرقى إلى الإبادة الجماعية، حيث قتلت قُرابة الـ 100,000 فلسطيني، وربما يقترب العدد من 200,000 (Khatib et al. 2024) في غزة. نزح أكثر من مليون شخص (IDMC 2025)، كما دُمِّرت الجامعات والمستشفيات والأرشيفات والأماكن المقدّسة والبنية التحتية الأساسية بشكل منهجي. ويكشف القصف المستمرّ وتسوية مخيمات اللاجئين مثل جباليا ورفح، على غرار المجازر مثل صبرا وشاتيلا، عن الذروة القاتلة للمصير الاستعماري المفروض على الفلسطينيين. وتؤكد هذه الأفعال، إلى جانب العنف المتصاعد من المستوطنين والتوغلات العسكرية في الضفة الغربية، أن مشروع "إسرائيل الكبرى" ذو نطاق إقليمي، يهدف إلى تفكيك كلّ أشكال الوجود السياسي والثقافي والمادي للفلسطينيين، ويصرّ على القضاء على أي شكل من أشكال الدولة القومية الفلسطينية.
ومع ذلك، فإنّ هذا البناء التفتيتي يواجه الآن تحدّيًا مباشرًا من مقاومةٍ مسلّحة عابرة للحدود. ففي غزة، نسّقت ألوية "القسام"، وألوية "القدس"، وألوية "الناصر صلاح الدين"، إلى جانب فصائل أخرى، جهودها عبر الخطوط الأيديولوجية المختلفة – الإسلاميين، والشيوعيين/الاشتراكيين، والعلمانيين، والقوميين – ما يظهر وحدة الهدف في الدفاع عن غزة وشعبها ضد واحدٍ من أكثر الجيوش تجهيزًا تكنولوجيًا في العالم. وفي جنوب لبنان، شكّلت المواجهات العسكرية لـ"حزب الله" مع "إسرائيل" امتدادًا للنضال الفلسطيني؛ وفي العراق واليمن، نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق و"أنصار الله" ضربات معلنة تضامنًا مع القضية. وهذه التعبئة متعددة الجنسيات ومتعددة الأديان لا تتحدَّى الاحتلال في فلسطين فحسب، بل تُقوّض أيضًا مشروع "إسرائيل الكبرى" المبني على الفصل الإثني والديني والتحريض عليه. ورغم محدودية اللاعبين الإقليميين المشاركين، إلا أن هذا يرمز إلى أن المقاومة ضد القوى الإمبريالية والاستعمارية ما زالت قائمة، رغم الدمار الهائل والتكاليف البشرية الباهظة المصاحبة لها.
يكشف التناقض بين الإبادة والمقاومة زيف الأساطير الاستعمارية التي أشار إليها باليبار. فـ"المصير" المفروض عبر الحدود والمجازر يُقابَل بفعلٍ نضاليٍّ عابر للحدود يرفض الخضوع له. و"البنية القومية"، التي تُصوَّر كإقليم مغلق واستبعادي، تتصدّع أمام مقاومة اللاجئين القائمة على الصمود وحقّ العودة. أما "الهوية"، فليست جوهرًا ثابتًا، بل كيانًا متحوّلًا يعيد تشكيل نفسه عبر المعاناة والإنجازات النضالية، متحرّرًا من التعريفات الاستعمارية. إن الإبادة الجماعية الجارية، بدل أن تمحو الوجود الفلسطيني، أعادت إحياء الانتماء الجماعي من داخل شظايا ما أنتجه الاستعمار نفسه. وهكذا يتكشف أن الاستمرارية المزعومة للنظام الاستعماري ليست سوى وهم، إذ يتأسس الانتماء الحقيقي من خلال النضال ضد الحدود المفروضة، لا من خلال القبول بها.
الخلاصة
يستعرض هذا المقال "التاريخ السابق" المشترك بين الفلسطينيين واللبنانيين باعتباره شكلًا جوهريًا من أشكال المقاومة ضد هياكل الدولة النيو-استعمارية، ويبحث في التاريخ والثقافة المميزة التي شكّلت الأمّة الفلسطينية داخل لبنان، بالإضافة إلى محاولات التعامل مع هذه التعقيدات بصفتهم أعضاءً في الجسد الفلسطيني الأكبر الساعين إلى حقّ العودة. وعلاوة على ذلك، يوضح المقال أن هذا التجزؤ الحصري مُصمَّم لغرضٍ محدّد، وهو ضمان أن إطار الدولة القومية يمنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم. وضمن هذا الإطار، تمّ بناء الهوية الوطنية اللبنانية في مقابل الفلسطينيين: فكونك "لبنانيًا" يعني ألا تكون فلسطينيًا. وعلى المستوى الإقليمي، تشكَّل وجود سوريا والأردن ولبنان كـ"دول قومية" على خلفية عدم وجود فلسطين كدولة؛ وجود هذه الدول القومية مرتبط بعدم وجود دولة فلسطينية. إن حالات الاستبعاد التي يواجهها الفلسطينيون في لبنان ليست إخفاقات للدولة القومية، بل هي أعراض لنظام صُمّم أصلاً لإنكار إقامة الدولة عليهم بالكامل.
وفي الوقت نفسه، حافظ الفلسطينيون على هويتهم الوطنية وأعادوا صوغها عبر الحدود. فمن خلال اللهجات والذاكرة والممارسات الثقافية، يُصرّ الفلسطينيون في لبنان على استمرارية الانتماء الشعبي، رغم بقائهم خارج التعريف القانوني للأمة. وقد أدّت مؤسساتٌ مثل "الأونروا"، رغم محدوديتها البالغة، دورًا حاسمًا في صون البنى الاجتماعية والمدنية بديلاً عن الدولة، مُنتجةً بذلك انتماءً وطنيًا واجتماعيًا يتخطّى الحدود القانونية والسياسية المفروضة. أما مخيمات اللاجئين، بما تحويه من شبكات سياسية واجتماعية، فتجسّد مفارقة "أمّة داخل دول قومية أخرى": إذ يُحرَم الفلسطينيون من السيادة، ومع ذلك يظلون كيانًا سياسيًا قائمًا يتحدّى شرعية النظام الاستبعادي.
ما ينبثق من ذلك هو تناقضٌ جوهري. فإذا كانت الدولة القومية تمثّل المعيار النهائي للانتماء والحقوق، فإن الفلسطينيين في لبنان يُحرَمون من كليهما. ومن خلال اعترافهم بتاريخهم، وتغلغلهم في النسيج الاجتماعي الشامي، وقدرتهم على الحفاظ على هوية وطنية تمتد عبر دولٍ وأزمنة متعددة، يتّضح أن إطار الدولة القومية غير كافٍ. فالهويّة اللبنانية، وسائر هويّات الدول في المنطقة، لا تُفهم إلا في سياق غياب فلسطين كدولة قائمة. ومن ثمّ، فإن الدولة القومية ليست كيانًا محايدًا، بل نظام قائم على الاستبعاد والعنف والتراتبية.
واليوم، تتعرّض بلاد الشام لنمط العنف ذاته الذي وضع الفلسطينيين في هذا الموضع داخل حدود الدولة اللبنانية. ويعيد العنف الاستعماري الموجّه نحو جنوب لبنان التأكيد على التاريخ المشترك، وعلى الصدمات ما بعد الاستعمارية، وعلى "الآخرية" التي فرضتها الدولة. وبالنسبة للّبنانيين والفلسطينيين، والفلسطينيين في لبنان على وجه الخصوص، تبرز أسئلة مُلحّة: أيُّ الشروخ تُكشَف من جديد، وأيّها يتشكّل، وأيّها قد يُمهّد الطريق للتقارب؟
تنطوي التداعيات على جانبين. أولًا، ما لم يُفكَّك نظام الدولة القومية بأسره، لا يمكن إنكار مسعى السيادة الفلسطينية دون استمرار العنف، فإما أن تكون الدولة القومية جامعة، أو لا تكون. ثانيًا، في ظل الواقع الراهن للإبادة الجماعية المستمرّة في غزة وتجدد العدوان "الإسرائيلي" على لبنان وسوريا، لا يُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة نظرية مجردة، بل شرط مادّي للبقاء على قيد الحياة.
- 1. إلى "المخيال" بدلاً من "الوهم"، إذ تنطوي "المخيال" على دلالة تركيبية تتجاوز الإيهام أو الخداع إلى الإشارة إلى الحقل الرمزي الذي تُعاد ضمنه صياغة تصوّرات الجماعة لذاتها وللعالم المحيط بها. فـ"المخيال" ليس وهماً جماعياً ينبغي تفكيكه، بل بُنية معرفية–أيديولوجية فاعلة تسهم في بلورة الهويات الجمعية وصياغة الأساطير الوطنية التي تُكسبها طابعها الواقعي المتخيَّل. في السياق الفلسطيني، تتخذ هذه البنية دلالة مغايرة، إذ تتحوّل سلطة "المخيال" إلى سلطة فعلٍ مقاوم يضع نفسه على طرف النقيض من بنية الدولة القومية العربية. وقد تجلّى ذلك بوضوح خلال الحقبة الناصرية والبعثية والشهابية، حين انتقل تصوّر الهوية الفلسطينية من مجرّد "حلم العودة إلى الأرض" إلى مخيالٍ تحرّري يُعيد تركيب معالم الشعوب العربية ذاتها على نحوٍ يتعارض مع الأيديولوجيات الأمنية التي حصرت دور الدولة العربية، واللبنانية بخاصة، في ضبط الفضاء السياسي والاجتماعي. بذلك، نرتقي من التصوّر العاطفي الجمعي إلى مخيالٍ متعدد الإمكانات يسعى إلى الانعتاق من خلال الاشتباك مع بنى الواقع، لا إلى الهروب منه. غير أنّ الواقع الراهن، حيث يشهد الفضاء الفلسطيني في دول الشتات انعداماً شبه تام لآليات الاشتباك المنظّم، قد يُبرّر إعادة ترجمة المصطلح إلى "الوهم"، تعبيراً عن تحوّل "المخيال المقاوم" إلى حالة تَراجع وتفكّك رمزي (ملاحظة المترجمة).
- 2. ترجمة تحريريّة (المترجمة)
Abu-Assab, N., and Nasser-Eddin, N. 2018. “Queering Justice: States as Machines of Oppression.” Kohl: a Journal for Body and Gender Research 4(1): 48–59. https://kohljournal.press/queering-justice
Abu Manneh, B. 2007. “The Rise of the Sanjak of Jerusalem in the Late Nineteenth Century.” In The Israel/Palestine Question, ed. by Illan Pappé. London: Routledge, 36–47.
al-Husseini, J. 2013. “Jordan and the Palestinians.” In Atlas of Jordan: History, Territory and Society, ed. by Myriam Ababsa. Beirut: Presses de l’Ifpo, 230–45. https://books.openedition.org/ifpo/4560
al-Shaikh, Z. 1984. “Sabra and Shatila 1982: Resisting the Massacre.” Journal of Palestine Studies 14(1): 57–90.
AlShehabi, O. H. 2019. “Policing Labour in Empire: The Modern Origins of the Kafala Sponsorship System in the Gulf Arab States.” British Journal of Middle Eastern Studies 48(2): 1–20.
Aouragh, M. 2008. “Everyday Resistance on the Internet: The Palestinian Context.” Journal of Arab & Muslim Media Research 1(2): 109–30.
BADIL. 2019. BADIL’s Position Paper: Stop the Ongoing Discrimination against Palestinians Refugees in Lebanon. BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights. https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/lebanon-pal-ref-rights-1618905391.pdf
BADIL. 2022. Upholding the Rights of Palestinian Refugees in Lebanon: Responsibility of Lebanon, Israel, and the International Community. [Written statement prepared for the UN’s Human Rights Council]. https://badil.org/cached_uploads/view/2022/06/22/badil-s-ws-unhrc-50th-item3-21june2022-rights-pal-ref-lebanon-1655891449.pdf
Balibar, E., and Wallerstein, I. 1991. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. London: Verso.
Bitar, S. 2009. Palestinian-Levantine Dialect Diaspora: Exploring Its Role in Maintaining Palestinian Cultural Heritage & Identity. [Postgraduate thesis]. Missoula: University of Montana.
Bowker, R. 2003. Palestinian Refugees: Mythology, Identity, and the Search for Peace. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
Brand, L. 1988. “Palestinians in Syria: The Politics of Integration.” Middle East Journal 42(4): 621–37. https://www.jstor.org/stable/432783
Chamie, J. 1976/1977. “The Lebanese Civil War: An Investigation into the Causes.” World Affairs 139(3): 171–88.
De Schutter, O. 2022. Visit to Lebanon – Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. The UN’s Human Rights Council. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/306/19/pdf/g2230619.pdf
Dulkadir, D., and Özüçetin, Y. 2022. “Ottoman Administration in Mount Lebanon and the Sectarian Policy of the Ottoman in the Region from Tanzimat to the First World War.” International Journal of Social and Humanities Sciences 6(2): 115–38.
Edward Said interviewed by Salman Rushdie. 1986. “Edward Said & Salman Rushdie.” YouTube. London: Institute of Contemporary Arts. https://www.youtube.com/watch?v=Sf0J9KlHank
Eloubeidi, S., and Reuter, T. K.. 2022. “Restricting Access to Employment as a Human Rights Violation: A Case Study of Palestinian Refugees in Lebanon.” The International Journal of Human Rights 27(1): 53–73.
Gabiam, N. 2018. “Mapping Palestinian Identity in the Diaspora.” South Atlantic Quarterly 117(1): 65–90.
Guerry, L. 2020. “Gender, Nationality and Naturalization.” EHNE: Digital Encyclopedia of European History. https://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/gender-and-europe/gender-citizenship-in-europe/gender-nationality-and-naturalization
Hage, G. 1996. “The Spatial Imaginary of National Practices: Dwelling—Domesticating / Being—Exterminating.” Environment and Planning D: Society and Space 14(4): 463–85.
Joudah, N. 2012. Palestinian Youth Perspectives on Exile Politics: Between Solidarity and Leadership. Georgetown University.
IDMC. 2025. “Palestine – IDPs’ conditions deteriorate further as hostilities escalate.” Internal Displacement Monitoring Centre. https://www.internal-displacement.org/spotlight/Palestine-IDPs-conditions-deteriorate-further-as-hostilities-escalate/
IMEU. 2023. “Quick Facts: The Palestinian Nakba (Catastrophe).” Institute for Middle East Understanding. https://imeu.org/article/quick-facts-the-palestinian-nakba
IPS Washington. 2020. “Nakba 1948: Selections from the Journal of Palestine Studies.” Institute for Palestine Studies. https://www.palestine-studies.org/en/node/1650086
Khalili, L. 2007. Heroes and Martyrs of Palestine: The Politics of National Commemoration. Cambridge: Cambridge University Press.
Khatib, R., McKee, M., and Yusuf, S. 2024. “Counting the Dead in Gaza: Difficult but Essential.” The Lancet 404(10449): 237–38.
Mellies, R. 2023. “Palestinian and Syrian Refugees’ Access to Education in Lebanon: A Comparative Approach.” Lebanese American University. https://soas.lau.edu.lb/news/2023/02/palestinian-and-syrian-refugees-access-to-education-in-lebanon-a.php
Mignolo, W. D. 2021. “Decolonizing the Nation-State.” In The Politics of Decolonial Investigations. Durham, NC: Duke University Press, 154–80.
Pappé, I. 2007. The Ethnic Cleansing of Palestine. London: Oneworld Publications.
Nuseibah, S. 2017. “The Second Nakba: Displacement of Palestinians in and after the 1967 Occupation.” Orient XXI. https://orientxxi.info/magazine/the-second-nakba-displacement-of-palestinians-in-and-after-the-1967-occupation,1875
Peteet, J. 1996. “The Palestinians in Lebanon: Identity at the Margins.” The Journal of the International Institute 3(3). https://quod.lib.umich.edu/j/jii/4750978.0003.303?view=text;rgn=main
Said, E. W. 1993. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.
Sayegh, N. 2025. State, Society, Psyche: A Dialectical Analysis of Multiscalar Gendered Oppression in Palestinian and Jordanian Women’s Everyday Lives. [PhD dissertation]. Toulouse: Université Toulouse – Jean-Jaurès, 54–62.
Sayigh, R. 1977. “The Palestinian Identity among Camp Residents.” Journal of Palestine Studies 6(3): 3–22.
Shabaneh, G. 2012. “Education and Identity: The Role of UNRWA’s Education Programmes in the Reconstruction of Palestinian Nationalism.” Journal of Refugee Studies 25(4): 491–513.
Traboulsi, F. 2012. “From Social Crisis to Civil War (1968–1975).” In A History of Modern Lebanon. London: Pluto Press, 157–90.
Tripp, C. (2012). The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 256–308.
UNHCR. 2013. Syria: The legal rights and obligations of a Palestinian who has been issued a Syrian travel document. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. https://www.ecoi.net/de/dokument/1332928.html
Zebdawi, M. (2020). ثورة اللبناني هي ثورة فلسطينيةُ.. والعكس صحيح. 180 Post. https://180post.com/archives/8621
Zebdawi, M. (2021). عندما يُعلن الفلسطيني عداءه لشرعة الوقت. 180 Post. https://180post.com/archives/18921
Zebdawi, M. (2024). In Maya Zebdawi and Zuhour Mahmoud, “There Will Be No Innocents Amongst Us.” Kohl: a Journal for Body and Gender Research 10(1). https://kohljournal.press/there-will-be-no-innocents-amongst-us
Zebdawi, M. (2025). “Zionism in Disarray: An Interrupted Continuum.” Kohl: a Journal for Body and Gender Research 10(1). https://kohljournal.press/zionism-in-disarray