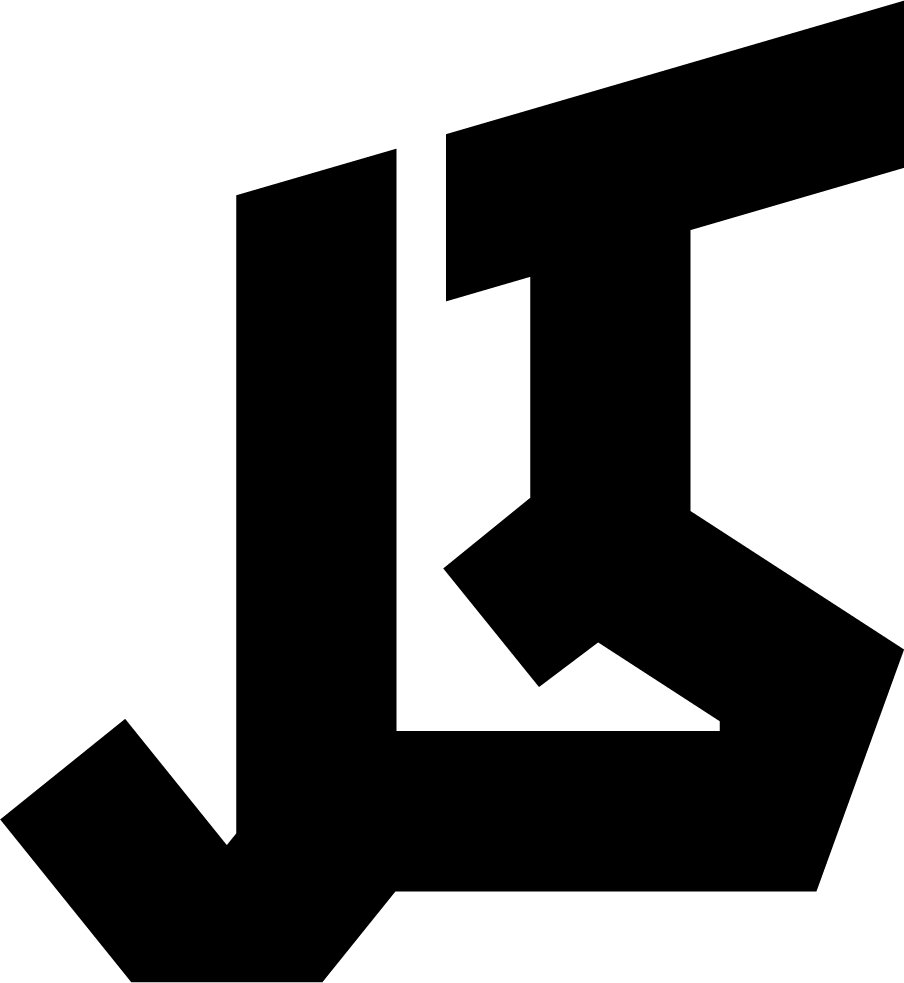العصيان المعرفي وعلم الجرائم
epistemic_disobedience_ar_2.jpg

ميرا المير
المقدمة
تسعى هذه المقالة إلى مساءلة أنماط إنتاج المعرفة ضمن علم الجريمة الأوروبي، بالتركيز على التداخل ما بين سياسة العقاب وسياسة المعرفة. أُبيّن كيف يعمد التيار السائد في علم الجريمة الأوروبي إلى نزع السياسة عن تجربة السجن عبر فصله عن بنيات الاضطهاد وسياقاته التاريخية، بما يُفضي إلى تطبيع ممارسات ذات طابع إبادي وإضفاء الشرعية عليها. رغم أنّ تيارات نقدية – على غرار المجموعة الأوروبية لدراسة الانحراف والضبط الاجتماعي (EGSD&SC) – قد واجهت هذا النزوع طويلاً، فإن المؤسسات المهيمنة في الحقل تواصل إنتاج خطاب يزعم الحياد التأديبي، خطابٌ يُعتم على التواطؤ مع عنف الدولة، ويختزل الجريمة في علّة فردية، ويضيّق أفق المقاومة. إنّ ما يُقدَّم في هذا الحقل بصفته لغة "موضوعية" و"محايدة" للإصلاح ليس إلا وجهاً من وجوه الحوكمة النيوليبرالية، حيث تُستَخدم بلاغة إنسانية إصلاحية للتستّر على علاقات القوة. وانطلاقاً من رؤية ميشيل فوكو في أركيولوجيا المعرفة (2002)، القائلة إن الحقول المعرفية هي تشكيلات مقيَّدة بقواعد تحدّد ما يمكن أن يُقال، فإنني أقرأ صمت علم الجريمة لا بوصفه إغفالاً عرضياً، بل نتيجةً مقصودة وضرورية لتلك القواعد ذاتها.
لإنجاز هذا المسعى، أستند إلى النظريات ما بعد الاستعمارية، ولا سيما أطروحات مبمبي (2019) وميغنولو (2009)، فضلاً عن تحليلات فوكو للسلطة والمعرفة (1977؛ 1980؛ 2002)، لاستكشاف الكيفية التي يمكن بها للتفكير والممارسة ما بعد الاستعمارية أن يفكّكا أنماط إنتاج المعرفة الإنسانية-الوضعية. يبيّن ميغنولو (2009) أنّ إنتاج المعرفة ارتكز، لفترة طويلة، على افتراض أنّ الحقول المعرفية شفافة ومنفصلة عن الأحكام الجغرافية-السياسية؛ ومن هذا الموقع، تقوم بتصنيف المشاريع والأفراد والجماعات ضمن أنماط تُحدّد ما ينبغي فعله. وعلى الرغم من أنّ هذا ما أشارت إليه أيضاً هاراواي (2013)، فإن بعض الحقول الأكاديمية وبعض الباحثين ما يزالون ينكرون أنّ الشروط التاريخية والجيوسياسية هي التي تؤطر إنتاج المعرفة. وبالنسبة إلى ميغنولو، فإن مقاومة هذا الإنكار تستلزم ما يسميه بـ"العصيان المعرفي": أي ممارسة الانفصال عن وهم الحياد وعن الأطر المتمركزة أوروبياً. يفتح العصيان المعرفي فضاءات أمام أنماط ما بعد استعمارية في المعرفة، وأشكال بديلة للوجود في العالم. إن هذا التحليل مشروطٌ ومرتبطٌ بوضعيته؛ إذ أستند فيه إلى تجربتي كباحثة وعالمة نفس كويرية من قبرص، أجريتُ دراسات في قبرص والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويتيح لي هذا المسار استكشاف الكيفية التي يمكن أن يتجلّى بها العصيان المعرفي بصورة متباينة تبعاً للسياقات الجيوسياسية والمعرفية. وللتساؤل حول الشروط التي تدفع الحقول أو الفروع المعرفية إلى تموضعاتٍ ما، والصمت حيال حيثياتٍ أُخرى؟ أُعالج حالتين: 1- صمت مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الجريمة (ESC) المنعقد في بوخارست عام 2024 إزاء الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجارية في فلسطين؛ 2- الدراسات السجنية التي تروّج لبرامج "إنسانية" في السجون الإسرائيلية بوصفها نماذج لـ"اعتقال أقل± ايذاءً". تكشف هاتان الحالتان كيف تعمل الأطر الأكاديمية والمهنية الغربية على التعتيم، وأحياناً على إضفاء الشرعية الفعلية على الإبادة عبر اختزال مفهوم الجريمة بسلوكياتٍ فردية، ومساواة العدالة بالإصلاح المؤسسي.
دراسات الاعتقال بوصفها رفضاً معرفياً
أتعامل مع الاعتقال بوصفه مفهوماً وتجربةً أكثر شمولاً، يتشكّلان عبر أنظمة وممارسات وشروط من التقييد القسري. فالاعتقال يتجاوز حدود السجن المادّي ليشمل الديناميات الثقافية والاجتماعية والبنيوية التي تُطبّع مع أشكال المراقبة والتقييد والسيطرة، وتُظهِرها كممارسات عادية. هذا التأطير يكشف كيف تعتمد الدول الاعتقالية على نزع الإنسانية، مستعيرة تكتيكات تحاكي تلك التي توظفها أنظمة الإبادة، فيما تُخفي أشكال الأفعال القسرية الأقل وضوحاً عبر جعلها مألوفة. ومن هذا المنظور، تصبح دراسات الاعتقال إطاراً لا لتحليل السجون فحسب، بل لفهم النظم الأوسع التي تكرّس الاعتقال كأداة للهيمنة العرقية والاستعمارية والاقتصادية. واستجابةً لدعوة براون وشِبت (2016) إلى تطوير دراسات اعتقال نقدية تقاوم اصطفاف علم الجريمة مع سلطة الدولة ومنطق الإصلاح، أتعامل مع دراسات الاعتقال لا كحقل معرفي مستقل، بل كصيغة من الرفض المعرفي، صيغة تقدّر المعرفة المتموضعة وتزعزع السرديات التي تضفي الشرعية على علم الجريمة السائد. وهذا، بطبيعة الحال، يتشكّل انطلاقاً من موقعي الشخصي، غير أنّه يتقاطع مع جهودٍ أخرى تروم تجاوز القراءات الضيقة والشرعية القانونية للاعتقال نحو بلورة نقد أوسع للسلطة. إنّ ما أعنيه بدراسات الاعتقال لا يرمي إلى تأسيس حقلٍ معرفي جديد، بل إلى خلق فضاءٍ نقديٍّ للتأمّل والمقاومة، فضاء يستلهم تقاليد فكرية وسياسية متعدّدة من غير أن يتقيّد بالأصفاد المؤسسية. ولعلّه من غير المصادفة أن عدداً من الباحثين رأوا أنّ مفهوم "علم الجريمة ما بعد الاستعماري" قد يكون متناقضاً في ذاته (كريتشلو، 2023). فيما دعا آخرون إلى تطوير علم جريمة كويري-ما بعد استعماري (بول، 2019)، أو علم جريمة ما بعد استعماري جنوبي (ديمو، 2021)، أو حتى إلى إلغاء علم الجريمة برمّته (صالح-هانا، 2023). بالموازاة يؤكد آخرون على مركزية الإبطال، لا كموضوعٍ بحثيٍّ فحسب، بل كمنهجٍ وممارسة (لامبل، 2021). وإلى جانب هذه التدخّلات، دعا بالي (2022) إلى علم جريمة يقوم على العصيان/الطاعة، مسلّطاً الضوء على كيفية تجاهل علم الجريمة لسياسات التجريم الممارَسة ضدّ كلٍّ من النشاط السياسي وأشكال المعارضة، ما يعزّز ثقافة الطاعة والتواطؤ مع سلطة الدولة. تكشف هذه التدخلات مجتمعةً أنّ مقاومة أنظمة العقاب الدولاتية تعني في جوهرها، إعادة التفكير في الكيفية التي تُنتَج بها المعرفة ما يتعلق بمسألة الجريمة والعقاب، وكيف يجري إعادة إنتاجها وشرعنتها.
الحياد وسياسات المعرفة
تعرّف إحدى أبرز المؤسسات التنظيمية في ميدان علم الجريمة في أوروبا، وهي "الجمعية الأوروبية لعلم الجريمة" (ESC)، هذا العلم بوصفه شكلاً من أشكال المعرفة المتصلة بـ: "تفسير الجريمة والانحراف والوقاية منهما والسيطرة عليهما ومعالجتهما، بما في ذلك مرتكبو الجرائم وضحاياها، فضلاً عن قياس الجريمة والكشف عنها، والتشريع، وممارسة القانون الجنائي، وأجهزة إنفاذ القانون والأنظمة القضائية والإصلاحية" (ب.ت، القسم 2). هذا التعريف يعرض الجريمة والعقاب من خلال استعارة الفعل-الردّ، مغفلاً القراءات البنيوية الأوسع للاضطهاد. وصياغات مماثلة تطبع خطابات مؤسسات أخرى سائدة في الحقل. فعلى سبيل المثال، تصف "الجمعية الأميركية لعلم الجريمة" (ASC) نفسها أساساً بأنها جمعية مهنية وعلمية مكرّسة للسعي وراء المعرفة الأكاديمية (ب.ت). غير أنّ هذا الموقف لا يعترف صراحة بالشروط العرقية والسياسية للعقاب. في المقابل، تطوّرت تقاليد نقدية داخل هذه المؤسسات وخارجها. ففي الولايات المتحدة، كشفت مقاربات الإبطال والنسوية لدراسات السجون منذ زمن طويل عن الأبعاد السياسية والعِرقية للاعتقال، ولا سيما تشابكه مع إرث العبودية وأشكال العنف الدولاتي ضد السود (ديفيس، 2003؛ غيلمور، 2007؛ ألكسندر، 2010). وقد اتخذ قسم علم الجريمة النقدي والعدالة الاجتماعية (DCCSJ) التابع لـ ASC مواقف حاسمة، منها بيانه الأخير الذي عارض الإبادة في فلسطين، رابطاً بين نضالات الإبطال ضد منتظم السجون وبين النضالات الأوسع ضد الاستعمار والهيمنة العرقية (2024). وفي جنوب أفريقيا، ما تزال مؤسسات الاعتقال فرعاً مركزياً في نظام الحوكمة ضمن الدولة ما بعد الأبارتهايد، حيث تعيد إنتاج التراتبيات العرقية والطبقية تحت غطاء الخطاب الدستوري (جيليسبي، 2022). أما علم الجريمة النقدي في أستراليا فقد تطور في حوار وثيق مع نقد الاستعمار الاستيطاني ومع ظاهرة التجريم المفرط للسكان الأصليين، ما جعل السلطة الاستعمارية محوراً أساسياً للتحليل (هوغ وآخرون، 2017). وبالمثل، في الجنوب العالمي، حيث غالباً ما تُختبَر المؤسسات الاعتقالية بوصفها إرثاً مباشراً للحكم الاستعماري أو لإعادة الهيكلة النيوليبرالية، فإن النقد يتجسد في الغالب ضمن الحركات الاجتماعية ويتجذّر في تواريخ النضال الجماعي.
على النقيض، فإن إنتاج المعرفة حول الاعتقال في أوروبا يميل إلى أن يكون أكثر حذراً وضمن منطقٍ إصلاحي، ومرتبطاً بفكرة العقاب الرحيم. غير أنّ ثمة استثناءات مهمّة، أبرزها "المجموعة الأوروبية لدراسة الانحراف والضبط الاجتماعي" (EGSD&SC)، التي قاومت طويلاً هذه النزعات، وجعلت الأبعاد السياسية للعقاب في صدارة اهتمامها. وفي الوقت نفسه، لا يمكن إنكار أنّ بعض السجون الأوروبية – ولا سيما في شمال أوروبا – غالباً ما تُقدَّم، أو على الأقل تبدو، أكثر "عنايةً" بالمسجونين. فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، ألغت عقوبة السجن المؤبّد من دون إفراج مشروط في حكمها بقضية فينتر (2013)، كما وضع مجلس أوروبا إرشادات مفصّلة بشأن المعاملة الإنسانية للسجناء (سناكن، 2010). لقد ساهمت هذه الضوابط القانونية والمؤسسية في ترسيخ سردية الاعتقال الأوروبي بوصفه أكثر تنويراً أو إصلاحية، ما أسهم في إزاحة الحاجة إلى نقدٍ جذري. غير أنّ هذا المثال لـ"سجونٍ أفضل" قد يعمل في الواقع كآلية لإدارة الانزعاج من عنف الدولة، بدل مواجهته مباشرة. والنتيجة هي جسدٌ معرفيٌّ يُعيد، في كثير من الأحيان، إنتاج شرعية المؤسسات الاعتقالية تحت ستار الإصلاح التقدمي.
في هذا السياق الفكري، كثيراً ما تتمحور النقاشات السائدة في أوروبا حول المقارنات بين نماذج عقابية ناجحة، فيما يُهمَل البعد السياسي للاعتقال. وضمن هذا الإطار، غالباً ما تُمجَّد السجون الاسكندنافية بوصفها أكثر "إنسانية" (سميث، 2012). وتتماهى هذه السرديات مع الاتجاهات العقابية الأوروبية الأوسع، حيث يُستَحضر خطاب حقوق الإنسان لتقديم الاعتقال باعتباره ممارسة أكثر كرامة وانضباطاً (سناكن، 2010؛ دايمس وروبير، 2017). وسواء تجلّى ذلك في التفاؤل بأن السجون ستختفي في نهاية المطاف (تونري، 2022)، أو في الاحتفاء المقارن بالنزعة الإنسانية الأوروبية والاسكندنافية، فإن هذه المواقف تظلّ صامتة إزاء غزة بوصفها "سجناً في الهواء الطلق"، "سجناً شبه مفتوح"، على الرغم من أنها تُجسّد التداخل العميق بين الاعتقالية والاستعمار والإبادة. إن هذا الصمت ليس عرضياً، بل يعكس ثنائية معرفية أعمق داخل علم الجريمة الغربي.
بالنسبة إلى ليفي-شتراوس، تمتصّ المجتمعات القوى الخطيرة من خلال الإدماج (anthropophagy) أو تلفظها عبر الطرد (anthropemy) (فوكو، 2015:2). وقد شكّك فوكو في هذا الانقسام الواضح، مبيناً أنّ الاستيعاب والإقصاء هما تقنيتان متكاملتان بيد السلطة وليست بدائل منفصلة. استناداً إلى نقد فوكو لـ ليفي-شتراوس (2015) في The Punitive Society، فإن هذه الثنائية بين الإقصاء والاستيعاب، مع اعتبار الاستيعاب متفوّقاً بطبيعته، تُخفِي الحقيقة بأن كلا النظامين السجنيين "الإنساني" و"الوحشي" يعملان ضمن نفس المنطق الاعتقالي. فكلاهما يستخدم التطبيع والقسر، إما تحت غطاء الإدماج الاجتماعي، أو في حالة الإبادة، نحو الإبادة التامة. توضّح هذه الرؤية أيضاً سبب فشل خطابات الشمولية في المجتمعات النيوليبرالية، سواء في الدول الإسكندنافية أو هولندا، أو الأنظمة الأكثر تقدمية مثل كاليفورنيا، في تحدّي الهيمنة؛ فهي تَعِد بالاعتراف والإدماج لكنها تعمل كآليات تأديبية تُحيد الاختلاف. ففي كاليفورنيا على سبيل المثال، تتعايش الإصلاحات التي يُحتفى بها بوصفها تقدّمية مع أكبر نظام سجني في الولايات المتحدة (غيلمور، 2007؛ سيمون، 2014)، ما يظهر أن خطاب الشمولية يعمل بالتوازي مع، لا ضد السجن الجماعي. يمكن إذن قراءة الاستيعاب والإقصاء كآليات تأديبية: أحدهما يستبعد، والآخر يدمج من أجل الضبط (فوكو، 2015).
يقدّم مفهوم necropolitics لمبمبي (مبمبي، 2019) إطاراً لفهم كيفية حكم السلطة السيادية من خلال القدرة على تقرير مَن يعيش ومَن يموت، رابطاً بين الاعتقالية والإبادة بوصفهما نظم سيطرة على الفئات المهمّشة. يمتدّ هذا البعد إلى ما يتجاوز ما يمكن أن يستوعبه التفكير السائد في علم الجريمة حين يُنظَر إلى الجريمة بطريقة غير سياسية. تعمل الفضاءات الاعتقالية، مثل السجون ومعسكرات الاحتجاز، كـ"عوالم موت"، حيث تُسلَب الحياة تدريجياً أو تُدمَّر، بما يتوافق مع أهدافٍ إبادية. وغالباً ما يتجلّى شكل المقاومة في هذه الظروف عبر العنف الذاتي (فانون، 1963؛ فاسيليو، 2025).
الحلقة الأولى: الصمت في بوخارست
في أيلول/سبتمبر 2024، انعقد المؤتمر السنوي لـ ESC في بوخارست، رومانيا. خلال حفل الافتتاح، تمّ ذكر "جامعة القدس" دون أي إشارة إلى علاقتها بالدولة الإسرائيلية. وعلى مدى الأيام التالية، قدّم أكاديميون من خمس جامعات إسرائيلية: جامعة بار إيلان، الجامعة المفتوحة في إسرائيل، جامعة القدس، جامعة حيفا، وجامعة أريئيل، أبحاثاً تناولت مواضيع مثل العدالة الجنسية، الجريمة الاقتصادية، علاج التسامح، التحيّز الجنساني، السعادة والتصنيف الذاتي، تعاطي المخدرات، ونماذج ابتكارية للاعتقال. بعد المؤتمر، ألّفت مجموعة من المشاركين "رسالة من علماء الجريمة القلقين بشأن تمثيل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في ESC، بوخارست (11/9–14/9)" (2024). وفي ردّ على هذه المخاوف، أصدر المجلس التنفيذي لـ ESC بياناً رسمياً في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مؤكداً أنّ ESC "لا تدعم المقاطعة المؤسسية للمؤسسات الأكاديمية بناءً على بلد عملها"، مع التشديد على التزام الجمعية بـ"الحرية الأكاديمية، والاحترام المتبادل، والسعي وراء المعرفة الجنائية" (2024). وأوضح البيان كذلك أنه، باستثناء الإعلان عن العدوان الروسي على أوكرانيا، وهو صراع وقع داخل دولة عضو في مجلس أوروبا، فإن ESC "ستمتنع عن إصدار بيانات بشأن النزاعات الدولية خارج أوروبا".
الردّ والانسجام الانتقائي مع العنف الجيوسياسي
يعكس هذا الردّ مشكلةً أوسع داخل علم الجريمة الأوروبي السائد، وهي الانخراط الانتقائي مع العنف الجيوسياسي. تُظهر الجمعية الأوروبية لعلم الجريمة (ESC) ازدواجيةً مؤسسية في استعدادها للحديث عن أوكرانيا، بينما تلتزم الصمت إزاء الإبادة الاستيطانية الإسرائيلية في غزة؛ إذ يُستَحضر مفهوم "الحياد" لحماية أشكالٍ معيّنة من عنف الدولة، وفي الوقت نفسه يُرفَّع بعضُ الفاعلين الدوليين عن النقد. يُقدّم ديدييه فاسين (2025)، الأنثروبولوجي الفرنسي الذي كتب كثيراً عن السجون والشرطة والدولة الاعتقالية، في كتابه Moral Abdication تحليلاً دقيقاً لاستجابة الحكومات والمؤسسات والأوساط الأكاديمية الغربية لعملية تدمير غزة، موضحاً أنها لا تمثل فشلاً في الفعل فحسب، بل فشلاً في التفكير ذاته. يبيّن فاسين كيف جرى تجنّب استخدام كلمات مثل "الإبادة الجماعية (genocide)" أو "التطهير العرقي (ethnic cleansing)"، ما يُفضي إلى صمتٍ متواطئ تحدّد السلطة السياسية قواعده وحدوده. يرتبط تحليل فاسين بفكرة المؤرخة والفيلسوفة حنة آرندت، التي رأت في كتابها الصادر عام 1963 أنّ رفض التفكير النقدي يمكن أن يجعل الأفراد متواطئين مع العنف. وفي سياق علم الجريمة، حيث يُنظَّر إلى الحياد والموضوعية غالباً باعتبارهما فضيلتين أكاديميتين، يُذكّرنا نقد فاسين بأن الصمت أو اللغة المحايدة قد يسهمان في ترسيخ أنظمة القمع. تتجلّى هذه الديناميكية أيضاً في حركة العدالة التصالحية (restorative justice)، التي غالباً ما بقيت صامتةً تجاه عنف الدولة والاستعمار. وكما يشير بالي (2018)، فإن ارتباط هذه الحركة بأجندات "مكافحة الإرهاب" يجعلها عرضةً لخطر تعزيز سلطة الدولة بدلاً من تحدّيها. يُثير هذا الطرح سؤالاً جوهرياً: ماذا يعني الحديث عن العدالة إن كنّا عاجزين عن تسمية مصادر العنف؟
لا أتعامل مع هذا الأمر بوصفه إغفالاً عرضياً، بل نتيجةً لأُسسٍ ترسّخت فيما نُسمّيه بالتخصّصات العلمية وما تسمح بطرحه، أي إن ما يُسمّى بالـ"حياد" ليس تعبيراً عن موقفٍ لا سياسي بل هو تجسيدٌ لأحكامٍ مُرسخةٍ تاريخياً فيما نسمّيه المدارس التخصصية. هل يمكن لحقلٍ معرفيٍّ أن يتخذ موقفاً علنياً إزاء فلسطين إن كان أرشيفه عاجزاً عن تسمية عنف الدولة؟ وهل ترتبط الحقول المعرفية على نحوٍ وثيقٍ بمؤسسات الدولة التي تعيد بالضرورة إنتاج الصمت، بيد أن تلك المتشكلة عبر التقاليد النقدية يمكنها وضع المقاومة في الصدارة؟ وهل يمكن لأفعال العصيان المعرفي الجماعية (epistemic disobedience) فرض قطيعة معرفية مع سيرورةٍ مُهيمنة؟
الحياد المهني وإنتاج المعرفة في علم الجريمة
إن ما يُسمّى بـ"الحياد" في علم الجريمة، مرتبط عضوياً بالدولة ومؤسساتها على غرار المحاكم والسجون – وهي نفسها المؤسسات التي تحافظ على شرعية الدولة ذاتها. يعزّز هذا الاصطفاف هياكل التمويل ومشاريع البحث التعاوني؛ فالأبحاث التي تُجرى مع وكالات الشرطة والسجون أو لصالحها، تدمج المعرفة الجنائية ضمن أجندات الدولة، وتكافئ الأبحاث التي تحافظ على السلطة المؤسسية بدلاً من تحدّيها. إن كسر موقف الحياد يعني تقويض شروط وجود علم الجريمة بحدّ ذاته. بالمقابل، فإن الأطر النسوية ومدارس الإجهاز على نظام السجون والمدارس ما بعد الاستعمارية ليست مرتبطة بهيكلية الدولة؛ إذ غالباً ما تأتي شرعيتها من النقد والعصيان المعرفي (epistemic disobedience). ومن هذا المنطلق، فإن اتخاذ موقفٍ إزاء فلسطين ليس انتهاكاً لقواعد الحقل المعرفي بل تطبيقاً لأحكامها. استناداً إلى هذا، يمكن القول إن علم الجريمة يقدّم نفسه بوصفه موضوعياً ومحايداً، بينما تقيّده قواعد إنتاج المعرفة في فهم الجريمة والعقاب، مفضّلاً التفسيرات الوضعية للسلوك الفردي على العنف البنيوي. وبهذه الطريقة، ينتج صمتاً حول الاستعمار والهيمنة العرقية وحتى الإبادة الجماعية، معيداً إنتاج استمرارية سلطة الدولة. بالمقابل، تفتح الحقول مثل الدراسات النسوية والجندرية والدراسات العرقية والأنثروبولوجية ودراسات السجون النقدية والمقاربات ما بعد الاستعمارية فجوات معرفية. فهي تتحدى الحياد الكامن شكلاً ضمن القواعد التخصصية المُمأسسة واضعةً علاقات القوة في صدارة التحليل. هكذا يُخلَق فضاءٌ للعصيان المعرفي. تتفاعل مجالات المعرفة المختلفة، والتقاليد التخصصية المؤسسة، والمواقع الجغرافية مع هذا الطرح التجريبي بطرقٍ متباينة. فعلى سبيل المثال، أدانت "الرابطة الأوروبية لأبحاث تعليم العلوم" (European Science Education Research Association – ESERA, 2025) و"الجمعية الأسترالية والنيوزيلندية لعلم الجريمة" (Australian and New Zealand Society of Criminology – ANZSOC, 2025) مؤخراً "جرائم الحرب" في غزة، موضحتَين أن الحياد في أوقات "الأزمة الإنسانية" يرقى إلى درجة التواطؤ. ورغم أن ESERA منظمة تلتزم أيضاً بقواعد الحياد والموضوعية، فقد ركزت التعليقات المنشورة من قِبل القرّاء والأعضاء على فكرة أنه لا ينبغي للمنظمة اتخاذ مواقف سياسية رسمية. ومن جهةٍ أخرى، وعلى أُسسٍ معرفية وتقاليد بحثية مغايرة، أصدرت "الرابطة الأوروبية للأنثروبولوجيين الاجتماعيين" (European Association of Social Anthropologists – EASA, 2023) و"الجمعية الدولية لعلم الاجتماع" (International Sociological Association – ISA, 2024) بيانات قوية تُدين العنف، حتى إن ISA أوقفت علاقاتها مع الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع. ومع ذلك، فإن هذه الفروق دائماً ما تتأثر بالسياق المؤسسي والجيوسياسي، فضلاً عن الظروف الشخصية لمن يشغلون مناصب مؤثرة داخل الجمعيات. فمثلاً، أنهى "معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية" في ألمانيا عقده مع غسان الحاج كأنثروبولوجي في شباط/فبراير 2024 بعد أن أبدى الأخير دعمه لفلسطين ولحركة BDS "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (Scholars at Risk, 2024).
إنتاج المعرفة الأكاديمية والحياد المفترض: قراءة نقدية فلسفية
علاوة على ذلك، إذا نُظر إلى إنتاج المعرفة الأكاديمية بوصفه مجرد تجسيد للحرية الأكاديمية، ومنفصلاً بطبيعته عن سياسة الدولة وبالتالي خارج نطاق النقد، فإننا نفشل في رؤية الحالات التي تمّ فيها تفنيد هذا الافتراض الجوهري. في كتاب The Cunning of Gender Violence (أبو لغد وآخرون، 2023)، يُظهر المؤلفون، من خلال دراسات حالات متعدّدة، كيف أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، حين يُحدَّد بشكل ضيق وفردي، يُفصَل عن بنية الدولة الاستعمارية، وتصبح المعرفة الأكاديمية غير قادرة على مساءلة الآليات البنيوية لإنتاج العنف. في هذا الإطار، تؤدي الأجندات العالمية لمكافحة العنف الجنسي إلى إعادة إنتاج التراتبيات الحضارية نفسها، بدل أن تفككها. ففي فلسطين، تُستغَلّ المعاناة المفترضة للنساء لتبرير التدخلات الإنسانية أو العسكرية، في حين يُمحى السياق الأوسع للفصل العنصري والاحتلال والاستعمار الاستيطاني. وكما توضح (شلهوب-كيفوركيان 2017:1279) في تحليلها لـ"احتلال الحواس" في القدس الشرقية، فإن الاستعمار الاستيطاني لا يقتصر على الأرضية الإقليمية بل يتجسد ويغزو الحواس، منتجاً عنفاً يستعمر الحياة اليومية ويُطبَع على الأجساد الفلسطينية. في غزة، يترافق القلق الدولي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي غالباً، مع صمتٍ صارخٍ إزاء العنف الإنجابي، والنزوح القسري والهجمات المستهدفة للمستشفيات من قبل إسرائيل. تعمل هذه التأطيرات الليبرالية للعدالة بوصفها إجراءات شكلية، والعنف الجنسي بوصفه مرضاً فردياً، على تعزيز سلطة الدولة بدلاً من تحديها، فتصبح المعرفة الأكاديمية أداةً لترسيخ أنظمة الهيمنة. وهكذا، فإن تجاهل هذه الهياكل البنيوية ليس مجرد غياب أو تقصير معرفي، بل شكلٌ من أشكال التواطؤ مع الدولة التي تنتج العنف. الدولة، في هذا السياق، قد تُقدّم نفسها كراعٍ خيّر يدافع عن حقوق النساء، بينما تُخفي منظومة عنفها. وأوضح تجليات هذا التواطؤ هو استغلال حقوق "ميم عين" كأداة لتغطية العنف، حيث توظّف إسرائيل استراتيجيات "الغسيل الوردي" لتصوير نفسها كدولة ليبرالية وصديقة للمثليين، بدلاً من الاعتراف بدورها كقوة استعمارية قمعية (شافعي، 2015).
علم الجريمة والحياد الأكاديمي كأداة احتواء معرفي
بنفس المنطق، في سياق علم الجريمة كمؤسسة أكاديمية، فإن الدعوات إلى "العدالة" التي تتجاهل تاريخ العنف العرقي والاستعماري والاعتقالي، معرّضة لأن تتحول إلى أدوات احتواء معرفي (epistemic containment). وهذا يعني أن الحياد الأكاديمي، أو العجز عن نقد المؤسسات الأكاديمية، يمكن أن يصبح أداة تواطؤ معرفية (epistemic complicity). كما يجادل ميغنولو (2009)، فإن العصيان المعرفي (epistemic disobedience) يستلزم الانفصال عن أنماط المعرفة المهيمنة التي تقدم نفسها على أنها غير سياسية. ويجب أن تشمل الحرية الأكاديمية حرية النقد والمقاومة ورفض المشاركة في الأنظمة التي تكرّس المعاناة الإنسانية تحت ستار الحياد العلمي. يحافظ موقف ESC على مظهر من الحياد، وإن كان حياداً متناقضاً، لكنه في الوقت نفسه يتهرّب من معالجة الديناميات البنيوية للسلطة التي تقوم عليها عمليات إنتاج المعرفة وسياسات التمثيل العالمية.
اليوغا السجنية والعدالة التصالحية للسجناء الإسرائيليين
يحدث تبييضٌ مماثل لعنف الدولة من خلال الترويج لبرامج رفاهية السجون وآليات تبدو أقلّ ضرراً. ففي دولة إسرائيل، شكّل هذا الخطاب برامج إعادة التأهيل التي تركز على الصحة والرفاهية، مثل اليوغا السجنية والوعي الذهني (mindfulness) (كوفالسكي وآخرون، 2020)، فضلاً عن مبادرات العدالة التصالحية التي تُعطي الأولوية للمساءلة والشفاء (بيليغ-كوريات وويمان-ساكس، 2019). تُقدَّم المبادرات الصحّية في السجون على أنها تحقّق فوائد ملموسة في الصحة الجسدية والنفسية (تيسلر وآخرون، 2023). لكن على أرض الواقع، تُطبَّق هذه البرامج بشكلٍ أساسي في السجون المخصَّصة للمواطنين الإسرائيليين. ويبرز هذا التطبيق الانتقائي كيفية عمل نظام الفصل العنصري: فبينما تُقدَّم السجون الإسرائيلية كمواقع للعناية وإعادة التأهيل، يواصل السجناء الفلسطينيون مواجهة التعذيب المنهجي والإهمال الطبي والانتهاكات الجنسية تاريخياً وفي الوقت الراهن (الضمير، ب.ت.). إن تداول مثل هذه الادعاءات في المنشورات الأكاديمية يكشف عن فشل أوسع: إذ غالباً ما تفشل المراجعات العلمية وعمليات التحرير والجمعيات العلمية في مساءلة هذا البحث، مما يسمح للمعرفة الأكاديمية في مجال السجون بإعادة إنتاج دعاية الدولة تحت ستار العلم المحايد. وأشار النص إلى أن هذه البرامج مخصَّصة فقط للمواطنين الإسرائيليين، بينما يواجه الفلسطينيون التعذيب والإهمال، ويُعد هذا بالفعل شكلاً من أشكال العصيان المعرفي (epistemic disobedience) لأنه يتحدى الصمت الذي غالباً ما تحميه المؤتمرات والمراجعات العلمية.
العقلانية الكامنة وراء البرامج التصالحية والمتمحورة حول الصحة تصبح ركيزةً تُبرَّر من خلالها الإبادة الجماعية، إذ تُقدَّم هذه البرامج بوصفها وجهاً إنسانياً للاحتلال في الساحات الأكاديمية ومجالات السياسات الدولية. وبينما تُظهر هذه المبادرات مظهر التعاطف والرحمة، فإنها تعمل ضمن نظام تُحرَم فيه الحاجات الأساسية – مثل الرعاية الطبية، والوصول إلى الغذاء، وحرية التنقل – من الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، فتتحوّل الصحة من حقٍّ إنساني إلى أداة بيوسياسية للسيطرة، تحدّد من يأكل ومن يموت جوعاً. هكذا يبتدع تعايش بين خطاب العافية من جهة والجوع البنيوي والإهمال الطبي من جهة، مولِّداً شكلاً بطيئاً من العنف يعكس أفعال الإبادة ذاتها. كما يكشف إنتاج هذا النمط من المعرفة الأكاديمية، وإدراج هذه "النتائج" في مؤتمرات علم الجريمة، عن انفصام في عملية إنتاج المعرفة ذاتها: من جهة، إدانة العنف ضد الأسرى، ومن جهة أخرى، صمت سياسي وموافقة ضمنية على عنف الدولة. يعكس ذلك اصطفافاً معرفياً أوسع يسمح للمجتمعات الأكاديمية، مثل "الجمعية الأوروبية لعلم الجريمة" (ESC)، بالتموضع في حيادٍ زائف أمام جريمة الإبادة.
الفصل الثاني: العصيان المعرفي كفعلٍ وممارسة
أكتب هذه السطور بعد أيام قليلة من مؤتمر "الجمعية الأوروبية لعلم الجريمة" (ESC) لعام 2025، الذي عُقد في أثينا بين 3 و6 أيلول/سبتمبر 2025. فقد تقدّم علماء الجريمة من أجل فلسطين (Criminologists for Palestine – CfP)، وهم تجمّع من أعضاء الجمعية المناهضين لإبادة إسرائيل، بمقترح إلى الجمعية العامة يدعو إلى قطع علاقات الجمعية مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة في هذه الجرائم، وعلى رأسها جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة غير قانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (2025). كما نظّم هذا التجمع أنشطة يومية خلال المؤتمر. ورغم أن المقترح حظي بتأييد واسع في الجمعية العامة، فإن مجلس إدارة الـESC رفض السماح بالتصويت عليه، مما أبقى على تواطؤ الجمعية مع الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل (المصدر نفسه). وهكذا، لم تظهر الإبادة الجارية في فلسطين داخل المؤتمر كصراع جيوسياسي فحسب، بل كإمكانية لخلق قطيعة معرفية – لحظة تجبر التخصصات الأكاديمية على مواجهة تواطؤها أو الاستغراق في صمتها. إن بروز علماء الجريمة من أجل فلسطين يجسّد هذا الضغط؛ فتنظيمهم دفع الجمعية إلى أن تختار بين الاستمرار في الاحتماء وراء خطاب الحياد الأكاديمي، أو مواجهة تورطها في عنف الدولة. ومن هذا المنظور، فإن هذا التجمع يمثّل العصيان المعرفي في ممارسته العملية، إذ يفتح إمكانية إحداث شرخ داخل حقل أكاديمي طالما شكّلته النزعة الإصلاحية والحياد المزعوم. وتبقى بعض الأسئلة مطروحة: هل تستطيع جمعية أكاديمية، ومعها التخصص الذي تمثّله، أن تستوعب قطيعة معرفية عبر اختيار الصمت حيال فلسطين؟ وهل يمكن لأفعال الرفض الجماعية – مثل مبادرة علماء الجريمة من أجل فلسطين – أن تفرض لحظة التحرر من السيرورة المؤسسية؟
الخاتمة
أظهر هذا المقال كيف أنّ علم الجريمة الأوروبي السائد غالباً ما يتعامل مع مسألة السجن باعتبارها مشكلة تقنية ينبغي إدارتها، لا مشروعاً سياسياً متجذّراً في الاستعمار والهيمنة العرقية والممارسة الإبادية. وعند قراءة هذا الصمت من خلال عدسة فوكو، يتضح أن هذه الظاهرة ليست عَرَضيه؛ فالقواعد المترسخة في المناهج التخصصية هي التي تحدّد ما يمكن قوله وما يمكن دراسته. يذكّرنا مبمبي (2019) بأن الأنظمة العقابية هي التي تُقرّر من يحق له أن يعيش ومن يُحكم عليه بالموت، فيما يدعونا ميغنولو (2009) إلى القطيعة مع أنماط المعرفة والوجود "الحيادية" التي تُخفي تلك الحقيقة العقابية. من خلال تركيزها على أسئلة الكفاءة المؤسسية، وتنميط النماذج الاوروبية لأنظمة السجون، والتكيّف الفردي، والرفاه النفسي، فإن هذه المقاربة في إنتاج المعرفة تُخفي العنف البنيوي الكامن في السجن وتُضفي شرعية على سلطة الدولة. لمواجهة العنف "الناعم" الكامن في فكرة السجون "ذات السياسات الإنسانية" وخطابات المعاملة الحميدة مع السجناء التي تُجمّل القسوة، علينا أن نفكّ ارتباطنا بأنماط المعرفة التي تنظر إلى السجن كمسألة لا سياسية، أو كنتيجة لفشل أخلاقي فردي. إن العصيان المعرفي يعني تحدّي ما يُعتَبر "معرفة مشروعة" ضمن الأطر السائدة لعلم الجريمة. إن العصيان يقتضي رفض المشاركة في السرديات العقابية التي تجعل الإبادة الجماعية تبدو قابلة للإدارة أو الإصلاح. ومن هذا المنطلق، يتطلّب العصيان المعرفي أن نعترف بالانقكاكات المعرفية القائمة أصلاً في الجمعيات والمؤتمرات والمجلات وقاعات الدراسة، وأن نُنتج أشكال عصيان جديدة حيثما يجري تطبيع فكرة الحياد. ولا يُقصد من ذلك تمجيد المقاومة المطلق فممارسات العصيان المعرفي يجب أن تراعي اختلاف المواقع التي يتحدث منها الأفراد، سواء داخل الأوساط الأكاديمية أو على هوامشها – بما في ذلك أولئك الذين تفرض عليهم أوضاعهم الهشّة، مثل الاعتماد على التأشيرات أو العقود غير المستقرة، حدوداً على ما يمكنهم تحمّله من مخاطر. وعليه، ينبغي فهم العصيان المعرفي بوصفه نقداً وممارسةً في آنٍ واحد، يصرّ على المساءلة الفكرية والسياسية، ويشكّل طريقاً لكسر الصمت وإعادة تخيّل الإمكانات المعرفية.
Abu-Lughod, L., Hammami, R., and Shalhoub-Kevorkian, N. (eds.). (2023). The Cunning of Gender Violence: Geopolitics & Feminism. Durham: Duke University Press.
Addameer (n.d.). Addameer Prisoner Support and Human Rights Association. https://addameer.ps/
Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.
American Society of Criminology. (n.d.). About ASC. ASC. https://asc41.org/about-asc/
Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press.
ANZCS (2025). Statement on the war in Gaza and genocide of the Palestinian people. Australian and New Zealand Society of Criminology, August 26. https://anzsoc.org/wp-content/uploads/2025/08/Statement-on-the-war-in-Gaza-and-genocide_REVISED_26_8_25.pdf
Brown, M., and Schept, J. (2017). New abolition, criminology and a critical carceral studies. Punishment & Society, 19(4), 440–462.
CfP (2025). Criminologists for Palestine [Blog]. https://criminologists4palestine.wordpress.com/
CfP (2025). ESC General Assembly shows overwhelming support for motion; ESC Board denies vote. Criminologists for Palestine, September 9. https://criminologists4palestine.wordpress.com/esc-denies-vote-protects-complicity-in-israels-atrocity-crimes/
Crichlow, W. (2023). Decolonial Criminology: Oxymoron for Necrocapitalism, Racial Capitalism, and the Westernization of the Professoriate. In C. Cunneen, A. Deckert, A. Porter, J. Tauri, and R. Webb (eds.), The Routledge International Handbook on Decolonizing Justice. Abingdon-on-Thames: Routledge, 459–468.
Daems, T., and Robert, L. (eds.). (2017). Europe in Prisons: Assessing the Impact of European Institutions on National Prison Systems. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Davis, A. Y. (2003). Are Prisons Obsolete? New York: Seven Stories Press.
DCCSJ (2024). The Division on Critical Criminology and Social Justice (DCCSJ) Executive Statement Opposing the Genocide of Palestine. ASC Division on Critical Criminology & Social Justice, November 11. https://divisiononcriticalcriminology.com/
Dimou, E. (2021). Decolonizing Southern Criminology: What Can the “Decolonial Option” Tell Us About Challenging the Modern/Colonial Foundations of Criminology? Critical Criminology, 29(3), 431–450.
EASA (2023). EASA executive statement on the situation in Gaza. European Association of Social Anthropologists. https://easaonline.org/letters-of-support/easa-executive-statement-on-the-situation-in-gaza/
ESC (n.d.). Constitution of the European Society of Criminology. European Society of Criminology. https://esc-eurocrim.org/v2/constitution-of-the-european-society-of-criminology/
ESC (2024). Statement of the Executive Board of the European Society of Criminology. European Society of Criminology, November 8. https://esc-eurocrim.org/v2/news/
EGSD&SC (n.d.). Constitution and Values. European Group for the Study of Deviance & Social Control. https://www.european-group.org/constitution-and-values/
ESERA (2025). ESERA Statement on the humanitarian crisis in Gaza. European Science Education Research Association, August 11. https://www.esera.org/22568-2/
Haraway, D. (2013). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In M. Wyer, M. Barbercheck, D. Geisman, H. Örün Öztürk, & M. Wayne (eds.), Women, Science, and Technology: A Reader in Feminist Science Studies. Abingdon-on-Thames: Routledge, 455–472.
Hogg, R., Scott, J., and Sozzo, M. (2017). Southern Criminology: Guest Editors’ Introduction. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 6(1), 1–7. https://www.crimejusticejournal.com/article/view/850/613
Fanon, F. (1963). The Wretched of the Earth, C. Farrington (trans.). New York: Grove Press [1961].
Fassin, D. (2025). Moral Abdication: How the World Failed to Stop the Destruction of Gaza. London: Verso Books.
Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison, A. Sheridan (trans.). New York: Pantheon Books [1975].
Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, & K. Soper (trans.). New York: Pantheon Books.
Foucault, M. (2002). The Archaeology of Knowledge, A. M. Sheridan Smith (trans.). Abingdon-on-Thames: Routledge [1969].
Foucault, M. (2015). The Punitive Society: Lectures at the Collège de France 1972–1973, G. Burchell (trans.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Gilmore, R. W. (2007). Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California. Berkeley: University of California Press.
Gillespie, K. (2022). Racialized Punishment and Post-Apartheid Contradictions: Notes from South Africa. In J. Meiners & A. James (eds.), Abolition Feminisms Vol. 1: Organizing, Survival, and Transformative Practice. Chicago: Haymarket Books, 213–228.
ISA (2024). ISA Executive Committee Decision on the Israeli Sociological Society. International Sociological Association. https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/isa-human-rights-committee/ec-decision-israeli-sociological-society
Kovalsky, S., Hasisi, B., Haviv, N., and Elisha, E. (2020). Can Yoga Overcome Criminality? The Impact of Yoga on Recidivism in Israeli prisons. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 64(13-14), 1461–1481.
Lamble, S. (2021). Practising Everyday Abolition. In K. Duff (ed.) and C. Sims (illust.), Abolishing the Police: An Illustrated Introduction. London: Dog Section Press, 147–161. https://abolitionistfutures.com/latest-news/practising-everyday-abolition
Letter from Concerned Criminologists regarding the Representation of Israeli Academic Institutions at the ESC, Bucharest (11/9–14/9). (2024). Google Docs, September 14. https://docs.google.com/document/d/1_v73Jg0mzKcjX9QYM48mBCR1WSCNlni2/
Pali, B. (2018). Restorative justice and terrorism: resisting evil with non-evil? Security Praxis, October 11. https://www.securitypraxis.eu/restorative-justice-and-terrorism/
Pali, B. (2022). A Criminology of Dis/Obedience? Critical Criminology, 31(1), 21–38.
Mbembe, A. (2019). Necropolitics, S. Corcoran (trans.). Durham, Duke University Press. [2003].
Mignolo, W. D. (2009). Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom. Theory, Culture & Society, 26(7-8), 159–181.
Peleg-Koriat, I., and Weimann-Saks, D. (2019). The attitudes of prisoners towards participation in restorative justice procedures. The International Journal of Restorative Justice, 2(1), 49–64.
Saleh-Hanna, V., Williams, J. M., and Coyle, M. J. (eds.). (2023). Abolish Criminology. Abingdon-on-Thames: Routledge.
Scholars at Risk (2024). Max Planck Institute for Social Anthropology. Scholars at Risk Network, February 7. https://www.scholarsatrisk.org/report/2024-02-07-max-planck-institute-for-social-anthropology/
Shafie, G. (2015). Pinkwashing: Israel’s International Strategy and Internal Agenda. Kohl: a Journal for Body and Gender Research, 1(1), 82–86. https://kohljournal.press/pinkwashing-israels-international-strategy
Shalhoub-Kevorkian, N. (2017). Occupation of the Senses: The Prosthetic and Aesthetic of State Terror. British Journal of Criminology, 57(6), 1279–1300.
Simon, J. (2014). Mass Incarceration on Trial: A Remarkable Court Decision and the Future of Prisons in America. New York: New Press.
Snacken, S. (2010). Resisting punitiveness in Europe? Theoretical Criminology, 14(3), 273–292.
Tesler, R., et al. (2023). Health promotion programs in prison: Attendance and role in promoting physical activity and subjective health status. Frontiers in Public Health, 11, 1189728.
Tonry, M. (2022). Punishments, Politics, and Prisons in Western Countries. Crime and Justice, 51(1), 7–57.
Vasiliou, E. (2025). Self-destruction in prison: A queer view on pain through decolonial and psychoanalytic theory. Theoretical Criminology, 0(0). https://doi.org/10.1177/13624806251350622