خارطة للصمت، والمسافات ما بينه
خلود فواز باحثة ومروجة صحية ومترجمة. حصلت على درجة البكالوريوس في علوم المختبرات الطبية وهي حاصلة على درجة الماجستير في الصحة العمومية من الجامعة الأمريكية في بيروت. تشمل اهتماماتها البحثية الرئيسية الصحة الجنسية والإنجابية وصحة مجتمع الميم والمشاكل الصحية بين السكان المشردين/ات. شاركت في المساحات النسوية، وهي عضو في تعاونية الضمة النسوية المحلية، ونادي السنديانة الحمراء في الجامعة الأمريكية في بيروت وهي مجموعة طلابية يسارية. تشمل خبرتها المهنية البحوث الطبية الحيوية في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، وإعداد التقارير في اليونيسف، وتعزيز الصحة في منظمة أطباء بلا حدود (MSF) مع التركيز على العنف الجنسي بين السكان اللاجئين/ات، وترجمة وتحرير مختلف مواد الصحة الجنسية والإنجابية و مواد نسوية لمشروع الألف وكحل على التّوالي.
Internal Clash.png
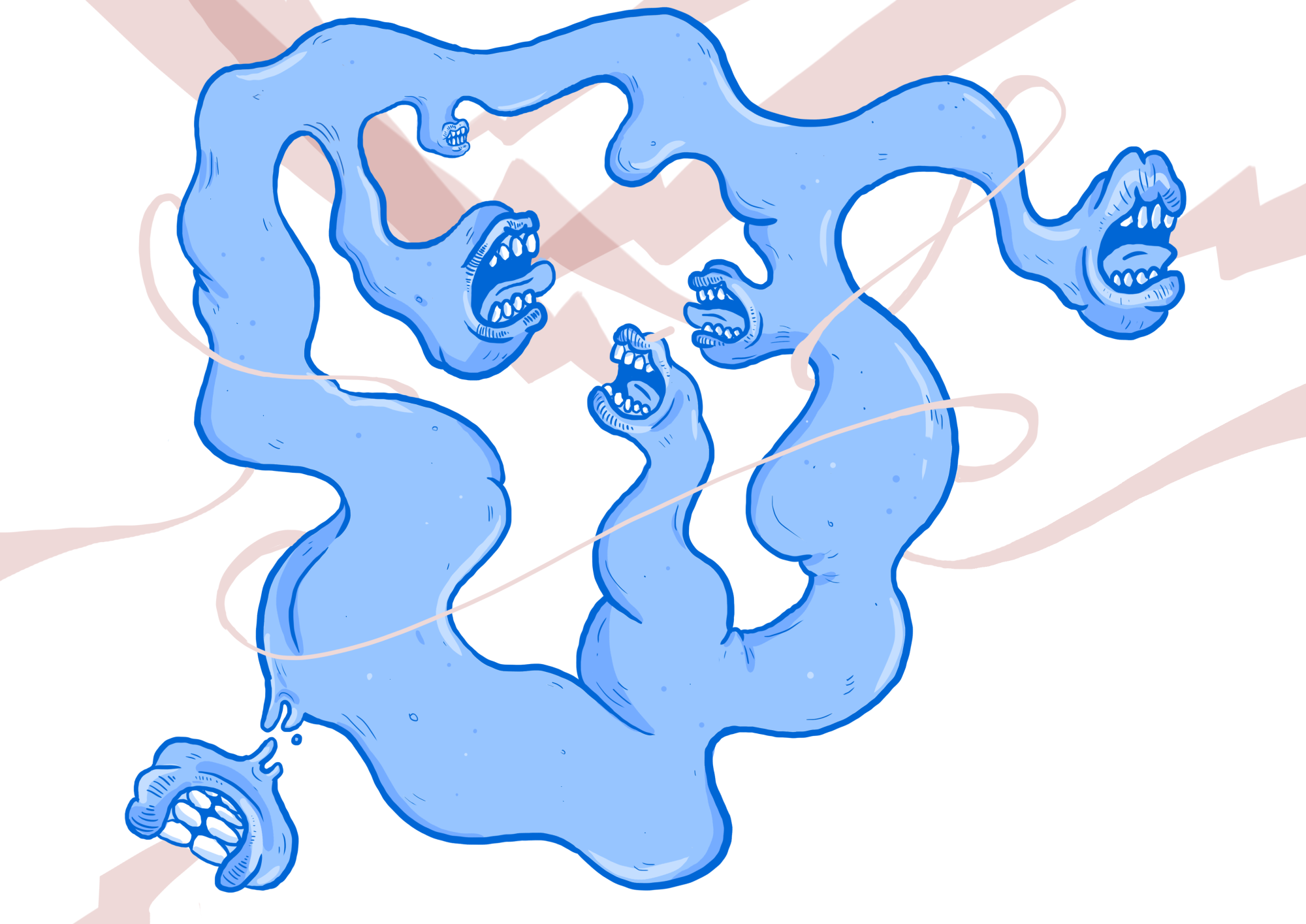
تصادم داخلي
عندما اصطففنا للمرّة الأخيرة على درج محكمة ديترويت، كنتُ قد انتقلت إلى هناك. كالعادة، ضجّت قاعة المحكمة الضخمة بأصداء أصوات خشخشة المفاتيح والأحزمة في الصناديق البلاستيكيّة، بينما كان الحرّاس يتلمسون أجسادنا بكفوفهم. قبل أن يصدر القاضي دراين أمر الترحيل، طلب من رسميّة أن تقرأ خطابها الأخير. وبينما كانت تتكلّم، اكتظّت الدموع في كعب حنجرتي. توقعّتُ سردًا شخصيًا مؤثّرًا، لكن خطابها كان أشبه بمقالة على ويكيبيديا عن الصراع الفلسطيني. همسَ صوت في أذني: "رسميّة لم تكتب ذلك". أدركتُ من رغمًا عني أنّها صمتت منذ وقت طويل، قبل أن يأمرها القاضي بالتوقّف عن الكلام.
فيما بعد، سارت صفوف المعتصمين/ات إلى أعلى وأسفل لافاييت بحركة بيضاوية، الواحد/ة تلو الآخر / الأخرى في تباعد منتظم. مشيتُ بحذرٍ في هذا الصفّ لسنوات عديدة، وهتفتُ حتى انبّح صوتي، في البرد القارس والمطر الذي باتت قطراته هالات تلمع فوق رؤوسنا، لكننا صرخنا "سننتصر!". وبينما كنّا نتنقّل صعودًا ونزولًا، مربّتين/ات على أكتاف رفاقنا / رفيقاتنا. كالأسماك، توجّهنا كما الأسماك إلى شبكة صيد مهولة، لكن غير مرئيّة. في تلك الأيّام، كنّا نسحب الأمل من حناجر بعضنا البعض، وتحاشينا خوض أيّ وكان نقاش حول نهاية أخرى لما يجري من حولنا. لم نرد أن نصدق أن كل شيئ ينهار. بل قاومنا وآمنّا بشعاراتنا، حتى غدت جماعية وعظيمة، كما لو كان تكرارها سيجسّد شكل العدالة.
في ذلك اليوم الأخير، بدا لي الحشد الذي كان يهتف على الرصيف أمام قاعة المحكمة كسيرك، تمامًا كغرفة القاضي الرخامية. تبجّح الرجال، الذين أعرف أنهم عنيفون، بخطابات عن تحرير النساء. أصبحت الحملة التي استمرّت أربع سنوات للتضامن مع رسميّة عودة، الناشطة في التنظيم المجتمعي الفلسطيني التي كانت حينها في الـ 70 من عمرها، من أجل عدم ترحيلها بسبب نشاطها السياسي، جوهرة نسوية تتوّج مسيرة الرجال السياسية وتضعهم في مقدّمة النضال. هؤلاء الرجال، خلال سعيهم نحو مشروع التحرير الفلسطيني المثالي المتمركز حول النساء، تركوا وراءهم، عددًا لا يحصى من النساء المشتتات. نساء استُبعدن إلى مكان بعيد جدًا.
يومها، وبعد حالة الذهول نتيجة الخطابات والكاميرات، وقفتُ وشاهدتُ الجميع يستقلّون الحافلة التي ركبتها مرّات عديدة. تذكّرتُ حينها كيف كنّا نهتف بينما نقف على الدرجات الطويلة المغلّفة بالمطّاط في موقف السيارات في المسجد قبل بزوغ الشمس، مرخيين/ات برؤوسنا على النوافذ الباردة بينما كنّا ننزل إلى أسفل I-94، هذا الشريان الذي يربط مدينتينا التوأم محلّقًا خارج النافذة. خلال تلك الرحلات الطويلة بين شيكاغو وديترويت، نمت صداقات وتحالفات وانفجرت وتحوّلت باستمرار، ولكن استمرينا نركب هذه الحافلة معًا، ونلعب لعبة الكراسي الموسيقية الدائمة التجدّد على أنغام أغاني الزفاف الفلسطينية، وخشخشة زجاجات المياه البلاستيكية وأصوات فتح أكياس "التشيبس"، لنصل إلى شيكاغو في وقت لاحق من مساء ذلك اليوم، حيث السماء مظلمة كما كانت عندما غادرنا.
في ذلك اليوم الأخير، قبل التوجّه إلى سيارتي، شاهدتُ الحافلة وهي تغادر بعيدًا، بينما نشرت الشمس ضوءها الذهبي المتناثر على طول أسطح مدينتي الجديدة.
أصبح منزل نور، في مرحلة ما خلال تلك السنوات، منزلي الديترويتي البعيد عن المنزل. في إحدى صباحات أواخر نيسان / أبريل، جلست مجموعة منّا على شرفة الطابق الثاني بملابس النوم، نتأمّل العشب الذي ينتظر التجذيب. وفيما كنّا نرتشف القهوة الساخنة ونشاهد الحيّ يستيقظ، شعرتُ بالكلمات العالقة في صدري تخرج من فمي قبل أن أفكّر: "سأنتقل إلى هنا". صمت نور للحظة. نظرتُ الى وجوههن مترقّبة الردّ. وأخيرًا أجبنني: "آه؟ وأخيرًا".
عندما عدتُ إلى شيكاغو في ذلك المساء، راسلتُ صديقةً لأطلب منها أن نتناول وجبة الإفطار سويًا في الصباح التالي، لأنّي أريد أن أخبرها عن أمر مهمّ. في اليوم التالي، عندما دخلنا إلى كشك الفينيل البرتقالي في مطعم "نورثويست سايد"، صرخَت: "ستنتقلين إلى ديترويت!". ابتسمت. "كيف عرفتِ؟" هزّت كتفها وهي تنظر جانبًا من خلال النافذة. "رأيتُ ستوري الانستاغرام.. كنتِ جالسة مع مجموعة من الناس في الفناء الخلفي، تشربون القهوة العربية وتتحدّثون عن الفنّ الفلسطيني. عندما رأيت الفيديو، علمتُ أنّهم سرقوا صديقتي".
المنفى السياسي شيء غريب. فجأة، يرميكِ مَن جعلكِ تشعرين بأنّك لا تُعوَّضين، مَن قضيتِ ليال طويلة تخطّطين معهم/ن للاعتصامات وجلسات التثقيف والاجتماعات والمسيرات، حتى أقنعتِ نفسكِ بأنّ هؤلاء هم/ن عائلتكِ. لكن في يوم من الأيّام، يحدث شيء ما. ربّما تحاولين محاسبة الشخص الخطأ، أو تسألين الأسئلة الخاطئة. فجأة، وبالسرعة ذاتها التي تمّ احتضانكِ فيها طوال تلك السنوات الماضية، يبدأ الأشخاص الذين اعتقدتِ أنّهم/ن سيكونون إلى جانبك مهما حصل، بالخروج من حياتِك. يومًا بعد يوم، تقلّ الدعوات إلى الاجتماعات، لتصبحين، من دون سابق إنذار، وحدكِ على جبهة المعارضات السياسية الخاطئة.
كان الانتقال إلى ديترويت الخطوة الأخيرة، وكان منفًا من صنعي، وهو أمر كان لديّ السلطة عليه. ذات مساء، في الأسابيع التي تلت انتقالي، كنت مستلقية على الأرض في غرفة نوم كاميليا، أتحدّث معها عن كلّ ما حدث في شيكاغو، فوجدتُ نفسي انهمر بالبكاء. قالت: "شيء واحد أدركته عندما كنت في شيكاغو في احتفال وداع رسمية، أنك كنت غارقة حتى الركب في مشهد التنظيم الفلسطيني في شيكاغو. ولكن استمعي إليّ": نظرَت في عينيّ وقالت "أنتِ في ديترويت الآن، حبيبتي". أصبحت ديترويت المدينة التي تعلّمت فيها أن أسمح لنفسي بالرقص، في عتمة الحانات ونوادي DIY حيث خفقت موسيقى التيكنو في صدورنا، ضاغطة بقوة على أجسادنا. في ديترويت، وقعتُ في الحبّ لأوّل مرّة، في حب شخص بادلني الحب، فحاربنا من أجل بعضنا البعض بشراسة والتزام لم أكن أعرف أبدًا أنّه ممكن خارج إطار العمل السياسيّ. أصبحت ديترويت، المدينة التي نفت الكثيرين، ملجأً لأنواع مختلفة من المنفيّين/ات. ما زلتُ غير قادرة على معرفة إن كانت هذه الحقيقة مشوّشة أم لا، لكنّها الحقيقة. نحن، المنفيّين/ات من مجتمعاتنا المنفيّة، الذين / اللواتي لم تتماشَ وجهات نظرنا مع وجهات نظر مؤسساتنا، الذين / اللواتي كانت سراويلهم/ن أقصر ممّا يجب، الذين / اللواتي ارتدوا الملابس والألوان غير المناسبة بحسب المعايير الجندريّة النمطيّة، ومن لم تتماشَ مساراتهم/ن المهنيّة مع التوقّعات، وجدنا مساحة لنا هنا. كنّا شعراء ورسّامين/ات وعلماء/عالمات رياضيات وموسيقيّين/ات.
ديترويت مدينة تعلّمنا الدعم المجتمعي بطرق لم أعرفها في شيكاغو. هنا، أعددنا الافطار لبعضنا البعض خلال شهر رمضان، قارنّا الوصفات العائليّة القديمة التي ما زلنا نتعلّم كيفية إعدادها. في أيّام الشتاء الباردة، اجتمعنا في The Bottom Line لقراءة الشعر ثنائي اللغة وفناجين القهوة، وعندما أوشك المكان على الإغلاق بسبب الديون، ساهم الجميع لإبقائه مفتوحًا. عندما فقد الأصدقاء منازلهم/ن للمتعهّدين، أصبحت الأرائك ملجأً لهم/ن. في فصل الشتاء، ساعدنا في حلاقة شعر بعضنا البعض في الحمّامات؛ يأتي الصيف، وننتقل إلى الشرفة الخلفية. في المساء، عندما نتعب من الرقص، ندخّن السجائر على الرصيف، ثم نساعد بعضنا البعض للإقلاع عن التدخين، ثم نبدأ بالتدخين مرّة أخرى. رسمنا لبعضنا البعض وشوم فاكهة أوطاننا، من التين الناضج ودوّار الشمس وفروع الزيتون وأزهار البرتقال. زرعنا في أجسادنا ذكريات الأماكن التي تركتها عائلاتنا خلفنا، وجعلناها جزءًا دائمًا من أنفسنا، كرموز مقدسة، ومشوشة كما رؤيتنا الرومانسية للأماكن والأفكار التي أصبحت تمثّلها.
الدعم المجتمعيّ كتكتيك للبقاء: تقليد عرفه شعبنا منذ فترة طويلة، ثم نسيناه، إلى حدّ ما، في الفراغ الهائل للفرديّة الأميركيّة، ثم أعدنا تعلّمه من ديترويت، إحدى المدن الأميركيّة النادرة التي أخبرتنا أنّه من المقبول أن نكون أنفسنا، قالت إنّه ليس علينا الاعتذار، وأكّدت لنا أنّنا لا ندين لهذه الإمبراطوريّة بشيء.
قبل أن أقرّر الانتقال بوقت قصير، التقيتُ بصديقة قديمة لتناول الغداء في وسط مدينة شيكاغو. لا أستطيع أن أتذكّر آخر مرّة رأيتها فيها. تحدّثنا ونحن نتناول الأرزّ، وتشاركنا تفاصيل حياتنا المملّة التي حدثت في الأشهر التي لم نكن فيها على تواصل. أخيرًا، قلتُ لها: "أشعر بأنّكم/ن توقّفتم/ن عن دعوتي بسببه يا رفاق / رفيقات"، وأضفت "عندما تدعونه، لا تدعونني". وافقت على أن هذا كان صحيحًا، ولكن فقط لأنّه عندما أكون موجودة، يتصرّف بطريقة بغيضة ويصبح متهوّرًا وعنيدًا. كان عدم حضوري، ببساطة، أسهل على الجميع، فقلتُ لها: "هذا شيء مزري وغير سليم نوعًا ما"، "نعم"، وافقت. لم يتغيّر شيء.
هذه هي الطرق التي تختفي فيها النساء، واحدة تلو الأخرى، ببطء، أمام أعين الجميع، وبعلْم الجميع، بعد سنوات من تصميم الملصقات التي لم نوقّع أسماءنا عليها مطلقًا، وصياغة جداول أعمال الاجتماعات التي لم نترأسها، وعناوين الحملات المصمّمة لأكل لحمنا. كنّا سعيدات بلعب هذه الأدوار، إلى أن، يومًا ما، مددنا أيدينا إلى آبار الطاقة والقوّة الخاصّة بنا، التي بدت بلا حدود ووجدنا أننا سكبنا أنفسنا في أكواب لا قعر لها، ولم يعد لدينا شيء نعطيه، فتخلّصت منّا الحركة. هكذا، سكتنا، عندما أساء إلينا الرجال الذين امتهنوا عملنا أو استغلّونا، التزمنا الصمت للحفاظ على سمعتهم، وسمعتنا، ولتجنّب "الدراما"، أو تعريض "الحركة" لخطر أكبر ممّا كانت عليه. وهكذا، اختفينا، وشاهدنا ظهور نساء جديدات في مكاننا، وعيون مشتعلة ومستعدّة للمتابعة من المكان الذي توقّفنا فيه، وكنّا نهمس لبعضنا البعض أننا قلقات عليهنّ، ولكن مع ذلك، بقينا صامتات.
إليكم/ن المفارقة: إذا تكلّمتِ، سوف ينفيكِ الآخرون. إذا التزمتِ الصمت، فلا خيار أمامكِ سوى نفي نفسكِ بنفسكِ. إختاري سلاحك.
راودتني الكوابيس لأشهر، فرأيت الأشخاص الذين / اللواتي كنت قد نُظّمت معهم سابقًا في شيكاغو وحوشًا. سمعتُ بأن هؤلاء الأشخاص ذاتهم/ن يخضعون للمراقبة والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنيّة، وأبقيت فمي مغلقًا. بعد شهور قليلة من انتقالي، تمّ ترحيل رسميّة إلى الأردن. نقرتُ على ألبوم صور أصدقائي يودّعونها بعيون تملؤها الدموع في مطار O’Hare. شعرتُ بالسعادة لأنّني ودّعتها شخصيًا قبل أن أغادر شيكاغو، مجنّبة نفسي مشهدًا عامًّا وغريبًا آخر. قضيتُ ساعات في صبّ قلبي في كتابات طويلة وغاضبة على فيسبوك. كنتُ أقوم بصياغتها بدقّة وبنشرها للشعور بالحماسة، ثم أحذفها بعد ثوانٍ، طقوس من نوع ما، تذيب ألمي في الفضاء الإلكتروني.
أفكّر كثيرًا في المرّات التي جرّبت فيها رسميّة المنفى، وكأنّ الأمر بهذه السهولة، أي ألّا تنتمي فجأة إلى أيّ مكان، أو وطن، ألّا يريدك أي بلد. هذا، يجعلني أرغب في تدمير جواز سفري ولكنّ السخرية هو أنّ هذا الشيء الذي يقول أنني لستُ من فلسطين هو الشيء الوحيد الذي سيدخلني إلى فلسطين، وربّما أحد الأشياء الوحيدة التي أعطتني حرية الحركة كفلسطينيّة. لكن، في نهاية المطاف تسقط الجنسيّة الوطنيّة التي أوصلتنا إلى هنا، فبعد كل شيء، وفي الوقت الحالي، ديترويت هي المكان الذي سأقيم فيه، ربّما حتى تلفظني (لن تكون هذه المرّة الأولى)، أو حتى ألفظ نفسي (لن تكون المرّة الأخيرة).
المنفى كمكان للإقامة، تقليد من نوع ما. ربما أشعر أكثر في البيت هنا في الما بين بين. إنها مفارقة المقبرة في مخيّم عائلتي للاجئين/ات، لقد دُفن جدّي إلى الأبد بين الجدران المنخفضة في مأوى مؤقّت. لذا، أحبّ الوجود في المنفى، الأمر الوحيد الذي لا يتغيّر.
هذه من بين أهمّ الأشياء التي أعتقد أنني اكتشفتها في ديترويت: نادرًا ما تكون المنازل دائمة. لا بأس بذلك. يمكن أن يُنفى الشخص عدّة مرّات وبطرق متعدّدة. يمكنك البقاء على قيد الحياة.. وأنّ ديترويت بالنسبة للبعض، قد تكون ما كانت شيكاغو بالنسبة لي، والعكس صحيح.. أنّ ديترويت، جزئيًا، هي مدينة المنفى.. أنّه ليس من الضرورة أن تكون كذلك.. بالنسبة للبعض منّا، تسمية مكان "الموطن" هو فعل سياسي جذري.. أنّه لا يجب أن يكون كذلك. أن رسميّة أتت إلى شيكاغو عن طريق ديترويت، وهذه الحقيقة هي التي دفعتني إلى ديترويت عن طريق شيكاغو.
