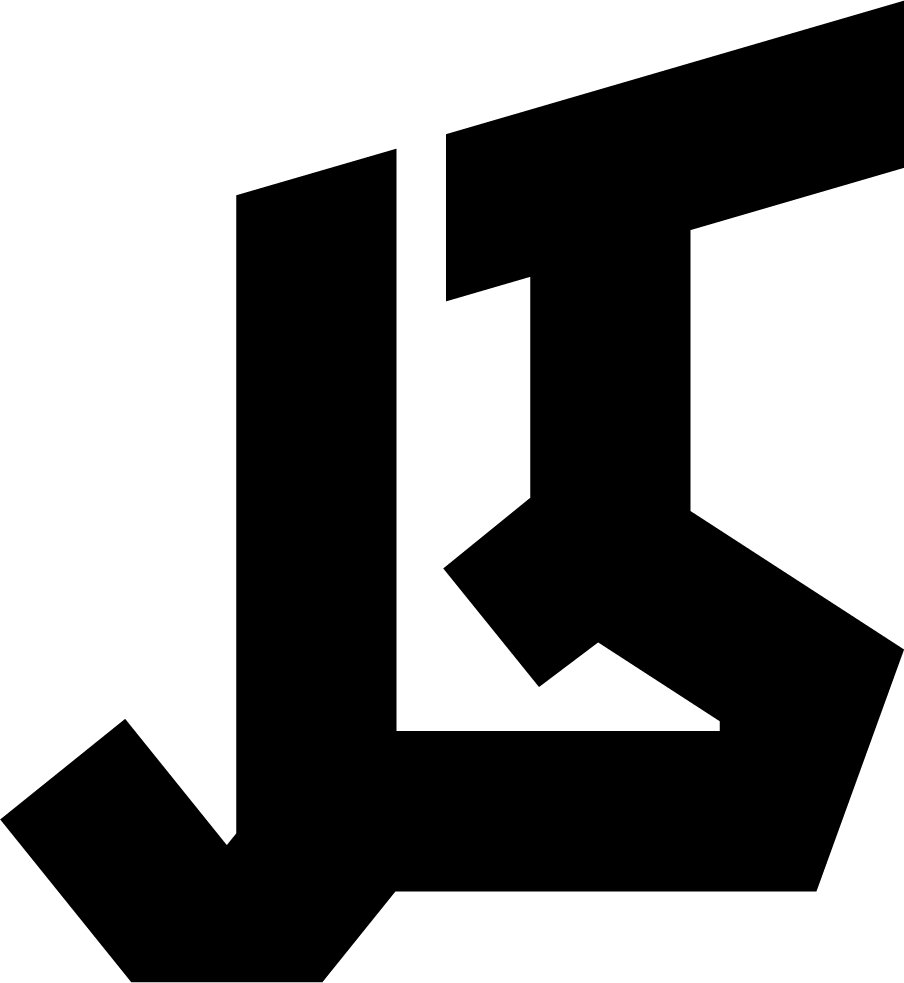مقتطف من أنطولوجيا "في ساحات الملتقى"
i_will_always_be_looking_ar.jpg
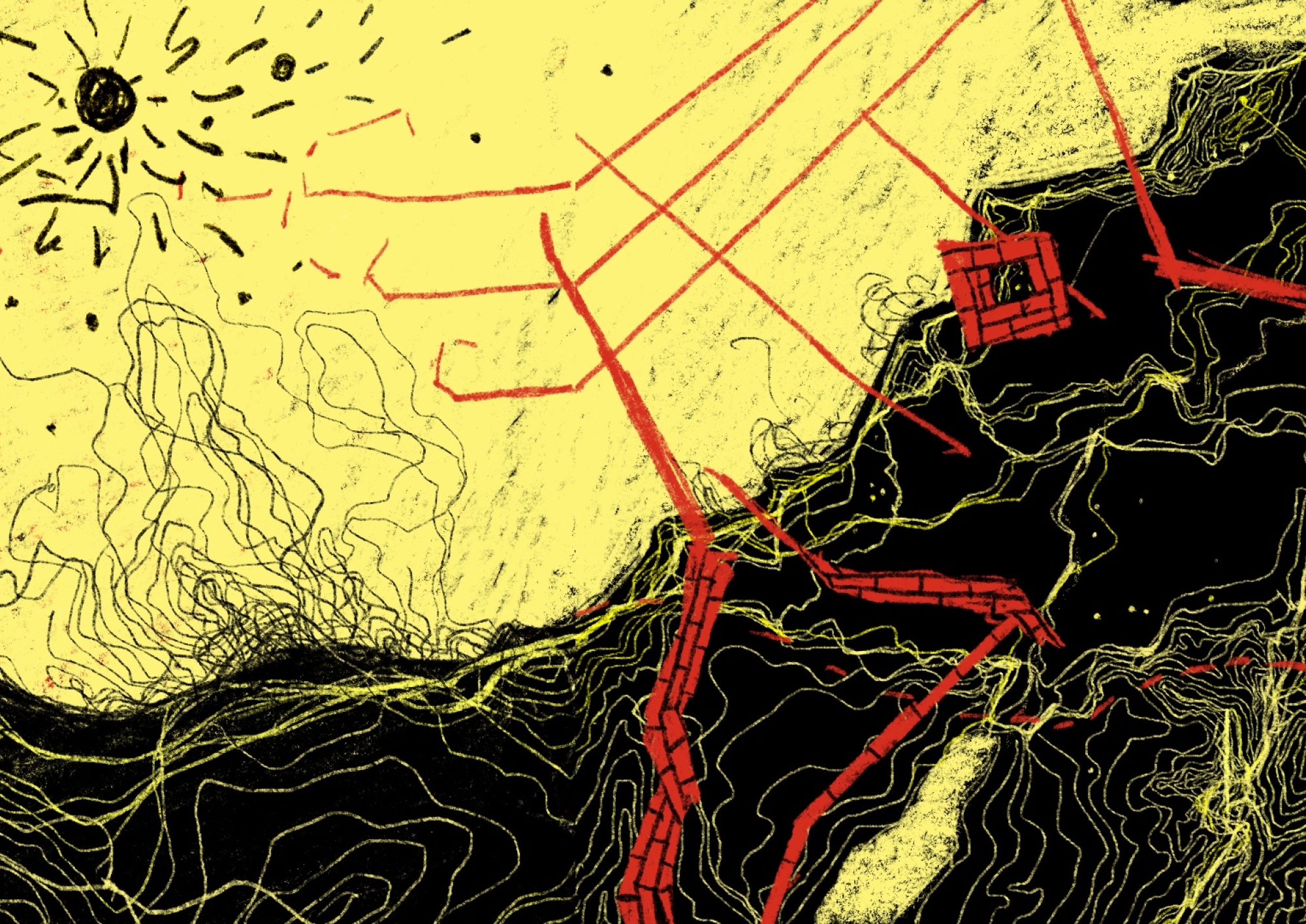
ميرا المير
المقدّمة لغوى صايغ
ترجمة مايا زبداوي لـ"كحل"
في عام 2022، تلقّيتُ دعوةً للمساهمة بصفتي محرّرةً استشارية، في الأنطولوجيا "في ساحات الملتقى" التي حرّرها كلّ من ياسمين الرفاعي ونديم شوفي، وأصدرتها "هايفن فور أرتستس"، الشبكة الفنيّة البيروتيّة الكويريّة التي تنشط في فضاءات الفن البديل. وقد رام هذا العمل الجماعي أن "يستكشف مسارات الخيارات السياسية والجمالية التي تشكّل فعل الإبداع الكويري في المنطقة العربية اليوم، وأن يتأمّل في الكيفية التي يمكن للأعمال الفنّية أن تنسج بها سرديات وأدوات لفهم الكويرية بوصفها ممارسةً وسبيلًا للحياة".
لم نكن ندرك أنّ رحلة صنع هذا الكتاب ستحمل على كاهلها، دون أن تدري، وجع تفتّت عوالمنا أمام أعيننا. في افتتاحيته، تستحضر ياسمين ونديم صدى الأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت عام 2020؛ ووجع تهجير الشيخ جرّاح عام 2021؛ ثم مرارة الحرب في السودان وبدايات الإبادة الجماعية في غزّة عام 2023؛ قبل أن تمتدّ نيران الحرب الاستعمارية لتطال لبنان في عام 2024. هكذا تسلّل التاريخ بكلّ ثقله إلى جسد هذا العمل، متخلّلاً كلماته وصفحاته، ليذكّرنا بأنّ العمل الكويري، حتّى في أبسط أشكال إنتاجه المادّي، هو فعلٌ يتخطّى الحدود التي رسمها الاستعمار، وينسج أفقًا يتّسع للحياة رغم الانكسار.
في هذا العدد من "كحل" اخترنا أن نُضيء على مقطعٍ من المقدّمة يرسم ملامح التمرحلات الكويريّة عبر ثقافة فنيّة مشتركة تتخطّى الحدود الإقليمية. فالفنّ الكويري العربي حاضر في كلّ مكان؛ كلّ ما يلزمنا هو أن نغيّر زاوية النظر كي نتعرّف إليه كما هو. وعلى هذا المنوال، قد نميل إلى القول إنّ الكتاب أبصر النور بالرغم من حروب الإبادة التي عصفت بنا في الأعوام الخمسة الأخيرة. غير أنّ الحقيقة، في وجوه كثيرة، أنّ تلك الحروب بالذات هي ما جعل سَعينا إلى عالمٍ متناقضٍ في حضوره: عالم كان وما يزال ضرورةً سياسية ملحّة. إنّ "في ساحات الملتقى" ليس مجرّد كتاب، بل هو وعد وواجب والتزام يمتدّ على مدى العمر.
يمكنكم العثور على النصوص عبر الرابط التالي: https://publicknowledgebooks.com/products/i-will-always-be-looking-for-you-a-queer-anthology-on-arab-art-1
المقدّمة التحريريّة لياسمين الرفاعي ونديم الشوفي
ترجمة ريّان عبد الخالق لـ"هايفن"
تخيّلوا المشهد. بحر بيروت. يتلألأ الضوء على سطح الماء المُبهج، ويقبّل الأفق البرتقالي الزعفراني. تركّز الأعين على موجةٍ لا تثبُت بما يكفي لتحفظ ذكراها، بل تهرب من ثبات اليقين مسرعةً نحو قدرها على شاطئ المدينة. تخيّلوا جمّ هذا الجمال وسرمدية هذه اللحظة، موضوعة في إطار صورة. الصورة مجرّد بصيص من المشهد، جزءٌ لن يتمكّن أبدًا من احتواء المنظر بأكمله.
"في ساحات الملتقى" هو صورة للعربي الكويري.
في أوائل صيف عام 2020، سألتْنا داينا – أي نحن ياسمين ونديم – إن كنّا مهتمَّين بالعمل على مشروعٍ بحثيّ يجمع مختارات من الفنون الكويرية في المنطقة. استمرّ الحديث مدّة سيجارة، إذ قبلنا شبه تلقائيًا بالفكرة. يا له من سرورٍ أصلًا أن ننشر عملًا أرشيفيًّا زاخرًا بموهبة مجتمعنا وعبقريته في المنطقة!
قبل أن نباشر في البحث، طرحنا على أنفسنا بعض الأسئلة المهمّة، مثل: ما هو شكل هذا الأرشيف، وما هي مهمّته، ولمَن هو؟ أردْنا أن نقدّم عملًا نابعًا من أحشاء هذه المنطقة. أن نقدّم كتابًا ينظر في كيفية إنتاج العرب لأعمالٍ كويريةٍ وسط الضبخان المعادي للكويرية في المدن العربية (والذي لا يزال يفضّله الكثيرات والكثيرون على معطِّر الهواء بخاصيّة الغسيل الوردي في الشمال العالمي الإبادي). أردْنا أن ينظر هذا الكتاب إلى ما هو أبعد من جندر العربي أو جنسانيّته في الفن، ليتناول الآليات والرموز التي نستخدمها للتمكّن من الحديث عن هذه المفاهيم. يرتكز "في ساحات الملتقى" في منهجيّته على رفض الامتثال، سواء لتوقعات القرّاء والقارئات، أو للطرائق التقليدية للبحث والنشر.
على هذا النحو، وُلد الكتابُ من رحم رغبةٍ في البحث عن الفن العربي الكويري من دون محاولة احتوائه. فالكتاب لا يسعى إلى تعريف هذا الفنّ أو إضفاء الشرعيّة عليه كصنفٍ محدّدٍ، ولا إلى دراسة إطاره المتناقض باعتباره موضوعًا استثنائيًّا؛ إنما هو تمرينٌ في النظر إلى ما يمكن أن يبدو عليه التئامُ الكويرية والهوية العربية في عملٍ فنّي، والسماح له بالتشكّل والتبدّد والتحوّل.
للشروع في هذا البحث، بدأنا بتقفّي آثار أسلافنا العرب من الكويريات/ين، إيمانًا منّا بوجودهن/م، وقناعةً منّا بأنهن/م إذا عشن وعاشوا مثلنا، فمن المرجّح أنهم كانوا بالفعل كثرًا، فتذكّرناهم. ثمّ اعترتْنا رغبةٌ في العثور على أسمائهن/م ووجوههن/م ومواقعهن/م، سعيًا منّا لإثبات – إثباتًا قاطعًا – أنّنا موجودات/ون منذ زمنٍ طويلٍ، كأي عربي/ة آخر/أخرى على هذه الأرض. بعد هذه الرغبة الأولية، جاء الإدراك التالي ليقلب الموازين كلّها: لم يُغيَّب أسلافنا الكويريات/ون قسرًا من الأرشيفات التاريخية فحسب، بل ربما أخفين/وا بمحض إرادتهن/م، سياقاتِهن/م المكانية والزمانية من أجل ضمان بقائهم/ن. ربما كان ذلك ضربًا من ضروب "الاختباء الطوعي"، ولا يزال، حتى اليوم، نوعًا من المحو القسري غير المباشر. صحيحٌ اليوم أن تعبيرات أسلافنا ولغاتهم/ن، كما هي الآن، تُنتَج بالتوازي مع هذا المحو المستمر وبمقاومته أيضًا. وفصل هذه الحقيقة عن تصويرنا لحيواتنا يعني تحريفها. لذلك، يصبح بحثنا عن هذه المؤشّرات السياقية تافهًا.
للحب والكويرية تاريخٌ من الانعقاد اللساني المتبادَل. فالتظاهر بكليْهما قد يُحقّق ما يحمله كلٌّ منهما، لكنّه سيُورّط الآخر.اشتعال ذاتي. لهذا السبب أيضًا، يتم إخفاء الكثير من حالات الحب الكويري، مثل "القبلة التي تركت أثرها على شفاهنا وغادرتْنا" في نصّ موسى الشديدي عن أكرم الزعتري ومحمود خالد، لكنّ الشديدي يُظهر لنا أنّ مكان اختباء القبلة، وممَّن تختبئ، هما أيضًا مصدر قوّتها التي تساعدها في فصل الكويرية عن سياسات الظهور الغربية. إذا أردتنّ/م البحث عن العربي الكويري في الأرشيف، كما قد يروق لكن/م أن تفعلن/وا من خلال هذا الكتاب، فستظلّون تبحثون. لذا، إن أردْنا أن نتعمّق في الحب والعيش الكويري، فنحن لا نحتاج إلى إبعاد السرد السائد فقط، بل نحتاج أيضًا إلى النظر بشكلٍ مختلف. لا يمكننا الوصول إلى ماضينا إلّا من خلال غربلة التاريخ بعناية بحثًا عن بقايا كويرية تُرِكتْ لنا عمدًا لنعثر عليها، من دون تعطيل آليات الحماية التي استخدمها الكويريات/ون قبلنا ليستمرّوا ويستمررن.
مع وضع هذه المنهجية نصب أعيننا، تولّينا المهمّة الصعبة المتمثّلة في اختيار ما سيُضَمَّن في هذا المنشور، فاخترنا سلسلةً من الأعمال الفنية بعناية، تحديدًا تلك التي تظهر مدى تنوّع الكويرية. أجرينا مقابلات مع الفنّانات والفنانّين، وسألناهن/م عن رأيهن/م في أعمالهن/م. بعض الفنّانات/ين المذكورات/ين في الكتاب يعتبرون أعمالهم/ن كويريةً، وبعضهم/ن الآخر لا ينظر إليها كذلك. لكنّ الجميع كان معطاءً بما يكفي للتفكير معنا في كيفيّة تصوير تلك الأعمال للمحةٍ من العيش الكويري، في عيون الأخريات والآخرين. ثم دعوْنا كتّابًا وكاتباتٍ من ثلاث عشرة دولة مختلفة ناطقة باللغة العربية للاطّلاع على الأعمال الفنية البصرية والفنّانين/ات الذين اقْتُرِنَّ/وا بهن/م، والردّ على تلك الأعمال بمساهمةٍ نصيّةٍ، بالطريقة التي تحلو لهن/م. تلقّينا مراجعاتٍ وتحليلاتٍ تاريخيةً ومقالاتٍ أكاديميةً، بالإضافة إلى الخيال والشعر والنصوص والحوارات وحتى الرسوم التوضيحية. قُدِّمت الكويرية العربية للكُتّاب كموضوع لمعالجته ودحضه. وقد حرص جميع المساهمين/ات على العمل انطلاقًا من هذه الخلفيّة، بأقصى درجات المتعة والشقاوة.
تتفاعل مواقفهن/م مع العروبة بطرائق مختلفة: البعض يُعرّف عن نفسه بأنه عربي، والبعض الآخر يرفض هذا التعريف، ومنهم/ن مَن يتأثر بالتعريب القسري لمجتمعاته. وهناك مَن يتأرجح بين كلّ هذه الهويّات. لم تكتب المساهمات/ون عن الكويرية فحسب، بل كتبن/وا بكويرية أيضًا. تلاعبن/وا بالتسلسلات الزمنية والجغرافية، وبالكلمات ومعانيها، وبالأسماء، وحتى التواريخ، واعتمدوا/ن إلى حدٍّ بعيدٍ على الخيال لدى النظر إلى الماضي والحاضر. أضفن/وا طابعًا شخصيًّا على النصوص، مستوحيات/ن من مسارح مُظلمة، وبرامج تلفزيونية منسيّة، وصالات عرض فاقعة، ومقاهٍ، وأسواق، وكتبٍ، وأغانٍ، وشواطئ، وبلدات، ومدن. مساحات شهدت على حبّنا الجيّاش وعزيمتنا الثابتة، حيث كانت كويريتنا ممكنةً ولا تزال. والنتيجة كتابٌ لا تحضر فيه الكويرية دائمًا، ولا تُفضَح، ولا تُستجوَب، بل تتجلّى باستمرار، ثم تُبعث حيّةً في أشكالٍ غير متوقعة من خلال النصوص المرافقة لها. ما ستحصل/ين عليه، عزيزنا القارئ وعزيزتنا القارئة، من هذا الكتاب، هو رقصة، تتغيّر في كل مرّة. نأمل أن تسمح/ي لها بالتغيّر معك.